7 - كتاب الجمعة.
7 - كتاب الجمعة
1 - (الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها، وما جاء في فضل يومها وساعتها).
683 - (1) [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن توضأَ فأحسنَ الوُضوء، ثم أتى الجمعةَ (1) فاستمعَ وأنصتَ؛ غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى، وزيادةُ ثلاثة أيام، ومَن مَسَّ الحصا فقد لَغا". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. (2) (لغا) قيل: معناه خاب من الأجر، وقيل أخطأ، وقيل: صارت جمعته ظهراً، وقيل غير ذلك. (3)
684 - (2) [صحيح] وعنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتنِبَتِ الكبائرُ". رواه مسلم وغيره.
685 - (3) [صحيح لغيره] وروى الطبراني في "الكبير" مِن حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الجمعةُ كفَّارةٌ لما بينها وبين الجمعةِ التي تليها، وزيادةٍ لثلاثةِ أيام، وذلك بأنَّ الله عز وجل قال: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ".
686 - (4) [صحيح] وعن أبي سعيد؛ أنَّه سمعَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "خمسٌ مَنْ عمِلهنَّ في يومٍ كَتبهُ اللهُ من أهلِ الجنةِ؛ مَن عاد مريضاً، وشَهِدَ جنازةٌ، وصام يوماً، وراح إلى الجمعةِ، وأعتق رقبة". رواه ابن حِبَّان في "صحيحه".
687 - (5) [صحيح] وعن يزيدَ بن أبي مريم قال: لحقني عَبايةُ بن رِفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال أَبشِرْ؛ فإنَّ خُطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبَا عَبْسٍ يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن اعبَرَّتْ قدماه في سبيلِ اللهِ؛ فهما حرامٌ على النار". رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". ورواه البخاري، وعنده: قال عَباية: أدرَكَني أبو عَبْسٍ وأنا ذاهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمهُ اللهُ على النار". (وفي رواية): "ما اغبرَّت قدما عبدٍ في سبيلِ الله فتمسَّهُ النارُ". وليس عنده قول عباية ليزيد.
688 - (6) [صحيح لغيره] وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن اغتسل يومَ الجمعة، ومَسَّ من طيبٍ إنْ كان عنده، ولَبِسَ من أحسنِ ثيابه، ثم خرج حتى يأتيَ المسجدَ، فيركع ما بدا له، ولم يُؤذِ أحداً، ثم أنصتَ حتى يصلِّي؛ كان كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى". رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، ورواة أحمد ثقات.
689 - (7) [صحيح] وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يغتسل رجلٌ يومَ الجمعةِ، ويَتَطهَّرُ ما استطاع من طُهرٍ (4)، ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، ويَمسُّ طيبِ بَيتِه، ثم يخرجُ فلا يفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنصتُ إذا تكلَّم الإمام؛ إلاَّ غُفرَ له ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى". رواه البخاري والنسائي. [حسن صحيح] وفي رواية للنسائي: (5) "ما مِن رجل يَتَطهَّر يومَ الجمعة كما أُمِر، ثم يخرجُ من بيتِه حتى يأْتيَ الجمعةَ، ويُنصتُ حتى يَقضيَ صلاتَه؛ إلا كان كفارةً لما قبله من الجمعة". ورواه الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن نحو رواية النَّسائي، وقال في آخره: "إلاَّ كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة الأُخرى، ما اجتُنِبَتِ المَقْتَلةُ. . ." (6).
690 - (8) [صحيح] وعن أوسِ بنِ أوسٍ الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن غَسَّل (7) يومَ الجمعة واغتَسل، وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا مِن الإمام فاستمعَ، ولم يَلْغُ؛ كان له بكل خُطوة عَملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: "حديث حسن"، والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم وصححه.
691 - (9) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس رحمه الله. قال الخطابي: (8) "قوله عليه السلام: "غسَّل واغتسل، وبكِّر وابتكر". اختلف الناس في معناه، فمنهم مَن ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: "ومشى ولم يركب"، ومعناهما واحد؟ وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقال بعضهم: قولهُ: "غسل". معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأنَّ العرب لهم لِمَمٌ وشعور، وفي غسلها مؤنة، فأفْرَدَ (9) غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله: "اغتسل" معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله: "غَسَّل" معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه، وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله: "وبكَّر وابتكر" زعم بعضهم أن معنى "بكَّر": أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى "ابتكر": قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري: معنا (بكَّر): تصدق قبل خروجه، وتأوَّل في ذلك ما روي في الحديث من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (باكروا بالصدقةِ؛ فإن البلاءَ لا يتخطاها) (10) ". (وقال الحافظ) أبو بكر ابن خزيمة (11): "مَن قال في الخبر: "غَسَّل واغْتَسَلَ" (يعني بالتشديد) معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمَته واغتسل، ومن قال: "غسَل واغتسل" (يعني بالتخفيف) أراد غسل رأسه، واغتسل: فضل سائر الجسد، لخبر طاوس عن ابن عباس".
692 - (10) [صحيح] ثم روى بإسناده الصحيح إلى طاوس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اغتسلوا يومَ الجمعة، واغسلوا روؤسَكم، وإنْ لم تكونوا جنباً، ومَسّوا من الطيب". قال ابن عباس: أمَّا الطيب فلا أدري، وأمَّا الغسل فنعمْ. (12)
693 - (11) [صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن غَسَّلَ واغتَسَلَ، ودنا وابتكرَ، واقترب واستمع، كان له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها". رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. (13)
694 - (12) [حسن صحيح] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عُرِضتْ الجمعةُ على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كَفِّه كالمرآة البيضاء، في وسَطها كالنُّكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبرائيل! قال: هذه الجمعة، يَعرضها عليك ربُّك؛ لتكون لك عيداً، ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأولَ، وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحدٌ ربَّه فيها بخير هو له قُسِمَ؛ إلاَّ أعطاه، أو يتعوَّذ من شر؛ إلا دُفِع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. . ." الحديث (14). رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد جيّد.
695 - (13) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خيرُ يومٍ طَلعتْ عليه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه دخل الجنةَ، وفيه أُخرج منها". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. [صحيح] وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه: قال: "ما طلعتِ الشمسُ ولا غَربتْ على يومٍ خيرٍ من يوم الجمعة، هدانا الله له، وضَلَّ الناس عنه، فالناسُ لنا فيه تَبَعٌ، فهو لنا، ولليهود يومُ السبت، وللنصارى يومُ الأحد، إنَّ فيه لساعةً لا يوافقها مؤمن يصلِّي يسأل الله شيئاً؛ إلا أعطاه" فذكر الحديث.
696 - (14) [صحيح] وعن أوسِ بنِ أوسٍ الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعة، فيه خُلق آدَمُ، وفيه قُبضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثِروا علي من الصلاة فيه، فإنّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ". قالوا: وكيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ أي: بَليت. فقال: "إنّ الله جل وعلا حَرَّمَ على الأرضِ أنْ تأكلَ أجسامَنا". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له، وهو أتمُّ. وله علّة دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره، وليس هذا موضعها (15)، وقد جمعت طرقه في جزء. (أَرَمْتَ) بفتح الراء وسكون ميم، أي: صِرت رميماً. ورُوي (أُرِمْتَ) بضم الهمزة وسكون الراء. (16)
697 - (15) [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تطلُعُ الشمسُ ولا تغرُبُ على أفضلَ من يومِ الجمعةِ، وما من دابَّةٍ إلاَّ وهي تَفزَعُ يومَ الجمعةِ، إلاَّ هذين الثقلين: الجن والإنس". رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، ورواه أبو داود وغيره أطول من هذا، وقال في آخره: "وما من دابَّة إلا وهي مُصيخةٌ يومَ الجمعة من حين تصبح، حتى تطلع الشمس، شفقاً من الساعة، إلا الإنسَ والجنَّ". (مصيخة) معناه: مستمعة مصغية، تتوقّع قيام الساعة.
698 - (16) [حسن] وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُحشَر الأيامُ على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراءَ منيرةً، أهلُها يَحُفُّون بها كالعروس تُهدَى إلى خِدرها، تضيء لهم؛ يمشون في ضوئها، ألوانُهم كالثلجِ بياضاً، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبالِ الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يُطرقِون تعجباً، حتى يدخلون (17) الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذِّنون المحتسِبون". رواه الطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: "إنْ صح هذا الخبر، فإنَّ في النفس من هذا الإسناد شيئاً". (قال الحافظ): "إسناده حسن، وفي متنه غرابة".
699 - (17) [صحيح] وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أضلَّ الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يومُ السبت، والأحدُ للنصارى، فهم لنا تَبَع إلى يوم القيامة، نحن الآخِرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيُّ لهم قبل الخلائق". رواه ابن ماجه والبزار، ورجالهما رجال "الصحيح"؛ إلا أنَّ البزار قال: "نحنُ الآخِرون في الدنيا، الأوَّلون يوم القيامة، المغفورُ لهم قبل الخلائق". وهو في مسلم بنحو اللفظ الأول من حديث حذيفة وحده (18).
700 - (18) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر يوم الجمعة فقال: "فيها (19) ساعةٌ لا يوافِقُها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلي؛ يسألُ اللهَ شيئاً؛ إلا أعطاه [إياه]. وأشار بيده يقلِّلُها". رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. (وأما تعيين الساعة) فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، واختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً، بسطتُه في غير هذا الكتاب، وأذكر هنا نبذة من الأحاديثِ الدالَّةِ لبعض الأقوال.
701 - (19) [حسن لغيره] ورُوي عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "التمِسوا الساعةَ التي تُرجَى في يوم الجمعة بَعدَ صلاةِ العصرِ، إلى غَيبوبةِ الشمسِ". رواه الترمذي وقال: "حديث غريب". ورواه الطبراني من رواية ابن لهيعة. وزاد في آخره: "يعني قدْر هذا". يعني قبضة. وإسناده أصلح من إسناد الترمذي.
702 - (20) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس: إنا لنجِد في كتاب الله تعالى: في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يصلِّي يسألُ اللهَ فيها شيئاً، إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إليَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أو بعضُ ساعةٍ". فقلت: صدقتَ، أو بعض ساعة. قلت: أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: "آخرُ ساعات النهار". قلت: إنها ليست ساعةَ صلاةٍ. قال: "بلى؛ إن العبد إذا صلَّى، ثم جلس لم يُجلِسْهُ إلا الصلاة، فهو في صلاة". رواه ابن ماجه، وإسناده على شرط "الصحيح".
703 - (21) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يومِ الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عزّ وجلّ شيئاً إلاَّ آتاه إياه، فالتمسوها آخرَ ساعة بعد صلاةِ العصرِ". رواه أبو داود والنسائي -واللفظ له-، والحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم". وهو كما قال. قال الترمذي: "ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم أن الساعة التي ترجى [فيها] (20) [إجابة الدعوة] بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. قال: (وتُرجَى بعد الزوال) ". ثم روى حديث عمرو بن عوف المتقدم. [في "الضعيف"]. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: "اختلفوا في وقت الساعة التي يُستجابُ فيها الدعاء من يوم الجمعة، فرُوِّينا عن أبي هريرةَ قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسِ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. (21) وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمس. وفيه قول ثالث، هو أنّه "إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة"، رُوي ذلك عن عائشة. ورُوِّينا عن الحسن البصري أنَّه قال: "هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ". وقال أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة. وقال أبو السوّار العدوي: كانوا يرون الدعاء مستجاباً ما بين أنْ تزول الشمس إلى أنْ يدخل في الصلاة. وفيه قول سابع، وهو أنَّها ما بين أنْ تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع. ورُويِّنا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن، وهو أنَّها ما بين العصر إلى أنْ تغرب الشمس. كذا قال أبو هريرة، وبه قال طاوس وعبد الله بن سلام. والله أعلم". (22)
____________
(1) في "المصباح": "سمي بذلك لاجتماع الناس به، وضم الميم لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وإسكانها لغة عقيل، وقرأ بها الأعمش".
(2) قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1762) وغيره من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوه، وزاد: "يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها"، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (370)، وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة من حديث أبي مالك الأشعري، وهو الآتي بعد حديث، ومن حديث ابن عمرو، ويأتي في آخر (5 - الترهيب من الكلام والإمام يخطب).
(3) قلت: ولعل الصواب القول الأخير، للحديث الآتي هنا (5 - باب/ 6): "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً". ثم هو لا ينافي ما قبله من الأقوال كما هو ظاهر.
(4) الأصل: "الطهور"، والتصحيح من "البخاري" (472 - مختصره).
(5) قلت: يعني في "السنن الكبرى" (1664 و1724). وهي عند الحاكم أيضاً (1/ 277). وقال: "صحيح الإسناد".
(6) هنا في الأصل زيادة بلفظ: "وذلك الدهر كله" فحذفتها، لأن في إسناد الطبراني (6/ 290/ 6089) (مغيرة) وهو ابن مقسم الضبي مدلس وقد عنعنه، وهو رواية للنسائي (1665 و17225)، ولكنه لم يذكرها.
(7) زاد أبو داود في رواية له: "رأسه". وإسنادها صحيح كما في "صحيحه" (373)، وهذا يؤيِّد ما سيذكره المؤلف عن ابن خزيمة في تفسير الحديث، واستدل له بحديث آخر عن ابن عباس كما سترى، ويشهد له حديث آخر له من حديث أبي هريرة مرفوعاً يأتي في (2 - التغيب في الغسل يوم الجمعة).
(8) "معالم السنن" (1/ 213 - 214). (9) في الأصل ومطبوعة عمارة والمعلقين الثلاثة: "فأراد"، والتصويب من "المعالم".
(10) قلت: هذا الحديث إسناده ضعيف جداً كما هو مبين في "تخريج المشكاة" (1887)، وسيأتي في (8 - الصدقات/ 9) في "الضعيف".
(11) "صحيح ابن خزيمة" (3/ 129). (12) قلت: وأخرجه البخاري أيضاً (رقم - 474 - مختصره). قلت: وغسل الرأس هو الذي ينبغي أنْ يفسَّر به الحديث؛ لحديث ابن عباس هذا، ولتصريح رواية أبي داود بذلك كما تقدم في التعليق تحت الحديث (8)، ولحديث أبي هريرة الآتي (2 - باب/ 2 - حديث).
(13) قلت: فيه (عثمان الشامي)، وهو (عثمان بن أبي سودة المقدسي)، لم يرو له في "الصحيح"؛ إلا البخاري في "الأدب المفرد" خارج "الصحيح"، وهو ثقة.
(14) قلت: وسيأتي بتمامه في آخر الكتاب بإذن الله تعالى.
(15) قلت: وقد تكلم عليها الناجي بتفصيل، (103 - 105) وأنهى الكلام عليها بقوله: "وليست هذه بعلة قادحة، فإنّ للحديث شواهد من حديث جماعات". قلت: وقد أصاب رحمه الله فيما قال، وبيّنت العلّة المشار إليها في "صحيح أبي داود" (962)، وأوضحت أنها لا تؤثر في صحة الحديث، ويكفي في ردها تتابع المحدّثين على تصحيحه، كابن خزيمة (1733 و1734)، وابن حبان (550)، والحاكم (1/ 278)، والذهبي، وقبله النووي.
(16) كذا الأصل، ولعل الصواب: "وسكون الميم"، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" أقوالاً في ضبط هذه الكلمة وأصلها، وقال في جملة ذلك: "وقيل: يجوز أن يكون (أرِمتَ) بوزن (أمرتَ) من قولهم: (أرَمَتْ الإبل تأرم)، إذا تناولت العلف وقلعته من الأرض". وكذا في "اللسان". ثم رجعت إلى المخطوطة (ق 82/ 2) فإذا بها "وكسر الراء"، فهو الصواب.
(17) كذا الأصل بإثبات النون، وعليه "المجمع"، والسياق للطبراني، ولفظ ابن خزيمة نحوه، وفيه "يدخلوا"، وهو الأصح. وباللفظ الأول رواه الطبراني في "مسند الشاميين" أيضاً (2/ 390)، وكذا الحاكم (1/ 277)، وقال: "حديث شاذ صحيح"! ووافقه الذهبي!
(18) قلت: ليس كذلك، بل أخرجه مسلم عنهما معاً. ثم ساقه قريباً منه من حديث حذيفة وحده. كذا في "العجالة" (105)، وهو كما قال، وهو في "مسلم" (3/ 7)، ولفظه في الجملة الأخيرة منه كلفظ ابن ماجه: "المقضيُّ لهم قبل الخلائق". وفي رواية: "المقضيُّ بينهم".
(19) قال الناجي: "هذا سبْق قلم، وإنما هو (فيه)، إذِ الضمير عائد إلى اليوم، وهو مذكّر، وذا واضح غير خاف". قلت: واللفظ للبخاري (935) والزيادة منه سقطت من قلم المؤلف رحمه الله.
(20) سقطت من الأصل، واستدركتها من "سنن الترمذي" والمخطوطة، وفيها بعدها زيادة: "إجابة الدعوة". وسقط ذلك كله من مطبوعة الثلاثة!
(21) قلت: وهذا قد رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً، ولا يصح أيضاً، وقد خرَّجته فى "الضعيفة" (5299).
(22) قلت: وهناك أقوال أخرى كثيرة، استقصاها الحافظ في "الفتح" (2/ 345 - 351) فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليه، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، وهو في الكتاب الآخر، فرجَّحوه على أحاديث الباب بأنّه في أحد "الصحيحين". قال الحافظ: "وأجاب الأوّلون بأنّ الترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفَّاظ كحديث أبي موسى هذا. فإنَّه أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب. . "، ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في "ضعيف أبي داود" (193)، وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع "الفتح".
_________
صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالي الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية المكتبة الشاملة
1 - (الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها، وما جاء في فضل يومها وساعتها).
683 - (1) [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن توضأَ فأحسنَ الوُضوء، ثم أتى الجمعةَ (1) فاستمعَ وأنصتَ؛ غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى، وزيادةُ ثلاثة أيام، ومَن مَسَّ الحصا فقد لَغا". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. (2) (لغا) قيل: معناه خاب من الأجر، وقيل أخطأ، وقيل: صارت جمعته ظهراً، وقيل غير ذلك. (3)
684 - (2) [صحيح] وعنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتنِبَتِ الكبائرُ". رواه مسلم وغيره.
685 - (3) [صحيح لغيره] وروى الطبراني في "الكبير" مِن حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الجمعةُ كفَّارةٌ لما بينها وبين الجمعةِ التي تليها، وزيادةٍ لثلاثةِ أيام، وذلك بأنَّ الله عز وجل قال: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ".
686 - (4) [صحيح] وعن أبي سعيد؛ أنَّه سمعَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "خمسٌ مَنْ عمِلهنَّ في يومٍ كَتبهُ اللهُ من أهلِ الجنةِ؛ مَن عاد مريضاً، وشَهِدَ جنازةٌ، وصام يوماً، وراح إلى الجمعةِ، وأعتق رقبة". رواه ابن حِبَّان في "صحيحه".
687 - (5) [صحيح] وعن يزيدَ بن أبي مريم قال: لحقني عَبايةُ بن رِفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال أَبشِرْ؛ فإنَّ خُطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبَا عَبْسٍ يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن اعبَرَّتْ قدماه في سبيلِ اللهِ؛ فهما حرامٌ على النار". رواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". ورواه البخاري، وعنده: قال عَباية: أدرَكَني أبو عَبْسٍ وأنا ذاهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمهُ اللهُ على النار". (وفي رواية): "ما اغبرَّت قدما عبدٍ في سبيلِ الله فتمسَّهُ النارُ". وليس عنده قول عباية ليزيد.
688 - (6) [صحيح لغيره] وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن اغتسل يومَ الجمعة، ومَسَّ من طيبٍ إنْ كان عنده، ولَبِسَ من أحسنِ ثيابه، ثم خرج حتى يأتيَ المسجدَ، فيركع ما بدا له، ولم يُؤذِ أحداً، ثم أنصتَ حتى يصلِّي؛ كان كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى". رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، ورواة أحمد ثقات.
689 - (7) [صحيح] وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يغتسل رجلٌ يومَ الجمعةِ، ويَتَطهَّرُ ما استطاع من طُهرٍ (4)، ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، ويَمسُّ طيبِ بَيتِه، ثم يخرجُ فلا يفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنصتُ إذا تكلَّم الإمام؛ إلاَّ غُفرَ له ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى". رواه البخاري والنسائي. [حسن صحيح] وفي رواية للنسائي: (5) "ما مِن رجل يَتَطهَّر يومَ الجمعة كما أُمِر، ثم يخرجُ من بيتِه حتى يأْتيَ الجمعةَ، ويُنصتُ حتى يَقضيَ صلاتَه؛ إلا كان كفارةً لما قبله من الجمعة". ورواه الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن نحو رواية النَّسائي، وقال في آخره: "إلاَّ كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة الأُخرى، ما اجتُنِبَتِ المَقْتَلةُ. . ." (6).
690 - (8) [صحيح] وعن أوسِ بنِ أوسٍ الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "مَن غَسَّل (7) يومَ الجمعة واغتَسل، وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا مِن الإمام فاستمعَ، ولم يَلْغُ؛ كان له بكل خُطوة عَملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: "حديث حسن"، والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم وصححه.
691 - (9) [صحيح لغيره] ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس رحمه الله. قال الخطابي: (8) "قوله عليه السلام: "غسَّل واغتسل، وبكِّر وابتكر". اختلف الناس في معناه، فمنهم مَن ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: "ومشى ولم يركب"، ومعناهما واحد؟ وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقال بعضهم: قولهُ: "غسل". معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأنَّ العرب لهم لِمَمٌ وشعور، وفي غسلها مؤنة، فأفْرَدَ (9) غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله: "اغتسل" معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله: "غَسَّل" معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه، وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله: "وبكَّر وابتكر" زعم بعضهم أن معنى "بكَّر": أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى "ابتكر": قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري: معنا (بكَّر): تصدق قبل خروجه، وتأوَّل في ذلك ما روي في الحديث من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (باكروا بالصدقةِ؛ فإن البلاءَ لا يتخطاها) (10) ". (وقال الحافظ) أبو بكر ابن خزيمة (11): "مَن قال في الخبر: "غَسَّل واغْتَسَلَ" (يعني بالتشديد) معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمَته واغتسل، ومن قال: "غسَل واغتسل" (يعني بالتخفيف) أراد غسل رأسه، واغتسل: فضل سائر الجسد، لخبر طاوس عن ابن عباس".
692 - (10) [صحيح] ثم روى بإسناده الصحيح إلى طاوس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اغتسلوا يومَ الجمعة، واغسلوا روؤسَكم، وإنْ لم تكونوا جنباً، ومَسّوا من الطيب". قال ابن عباس: أمَّا الطيب فلا أدري، وأمَّا الغسل فنعمْ. (12)
693 - (11) [صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن غَسَّلَ واغتَسَلَ، ودنا وابتكرَ، واقترب واستمع، كان له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها". رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. (13)
694 - (12) [حسن صحيح] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عُرِضتْ الجمعةُ على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كَفِّه كالمرآة البيضاء، في وسَطها كالنُّكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبرائيل! قال: هذه الجمعة، يَعرضها عليك ربُّك؛ لتكون لك عيداً، ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأولَ، وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحدٌ ربَّه فيها بخير هو له قُسِمَ؛ إلاَّ أعطاه، أو يتعوَّذ من شر؛ إلا دُفِع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. . ." الحديث (14). رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد جيّد.
695 - (13) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خيرُ يومٍ طَلعتْ عليه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه دخل الجنةَ، وفيه أُخرج منها". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. [صحيح] وابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه: قال: "ما طلعتِ الشمسُ ولا غَربتْ على يومٍ خيرٍ من يوم الجمعة، هدانا الله له، وضَلَّ الناس عنه، فالناسُ لنا فيه تَبَعٌ، فهو لنا، ولليهود يومُ السبت، وللنصارى يومُ الأحد، إنَّ فيه لساعةً لا يوافقها مؤمن يصلِّي يسأل الله شيئاً؛ إلا أعطاه" فذكر الحديث.
696 - (14) [صحيح] وعن أوسِ بنِ أوسٍ الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعة، فيه خُلق آدَمُ، وفيه قُبضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثِروا علي من الصلاة فيه، فإنّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ". قالوا: وكيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ أي: بَليت. فقال: "إنّ الله جل وعلا حَرَّمَ على الأرضِ أنْ تأكلَ أجسامَنا". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له، وهو أتمُّ. وله علّة دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره، وليس هذا موضعها (15)، وقد جمعت طرقه في جزء. (أَرَمْتَ) بفتح الراء وسكون ميم، أي: صِرت رميماً. ورُوي (أُرِمْتَ) بضم الهمزة وسكون الراء. (16)
697 - (15) [حسن] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تطلُعُ الشمسُ ولا تغرُبُ على أفضلَ من يومِ الجمعةِ، وما من دابَّةٍ إلاَّ وهي تَفزَعُ يومَ الجمعةِ، إلاَّ هذين الثقلين: الجن والإنس". رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، ورواه أبو داود وغيره أطول من هذا، وقال في آخره: "وما من دابَّة إلا وهي مُصيخةٌ يومَ الجمعة من حين تصبح، حتى تطلع الشمس، شفقاً من الساعة، إلا الإنسَ والجنَّ". (مصيخة) معناه: مستمعة مصغية، تتوقّع قيام الساعة.
698 - (16) [حسن] وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُحشَر الأيامُ على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراءَ منيرةً، أهلُها يَحُفُّون بها كالعروس تُهدَى إلى خِدرها، تضيء لهم؛ يمشون في ضوئها، ألوانُهم كالثلجِ بياضاً، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبالِ الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يُطرقِون تعجباً، حتى يدخلون (17) الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذِّنون المحتسِبون". رواه الطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: "إنْ صح هذا الخبر، فإنَّ في النفس من هذا الإسناد شيئاً". (قال الحافظ): "إسناده حسن، وفي متنه غرابة".
699 - (17) [صحيح] وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أضلَّ الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يومُ السبت، والأحدُ للنصارى، فهم لنا تَبَع إلى يوم القيامة، نحن الآخِرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيُّ لهم قبل الخلائق". رواه ابن ماجه والبزار، ورجالهما رجال "الصحيح"؛ إلا أنَّ البزار قال: "نحنُ الآخِرون في الدنيا، الأوَّلون يوم القيامة، المغفورُ لهم قبل الخلائق". وهو في مسلم بنحو اللفظ الأول من حديث حذيفة وحده (18).
700 - (18) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر يوم الجمعة فقال: "فيها (19) ساعةٌ لا يوافِقُها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلي؛ يسألُ اللهَ شيئاً؛ إلا أعطاه [إياه]. وأشار بيده يقلِّلُها". رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. (وأما تعيين الساعة) فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، واختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً، بسطتُه في غير هذا الكتاب، وأذكر هنا نبذة من الأحاديثِ الدالَّةِ لبعض الأقوال.
701 - (19) [حسن لغيره] ورُوي عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "التمِسوا الساعةَ التي تُرجَى في يوم الجمعة بَعدَ صلاةِ العصرِ، إلى غَيبوبةِ الشمسِ". رواه الترمذي وقال: "حديث غريب". ورواه الطبراني من رواية ابن لهيعة. وزاد في آخره: "يعني قدْر هذا". يعني قبضة. وإسناده أصلح من إسناد الترمذي.
702 - (20) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس: إنا لنجِد في كتاب الله تعالى: في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يصلِّي يسألُ اللهَ فيها شيئاً، إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إليَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أو بعضُ ساعةٍ". فقلت: صدقتَ، أو بعض ساعة. قلت: أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: "آخرُ ساعات النهار". قلت: إنها ليست ساعةَ صلاةٍ. قال: "بلى؛ إن العبد إذا صلَّى، ثم جلس لم يُجلِسْهُ إلا الصلاة، فهو في صلاة". رواه ابن ماجه، وإسناده على شرط "الصحيح".
703 - (21) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يومِ الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عزّ وجلّ شيئاً إلاَّ آتاه إياه، فالتمسوها آخرَ ساعة بعد صلاةِ العصرِ". رواه أبو داود والنسائي -واللفظ له-، والحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم". وهو كما قال. قال الترمذي: "ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم أن الساعة التي ترجى [فيها] (20) [إجابة الدعوة] بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. قال: (وتُرجَى بعد الزوال) ". ثم روى حديث عمرو بن عوف المتقدم. [في "الضعيف"]. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: "اختلفوا في وقت الساعة التي يُستجابُ فيها الدعاء من يوم الجمعة، فرُوِّينا عن أبي هريرةَ قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسِ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. (21) وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمس. وفيه قول ثالث، هو أنّه "إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة"، رُوي ذلك عن عائشة. ورُوِّينا عن الحسن البصري أنَّه قال: "هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ". وقال أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة. وقال أبو السوّار العدوي: كانوا يرون الدعاء مستجاباً ما بين أنْ تزول الشمس إلى أنْ يدخل في الصلاة. وفيه قول سابع، وهو أنَّها ما بين أنْ تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع. ورُويِّنا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن، وهو أنَّها ما بين العصر إلى أنْ تغرب الشمس. كذا قال أبو هريرة، وبه قال طاوس وعبد الله بن سلام. والله أعلم". (22)
____________
(1) في "المصباح": "سمي بذلك لاجتماع الناس به، وضم الميم لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وإسكانها لغة عقيل، وقرأ بها الأعمش".
(2) قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1762) وغيره من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوه، وزاد: "يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها"، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (370)، وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة من حديث أبي مالك الأشعري، وهو الآتي بعد حديث، ومن حديث ابن عمرو، ويأتي في آخر (5 - الترهيب من الكلام والإمام يخطب).
(3) قلت: ولعل الصواب القول الأخير، للحديث الآتي هنا (5 - باب/ 6): "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً". ثم هو لا ينافي ما قبله من الأقوال كما هو ظاهر.
(4) الأصل: "الطهور"، والتصحيح من "البخاري" (472 - مختصره).
(5) قلت: يعني في "السنن الكبرى" (1664 و1724). وهي عند الحاكم أيضاً (1/ 277). وقال: "صحيح الإسناد".
(6) هنا في الأصل زيادة بلفظ: "وذلك الدهر كله" فحذفتها، لأن في إسناد الطبراني (6/ 290/ 6089) (مغيرة) وهو ابن مقسم الضبي مدلس وقد عنعنه، وهو رواية للنسائي (1665 و17225)، ولكنه لم يذكرها.
(7) زاد أبو داود في رواية له: "رأسه". وإسنادها صحيح كما في "صحيحه" (373)، وهذا يؤيِّد ما سيذكره المؤلف عن ابن خزيمة في تفسير الحديث، واستدل له بحديث آخر عن ابن عباس كما سترى، ويشهد له حديث آخر له من حديث أبي هريرة مرفوعاً يأتي في (2 - التغيب في الغسل يوم الجمعة).
(8) "معالم السنن" (1/ 213 - 214). (9) في الأصل ومطبوعة عمارة والمعلقين الثلاثة: "فأراد"، والتصويب من "المعالم".
(10) قلت: هذا الحديث إسناده ضعيف جداً كما هو مبين في "تخريج المشكاة" (1887)، وسيأتي في (8 - الصدقات/ 9) في "الضعيف".
(11) "صحيح ابن خزيمة" (3/ 129). (12) قلت: وأخرجه البخاري أيضاً (رقم - 474 - مختصره). قلت: وغسل الرأس هو الذي ينبغي أنْ يفسَّر به الحديث؛ لحديث ابن عباس هذا، ولتصريح رواية أبي داود بذلك كما تقدم في التعليق تحت الحديث (8)، ولحديث أبي هريرة الآتي (2 - باب/ 2 - حديث).
(13) قلت: فيه (عثمان الشامي)، وهو (عثمان بن أبي سودة المقدسي)، لم يرو له في "الصحيح"؛ إلا البخاري في "الأدب المفرد" خارج "الصحيح"، وهو ثقة.
(14) قلت: وسيأتي بتمامه في آخر الكتاب بإذن الله تعالى.
(15) قلت: وقد تكلم عليها الناجي بتفصيل، (103 - 105) وأنهى الكلام عليها بقوله: "وليست هذه بعلة قادحة، فإنّ للحديث شواهد من حديث جماعات". قلت: وقد أصاب رحمه الله فيما قال، وبيّنت العلّة المشار إليها في "صحيح أبي داود" (962)، وأوضحت أنها لا تؤثر في صحة الحديث، ويكفي في ردها تتابع المحدّثين على تصحيحه، كابن خزيمة (1733 و1734)، وابن حبان (550)، والحاكم (1/ 278)، والذهبي، وقبله النووي.
(16) كذا الأصل، ولعل الصواب: "وسكون الميم"، فقد ذكر ابن الأثير في "النهاية" أقوالاً في ضبط هذه الكلمة وأصلها، وقال في جملة ذلك: "وقيل: يجوز أن يكون (أرِمتَ) بوزن (أمرتَ) من قولهم: (أرَمَتْ الإبل تأرم)، إذا تناولت العلف وقلعته من الأرض". وكذا في "اللسان". ثم رجعت إلى المخطوطة (ق 82/ 2) فإذا بها "وكسر الراء"، فهو الصواب.
(17) كذا الأصل بإثبات النون، وعليه "المجمع"، والسياق للطبراني، ولفظ ابن خزيمة نحوه، وفيه "يدخلوا"، وهو الأصح. وباللفظ الأول رواه الطبراني في "مسند الشاميين" أيضاً (2/ 390)، وكذا الحاكم (1/ 277)، وقال: "حديث شاذ صحيح"! ووافقه الذهبي!
(18) قلت: ليس كذلك، بل أخرجه مسلم عنهما معاً. ثم ساقه قريباً منه من حديث حذيفة وحده. كذا في "العجالة" (105)، وهو كما قال، وهو في "مسلم" (3/ 7)، ولفظه في الجملة الأخيرة منه كلفظ ابن ماجه: "المقضيُّ لهم قبل الخلائق". وفي رواية: "المقضيُّ بينهم".
(19) قال الناجي: "هذا سبْق قلم، وإنما هو (فيه)، إذِ الضمير عائد إلى اليوم، وهو مذكّر، وذا واضح غير خاف". قلت: واللفظ للبخاري (935) والزيادة منه سقطت من قلم المؤلف رحمه الله.
(20) سقطت من الأصل، واستدركتها من "سنن الترمذي" والمخطوطة، وفيها بعدها زيادة: "إجابة الدعوة". وسقط ذلك كله من مطبوعة الثلاثة!
(21) قلت: وهذا قد رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً، ولا يصح أيضاً، وقد خرَّجته فى "الضعيفة" (5299).
(22) قلت: وهناك أقوال أخرى كثيرة، استقصاها الحافظ في "الفتح" (2/ 345 - 351) فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليه، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، وهو في الكتاب الآخر، فرجَّحوه على أحاديث الباب بأنّه في أحد "الصحيحين". قال الحافظ: "وأجاب الأوّلون بأنّ الترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفَّاظ كحديث أبي موسى هذا. فإنَّه أُعِلَّ بالانقطاع والاضطراب. . "، ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في "ضعيف أبي داود" (193)، وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع "الفتح".
_________
صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالي الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية المكتبة الشاملة



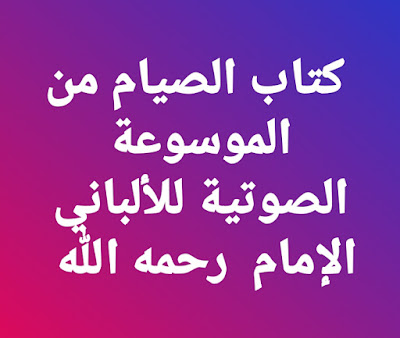

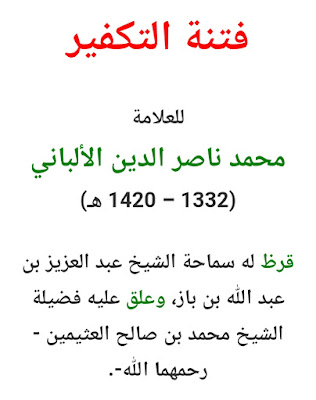

تعليقات
إرسال تعليق