4 - باب الوضوء
(4 - باب الوضوء)
(الفصل الأول: فرائض الوضوء] )
( [متى فُرض الوضوء؟] :)
فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم، لا لأنبيائهم.
(1 -[التسمية إذا ذكر] :)
(يجب على كل مكلَّف) : لمن أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب (أن يسمي) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، أنه قال: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى -؛ وأبو داود - رحمه الله تعالى -؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى -، والترمذي - رحمه الله تعالى -، في " العلل "، والدارقطني - رحمه الله تعالى -، وابن السكن - رحمه الله تعالى -، والحاكم - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى -، وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار.
وله طرق أخرى (1) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى -
والبيهقي - رحمه الله -.
وأخرج نحوه أحمد - رحمه الله تعالى -، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - من حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -، ومن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وسهل بن سعد - رضي الله عنه - وأبي سبرة - رضي الله عنه -، وأم سبرة - رضي الله عنها -، وعلي - رضي الله عنه -، وأنس - رضي الله عنه -.
ولا شك ولا ريب أنها جميعاً تنتهض للاحتجاج؛ بها، بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن، فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟ {ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف، وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه (2) .
(إذا ذكر) : تقييد الوجوب بالذِّكر؛ للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: " من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه " (3) ؛
أخرجه الدارقطني - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وفي إسناده متروك.
ورواه الدارقطني - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى - من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وفي إسناده - أيضا - متروك.
ورواه أيضا الدارقطني - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه ضعيفان.
وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها، وليس فيها أيضا دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذِّكر، ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان، وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز، فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية، ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية، وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذكر إشكال.
قال في " الحجة البالغة ": قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا وضوء لمن لا يذكر الله " هذا الحديث لم يُجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، وعلى تقدير صحته؛ فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي [صلى الله عليه وسلم] فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي [صلى الله عليه وسلم] ،
ويعلّمون الناس ولا يذكرون التسمية، حتى ظهر زمان أهل الحديث (4) ، وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التذكر بالقلب (5) ؛ فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية، وحينئذ يكون صيغة: " لا وضوء " على ظاهرها.
نعم؛ التسمية أدب كسائر الآداب - لقوله [صلى الله عليه وسلم]-: " كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر " (6) ، وقياساً على مواضع كثيرة.
ويحتمل أن يكون المعنى: لا يكمل الوضوء، لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل؛ فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. انتهى.
وأقول: قد تقرر أن النفي في مثل قوله: " لا وضوء ... " يتوجه إلى الذات إن أمكن، فإن لم يمكن؛ توجه إلى الأقرب إليها - وهو نفي الصحة -؛ فإنه أقرب المجازيْن، لا إلى الأبعد - وهو نفي الكمال -، وإذا توجه إلى الذات - أي: لا ذات وضوء شرعية، أو إلى الصحة -: دل على وجوب التسمية؛ لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية، أو انتفاء صحتها؛ فكان تحصيل ما يُحصِّل الذات الشرعية، أو صحتها واجباً، ولا يتوجه إلى نفي الكمال إلا لقرينة؛ لأن الواجب الحمل على الحقيقة، ثم على أقرب المجازات إليها إن تعذر الحمل على الذات، ثم لا يحمل على أبعد المجازات إلا لقرينة.
يمكن أن يقال: إن القرينة - ههنا - المسوِّغة لحمل النفي على المجاز الأبعد هي ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضائه "؛ وسنده ضعيف (7) .
__________
(1) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحُويني في جزء مفرد عنوانه: " كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء "، وهو مطبوع.
(2) الحديث الأول ضعيف؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة
قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
ووقع الإسناد للحاكم في " المستدرك ": " يعقوب بن أبي سلمة "} وزعم أنه الماجشون؛ فصححه لذلك، وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطأ، والصواب: " يعقوب بن سلمة الليثي "! ولو سُلّم أنه الماجشون؛ فإن أباه أبا سلمة - واسمه دينار - مجهول الحال، وعلى كل فالحديث ضعيف.
وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج؛ لأنها ضعيفة جداً، ولذلك قال أحمد ابن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد.
وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء - على أنها شرط فيه - دليل صحيح، والحق أنها سنة. (ش) .
قلت: ومناقشة هذا الكلام تراها في جزء " كشف المخبوء ... " الذي ذكرته آنفاً.
(3) انظر تعليق شيخنا على " المشكاة " (428) .
(4) ونِعْم الزمان هو!
(5) أما هذا: فلا.
(6) وهو حديث ضعيف من سائر طرقه؛ فانظر " الإرواء " (1) و (2)
(7) فلا قرينة - إذا -!!
__________________________
(2 -[المضمضة والاستنشاق] :)
(ويتمضمض ويستنشق) : وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله، وقد بين النبي [صلى الله عليه وسلم] ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا، ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق، فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملة المضمضة والاستنشاق.
وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني - رحمه الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالمضمضة والاستنشاق (1) .
وثبت في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أيضا - أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر ".
وثبت عند أهل " السنن " - وصححه الترمذي، رحمه الله تعالى - من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله تعالى عنه - بلفظ: " ... وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً (2) ".
وأخرج النسائي - رحمه الله تعالى - من حديث سلمة بن قيس - رضي الله تعالى عنه -: " إذا توضأت فانتثر ".
وأخرجه الترمذي - رحمه الله تعالى - أيضاً.
وفي رواية من حديث لقيط بن صَبِرة - رضي الله تعالى عنه - المذكور: " إذا توضأت فمضمض "؛ أخرجها أبو داود بإسناد صحيح.
وقد صحح حديث لقيط - رضي الله تعالى عنه - الترمذي - رحمه الله تعالى -، والنووي - رحمه الله تعالى -، وغيرهما؛ ولم يأت من أعلّه بما يقدح فيه.
وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد - رحمه الله تعالى -، وإسحاق - رحمه الله تعالى -، وبه قال ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى -، وحماد بن أبي سليمان - رحمه الله تعالى (3) -.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما.
حكى هذا المذهب النووي - رحمه الله تعالى - في " شرح مسلم " عن أبي ثور - رحمه الله تعالى -، وأبي عبيد - رحمه الله تعالى -، وداود الظاهري، وابن المنذر - رحمه الله تعالى -، ورواية عن أحمد - رحمه الله تعالى -.
وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، والثوري - رحمه الله تعالى -، وزيد بن علي - رحمه الله تعالى -.
وذهب مالك - رحمه الله تعالى -، والشافعي - رحمه الله تعالى -، والأوزاعي - رحمه الله تعالى -، والليث - رحمه الله تعالى -، والحسن البصري - رحمه الله تعالى -، والزهري - رحمه الله تعالى -، وربيعة - رحمه الله تعالى -، ويحيى بن سعيد - رحمه الله تعالى -، وقتادة - رحمه الله تعالى -، والحكم بن عتيبة - رحمه الله تعالى -، ومحمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -، إلى أنهما غير واجبين، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: " عشر من سنن المرسلين ... " - وهو حديث صحيح (5) -، ومن جملتها المضمضة والاستنشاق.
ورد بأنه لم يرو بلفظ: " عشر من السنن "، بل بلفظ: " عشر من الفطرة ... " (6) ، وعلى فرض وروده بذلك اللفظ: فالمراد بالسنة الطريقة، وهي تعم الواجب، لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول، فإن ذلك اصطلاح حادث، وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع!
وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - بلفظ: " المضمضة والاستنشاق سنة "؛ أخرجه الدارقطني - رحمه الله تعالى -، وإسناده ضعيف (7) .
والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره: ما دل عليه دليل من قوله [صلى الله عليه وسلم] أو فعله أو تقريره، ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن، فهذه اللفظة أعم من المدعى، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب، فيقال مثلا: الدليل على هذا الحكم من السنة.
ولا يقال: إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن المراد بالسنة - كما عرفت - في لسان الشارع، ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول؛ فتأمل!
__________
(1) وهو حديث معلول؛ فانظر " سنن البيهقي " (1 / 52) .
(2) رواه أيضا الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم البيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا البغوي وابن القطان.
ورواه أيضا الدولابي بلفظ: " وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".
قال ابن القطان: وهذا سند صحيح.
ورجحه على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذكر المضمضة. (ش)
(3) من الأدلة القوية على وجوب المضمضة والاستنشاق؛ أن غسلهما داخل في غسل الوجه؛ لأنهما عضوان منه، وقد واظب عليهما النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فالتحق عمله بالأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه بياناً له.
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": لم يحك أحد ممن وصف وضوءه -[صلى الله عليه وسلم]- على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق؛ بل ولا المضمضة؛ وهو يَرد على من لم يوجب المضمضة ". (ش) .
(5) لا؛ فقد رواه ابن عدي (3 / 13) بلفظ: " عشر من السنة ... "، بسند ضعيف.
(6) رواه مسلم (261) عن عائشة.
(7) انظر " التلخيص الحبير " (1 / 77 - الطبعة الأولى) .
__________________________
(3 -[غسل الوجه] :)
(ثم يغسل جميع وجهه) : والمراد بالوجه ما يسمى وجهاً عند أهل الشرع واللغة.
ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة، وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة.
(4 -[غسل اليدين مع المرفقين] :)
(ثم يديه مع مرفقيه) : هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند الدارقطني - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى -: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أدار الماء على مرفقيه، ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "؛ وفي إسناده ضعيفان هما: عباد بن يعقوب، والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل (1) .
ولكن يغني عن هذا الضعيف ما في " صحيح مسلم " من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أنه توضأ ثم غسل يده، حتى شرع في العضد. ثم قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يتوضأ هكذا.
وفي رواية الدارقطني - رحمه الله تعالى - من حديث عثمان - رضي الله عنه -: أنه غسل وجهه ويديه، حتى مس أطراف العضدين؛ قال الحافظ: وإسناده حسن.
وأخرج البزار والطبراني (2) من حديث ثعلبة بن عباد، عن أبيه - مرفوعاً -: ثم غسل ذراعيه، حتى يسيل الماء على مرفقيه.
وهذا بيان لما في القرآن، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها.
____________
(1) انظر " إرواء الغليل " (85) .
(2) قال الهيثمي في " المجمع " (1 / 224) : " ورجاله موثقون ".
__________________________
(5 -[مسح الرأس] :)
(ثم يمسح رأسه) : ولا خلاف فيه - في الجملة -، وإنما وقع الخلاف: هل المتعين مسح الكل؟ أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أم البعض، والسنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات، كما في " صحيح مسلم "، وغيره من حديث المغيرة - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] توضأ، ومسح بناصيته وعلى العمامة.
وأخرج أبو داود (1) - رحمه الله تعالى - من حديث أنس - رضي الله
عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر.
وهذه هي الهيئة التي استمر عليها [صلى الله عليه وسلم] ، فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي كان [صلى الله عليه وسلم] يداوم عليها - وهي مسح الرأس مقبلا ومدبرا -، وإجزاء غيرها في بعض الأحوال.
ولا يخفى أن قوله - تعالى -: {وامسحوا برؤسكم} لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال؛ نحو: ضربت رأس زيد، وضربت برأسه، وضربت زيداً، وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، وهكذا ما في الآية.
وليس النزاع في مسمى الرأس - لغة - حتى يقال: إنه - حقيقة - في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه، وعلى فرض الإجمال: فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع، وتارة بمسح البعض، بخلاف الوجه؛ فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال، بل غسله جميعا، وأما اليدان والرجلان؛ فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل.
فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به؛ قلت: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال: مسحت الثوب - أو بالثوب -، أو مسحت الحائط - أو بالحائط -، على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة.
وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في " حاشية الشفاء " وغيرها؛ فليراجع.
_____________
(1) برقم (147) ؛ وفي سنده جهالة.
__________________________
( [مسح الأذنين] :)
(مع أذنيه) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه [صلى الله عليه وسلم] مسحهما مع مسح رأسه، وقد ثبت عنه [صلى الله عليه وسلم] بلفظ: " الأذنان من الرأس " من طرق يقوي بعضها بعضا (1) .
(ويجزئ مسح بعضه)
قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: الفرض أدنى ما يطلق عليه اسم المسح.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: مسح ربع الرأس.
وقال مالك: مسح جميع الرأس.
في " سفر السعادة " (2) : وكان يمسح جميع رأسه أحيانا، وأحيانا يمسح على العمامة، وأحيانا يمسح على الناصية والعمامة، ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبدا، وكان يمسح الآذان ظاهرا وباطنا، ولم يثبت في مسح الرقبة حديث. انتهى.
__________
(1) بل كل طرقه ضعيفة، والضعيف لا حجة فيه وإن اعتضد بمئة ضعيف مثله؛ إلا ما كان ضعفه من قبل حفظ الراوي، فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه. (ش) .
قلت: بل الحديث حسن، وطرقه ترفعه إلى الحسن؛ فانظر " السلسلة الصحيحة " (1 / 1 / 81 - 93) و (1 / 2 / 903 - 906) .
(2) وهو كتاب نفيس جدا، وقد نشرناه بفضل الله وحسن توفيقه. (ش).
__________________________
( [المسح على العمامة] :)
(والمسح على العمامة) أو غيرها مما هو على الرأس، فقد ثبت ذلك عنه [صلى الله عليه وسلم] من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري - رحمه الله تعالى - وغيره، ومن حديث بلال - رضي الله عنه - عند مسلم - رحمه الله تعالى - وغيره، ومن حديث المغيرة - رضي الله عنه - عند الترمذي - رحمه الله، وصححه -.
وليس فيه المسح على الناصية، بل هو بلفظ: ومسح على الخفين والعمامة.
وفي الباب أحاديث غير هذه:
منها عن سلمان - رضي الله عنه - عند أحمد - رحمه الله تعالى -،
وعن ثوبان - رضي الله عنه - عند أبي داود وأحمد - رحمه الله - أيضا.
والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده، وعلى العمامة وحدها، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت.
وقد ورد في حديث ثوبان - رحمه الله - ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر، وهو عند أحمد - رحمه الله -، وأبي داود (1) - رحمه الله -: أنه [صلى الله عليه وسلم] بعث سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي [صلى الله عليه وسلم] شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين؛ وفي إسناده راشد بن سعد؛
قال الخلال في " علله ": إن أحمد - رحمه الله - قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان - رضي الله عنه - لأنه مات قديما (2) .
__________
(1) رواه أحمد (5 / 277) ، وأبو داود (146) .
(1) انظر " جامع التحصيل " (ص 174) .
__________________________
(6 -[غسل الرجلين] :)
(ثم يغسل رجليه) : وجهه ما ثبت عنه [صلى الله عليه وسلم] في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه؛ فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح؛ إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة، ويؤيد ذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] للماسحين على أعقابهم: " ويل للأعقاب من النار " - كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما -.
ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه [صلى الله عليه وسلم] بغسل الرجلين، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - عند الدارقطني (1) - رحمه الله -.
ويؤيده - أيضا - قوله [صلى الله عليه وسلم] : " فمن زاد على هذا أو نقص (2) فقد أساء وظلم "؛ وهو حديث رواه أهل " السنن "، وصححه ابن خزيمة - رحمه الله -، ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص.
وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه.
وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] للأعرابي: " توضأ كما أمرك الله " (3) ، ثم ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجلين.
وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار (4) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور.
قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع.
وقال الحافظ - رحمه الله - في " الفتح ": إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك؛ إلا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وابن عباس - رضي الله عنه -، وأنس - رضي الله عنه -، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك.
وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله -، قال: اجتمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- رضي الله عنهم - على غسل القدمين.
وقالت الإمامية (5) : الواجب مسحهما.
وقال محمد بن جرير، والحسن البصري - رحمه الله -، والجبائي: إنه مخير بين الغسل والمسح.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح.
ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر؛ وهي لا تدل على أن المسح متعين؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف، بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير، لو لم يرد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ما يوجب الاقتصار على الغسل.
أقول: الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح؛ لثبوت قراءة النصب والجر ثبوتاً لا ينكر (6) .
وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار، وأنه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس، بل هو معطوف على الوجوه، فلما جاور المجرور انجر.
وتعسف القائلون بالمسح، فحملوا قراءة النصب على العطف على محل الجار والمجرور في قوله: {برؤسكم} (7) ، كما أن قراءة الجر عطف على لفظ المجرور.
وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف، ولو وجد أحد القائلين بأحد التأويلين اسما مجرورا في رواية ومنصوبا في أخرى مما لا يتعلق به الاختلاف، ووجد قبله منصوبا لفظا ومجرورا: لما شك أن النصب عطف على المنصوب والجر عطف على المجرور، وإذا تقرر هذا؛ كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده، لا على مشروعية الجمع بينهما؛ وإن قال به قائل - فهو من الضعف بمكان؛ لأن الجمع بين الأمرين لم يثبت في شيء من الشريعة -.
انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء؛ فإن الله سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط، وكذلك في اليدين، وشرع في الرأس المسح فقط؛ ولكن الرسول [صلى الله عليه وسلم] قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحهما، فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه [صلى الله عليه وسلم] ، وكلها مصرحة بالغسل، ولم يأت في شيء منها المسح إلا في مسح الخفين، فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها للغسل والمسح؛ فالواجب الغسل بما وقع منه [صلى الله عليه وسلم] من البيان المستمر جميع عمره (8) .
وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال؛
فقد ورد في السنة الأمر بالغسل ورودا ظاهرا؛ ومنه الأمر بتخليل الأصابع؛ فإنه يستلزم الأمر بالغسل؛ لأن المسح لا تخليل فيه، بل يصيب ما أصاب، ويخطئ ما أخطأ.
والكلام على ذلك يطول جدا.
والحاصل: أن الحق ما ذهب إليه الجمهور؛ من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح (9) .
قال في " الحجة البالغة ": ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء، فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية (10) ؛ فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول، وبين من أنكر غزوة بدر وأحد - مما هو كالشمس في رابعة النهار -.
نعم؛ من قال بأن الاحتياط (11) الجمع بين الغسل والمسح، أو أن أدنى الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.
قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.
(مع الكعبين) ؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [صلى الله عليه وسلم] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.
__________
(1) في " سننه " (1 / 107) ، وقد ضعفه النووي في " المجموع " (1 / 417) .
(2) زيادة: " أو نقص ": لا تصح؛ فانظر " فتح الباري " (1 / 233) ، و " عون المعبود " (1 / 229) .
(3) رواه أبو داود (861) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح.
وانظر " نصب الراية " (1 / 367) .
(4) كما قال ابن زنجلة في " حجة القراءات " (ص 223) ، ثم قال: " كما يقال: هذا جحر ضب خرب ".
(5) وهم الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية {}
(6) سيرجح المصنف - بعد أن الغسل - فقط - هو الواجب.
وأما كلامه - هنا -: فمتعلق بالدلالة اللغوية.
(7) هذا هو الصحيح من جهة العربية، وليس فيه تعسف. (ش) .
(9) انظر التعليق السابق.
(10) على إحدى القراءتين.
(11) وبابه واسع!!
__________________________
( [شروط المسح على الخفين] :)
(1 -[أن يلبسهما على طهارة] :)
(وله المسح على الخفين) ، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.
قال الشافعي - رحمه الله -: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: عند الحدث.
ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يمسح إلا الأعلى.
وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواتراً عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من فعله وقوله.
وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: فيه أربعون حديثا، وكذلك قال غيره.
وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله -: إنه رواه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من الصحابة (رض) (1) أحد وأربعون رجلا.
وقال ابن عبد البر - رحمه الله -: أربعون رجلا.
وقال ابن منده: إن الذين رووه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ثمانون رجلا.
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك - رحمه الله -، أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
وقد ذكر أحمد - رحمه الله - أن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في إنكار المسح باطل.
وكذلك ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس - رضي الله عنه - قد أنكره الحفاظ، ورووا عنهم خلافه.
وكذلك ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: سبق الكتاب الخفين؛ فهو منقطع.
وقد روى عنه مسلم - رحمه الله -، والنسائي - رحمه الله - القول بالمسح عليهما بعد موت النبي [صلى الله عليه وسلم] .
وقد روى الإمام المهدي (2) في " البحر " عن علي - رضي الله عنه - القول بمسح الخفين.
وقد ثبت في " الصحيح " من حديث جرير - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] مسح على الخفين؛ وإسلام جرير - رضي الله تعالى عنه - كان بعد نزول المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع.
وقد روى المغيرة - رضي الله عنه - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق.
وقد ذكر البزار - رحمه الله - أن حديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا رواه عنه ستون رجلا.
وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام عليهما، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بها، حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد.
(2 -[أن يكون المسح مؤقتا] :)
وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، وبيوم وليلة للمقيم.
قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " (3) : سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
عن المسح على الخفين؟ فقال: " للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما "، وسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبي بن عمارة - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: " نعم "، قال: يوما؟ قال: " ويومين "، قال: وثلاثة أيام؟ قال: " نعم، وما شئت ". ذكره أبو داود (4) - رحمه الله -.
وطائفة قالت: هذا مطلق، وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق انتهى.
وأما مسح الرقبة؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة (5) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في " شرح المنتقى " (6) ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة.
__________
(1) اختصار (رضي الله عنه) . (ش)
(2) هو من أئمة الزيدية!
وكتابه هو " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار "، وانظر (1 / 70) - منه -.
(3) وهو كتاب نادر المثال، وقد وفقنا الله لنشره، والحمد لله. (ش)
(4) (158) ، وابن ماجه (557) .
وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته -.
(5) وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1 / 49) : " ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ".
انظر " السلسلة الضعيفة " (69) و (744) .
(6) " نيل الأوطار " (1 / 163 - 164) .
__________________________
(3 -[النية] :)
(ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة) ؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وهو في " الصحيحين " وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ.
قال في " التلخيص ": لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - من لم يخرجه؛ سوى مالك - رحمه الله -، فإنه لم يخرجه في " الموطأ "، وإن كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلك، وادعى أنه في " الموطأ " (1) .
قال الهروي: كتب هذا الحديث عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد.
قلت: تتبعته من الكتب والأجزاء، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا، هذا ما كنت وقفت عليه؛ ثم إن في " المستخرج لابن منده " - رحمه الله - عدة طرق، فضممتها إلى ما عندي، فزادت على ثلاث مئة طريق. انتهى.
فإن كان المقدر عاما (2) فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، وإن كان خاصا؛ فأقرب ما يقدر الصحة، وهي تفيد ذلك.
قال في " الفتح ": " وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في الوسائل ".
ومن ثم خالفت الحنفية - رحمهم الله - في اشتراطها للوضوء، ورد ابن القيم - رحمه الله - على الحنفية - رحمهم الله - بأحد وخمسين وجها في " إعلام الموقعين " فليرجع إليه.
وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي - رحمه الله -، ومالك - رحمه الله -، والليث - رحمه الله -، وربيعة - رحمه الله -، وأحمد بن حنبل - رحمه الله -، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله -.
_____________
(1) بل هو في " الموطأ " (982 - رواية محمد بن الحسن الشيباني) .
(2) • أي: لا عمل إلا بالنية، ولما كان هذا متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية -؛ قيده الشارع بالعمل الشرعي، وإن كان خاصاً بالأعمال - الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث. (ن)
__________________________
( [فصل: سنن الوضوء] )
(1 -[التثليث] )
(ويستحب التثليث) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه
[صلى الله عليه وسلم] غسل كل عضو ثلاث مرات، وبيّن أن الواجب مرة واحدة.
(في غير الرأس) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه (1) .
( [بيان حكم الترتيب] :)
وأما الترتيب: فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب: أن الآية مجملة باعتبار أن (الواو) لمطلق الجمع على أي صفة كان؛ فبيّن النبي [صلى الله عليه وسلم] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه، وهي مرتبة.
وأيضا؛ الوضوء الذي قال فيه [صلى الله عليه وسلم] : " لا يقبل الله الصلاة إلا به " كان مرتبا (2) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال -؛ لكنها يقوي بعضها بعضا؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا عن أبي هريرة: " إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم " (3) :
قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح.
وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في " شرح المنتقى ".
__________
(1) قارن ب " نصب الراية " (1 / 34) للزيلعي.
(2) قارن ب " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 1 / 523 - 525) .
(3) انظر " صحيح سنن ابن ماجه " (323) .
__________________________
(2 -[إطالة الغرة والتحجيل] :)
(وإطالة الغرة والتحجيل) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة، كقوله [صلى الله عليه وسلم] :
" إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء " (1) ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
__________
(1) رواه البخاري (136) ، ومسلم (246) .
وأما ما بعده: فمدرج؛ فانظر " الضعيفة " (1030) .
__________________________
(3 -[السواك] :)
(وتقديم السواك استحباباً) : وجهه الأحاديث المتواترة من قوله [صلى الله عليه وسلم] وفعله، وليس في ذلك خلاف.
قال في " الحجة ": " قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "؛ معناه: لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا للصلاة كالوضوء؛ وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جدا؛ وهي دلائل واضحة على أن لاجتهاد النبي [صلى الله عليه وسلم] مدخلاً في الحدود الشرعية، وأنها منوطة بالمقاصد، وأن رفع الحرج من الأصول التي بُني عليها الشرائع.
وقول الراوي في صفة تسوكه [صلى الله عليه وسلم] : يقول: أع أع؛ كما يتهوع.
أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم، فيخرج بلاغم الحلق والصدر، والاستقصاء في السواك يذهب بالقُلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة ". انتهى.
(4 -[غسل الكفين ثلاثاً] :)
(وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة) :
لحديث أوس بن أوس الثقفي، قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ، فاستوكف ثلاثاً "؛ أي: غسل كفيه، أخرجه أحمد - رحمه الله -، والنسائي - رحمه الله -.
وثبت في " الصحيحين " من حديث عثمان - رضي الله عنه -: " فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ".
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يروونه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] .
(فصل: [نواقض الوضوء] )
(1 -[خروج شيء من أحد السبيلين] :)
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح) : فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.
(2 -[الجماع] :)
(وبما يوجب الغسل) في الجماع، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا.
(3 -[نوم المضطجع] :)
(ونوم المضطجع) : وجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث: " من نام فليتوضأ " مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها (1) ؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة.
وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في " مسك الختام شرح بلوغ المرام "، واستوفاها الماتن في " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار "، وذكر الأحاديث المختلفة وتخريجها، وترجيح ما هو الراجح.
قال الشافعي - رحمه الله -: النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكِّن مقعدته.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لو نام قائماً أو قاعداً أو ساجداً؛ لا وضوء عليه، حتى ينام مضطجعاً أو متكئاً ".
كذا في " المسوى ".
__________
(1) • هذه الدعوى باطلة؛ فإن شرط انجبار الحديث بكثرة الطرق؛ أن لا يكون فيها متهم أو متروك؛ كما بينه النووي وغيره في (مصطلح الحديث) .
ويدلك على ذلك أنه كم من حديث له من الطرق أكثر من هذا بكثير؛ ومع ذلك فقد ظلوا يحكمون عليها بالضعف؛ وهذا الحديث لا يوجد فيه هذا الشرط؛ على قلتها - أعني: طرقه -، وهي ثلاثة:
الأول: حديث ابن عباس، وله أربع - بل خمس - علل بيناها في " الأحاديث الضعيفة " التي جردناها من " سنن أبي داود " رقم (26) .
الثاني: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال الشوكاني في " النيل " (1 / 170) : " وفيه مهدي بن هلال؛ وهو متهم بوضع الحديث، ومن رواية عمر بن هارون البلخي؛ وهو متروك، ومن رواية مقاتل بن سليمان؛ وهو متهم ".
الثالث: حديث حذيفة؛ أخرجه البيهقي (1 / 120) ، وقال: " ينفرد به بحر بن كنيز السقاء؛ وهو ضعيف ولا يحتج بروايته ".
فمثل هذه الطرق لا ينجبر بها الحديث؛ بل تزيده وهنا على وهن. (ن) .
قلت: وانظر " تمام المنة " (99) .
__________________________
(4 -[أكل لحم الإبل] :)
(وأكل لحم الإبل) : وجهه قوله [صلى الله عليه وسلم]- لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ - قال: " نعم "، وهو في " الصحيح " من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
وقد روي - أيضا - من طريق غيره.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار.
ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخاً.
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل - رحمه الله -، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله -، ويحيى بن يحيى - رحمه الله، وابن المنذر - رحمه الله -، وابن خزيمة - رحمه الله -، والبيهقي - رحمه الله -، وحكي عن أصحاب الحديث - رحمهم الله -، وحكي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - كما قال النووي رحمه الله.
قال البيهقي - رحمه الله - حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي
- رحمه الله - أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي - رحمه الله -: قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، وحديث البراء - رضي الله عنه -.
قال في " الحجة ": " وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج (1) ، وقال به أحمد (رح) (2) ، وإسحاق (رح) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان. والله أعلم ".
وقد أطال ابن القيم (رح) في " إعلام الموقعين " (3) في إثبات النقض به.
أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن: أخرجه مسلم و " أهل السنن "، وصححه جماعة من غيرهم؛ ولم يأت عنه [صلى الله عليه وسلم] ما يخالف هذا من قول أو فعل أو تقرير، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما تقدم -.
ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة؛ فهي مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني.
وأما حمل الوضوء على غسل اليد؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع
على الحقائق الشرعية إن وجدت، وهي ههنا موجودة؛ فإنه في - لسان الشارع وأهل عصره -؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط.
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء (4) .
__________
(1) أي: ذكر الأدلة، والترجيح بينها.
(2) اختصار (رحمه الله) . (ش)
(3) • (2 / 97 - 100) . (ن)
(1) انظر " السلسلة الضعيفة " (168) .
__________________________
(5 -[القيء] :)
(والقيء) : وجهه ما روي عنه [صلى الله عليه وسلم] : أنه قاء فتوضأ (1) ؛ أخرجه أحمد (رح) ، و " أهل السنن " (رح) .
قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب.
وصححه ابن منده (رح) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث، منها: حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، عنه [صلى الله عليه وسلم] : " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ "؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال (2) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به.
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (رح) ، وأصحابه (رح) .
وذهب الشافعي (رح) وأصحابه (رح) إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين! ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة.
وفي " الحجة البالغة ": قال إبراهيم (رح) بالوضوء من الدم السائل والقيء الكثير، والحسن (رح) بالوضوء من القهقهة في الصلاة، ولم يقل بذلك آخرون، وفي كل حديث لم يُجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه.
والأصح في هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن لا: فلا سبيل عليه في صراح الشريعة.
والدم السائل والقيء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس، والقهقهة في الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفّارة، فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه، ولا عجب أن يأمر ويرغب فيه من غير عزيمة.
وفي " المسوى ": قال الشافعي - رحمه الله -: خروج النجاسة من غير الفرجين لا يوجب الوضوء.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يوجبه بشرطه. انتهى (3) .
__________
(1) استحباباً، لا وجوباً؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في " الاختيارات العلمية " (16) .
(2) انظر " نصب الراية " (1 / 38)
(3) الأحاديث المروية في نقض الوضوء بالقيء ضعيفة، لا تصلح للاللاحتجاج، وكذلك ما ورد في النقض بخروج النجاسة من غير السبيلين.
وأما أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة؛ فإنها من أضعف الحديث، بل حكم كثير من الحفاظ بأنها موضوعة.
والحق أن ليس شيء من هذا ناقضاً للوضوء. (ش)
__________________________
( [القلس والرعاف] :)
(ونحوه) والمراد بنحو القيء: هو القلس والرعاف، والخلاف في القلس كالخلاف في القيء.
قال الخليل (1) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء -.
وفي " النهاية ": القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل.
وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة - رحمه الله -، وأبو يوسف - رحمه الله -، ومحمد - رحمه الله -، وأحمد بن حنبل - رحمه الله -، وإسحاق - رحمه الله -، وقيدوه بالسيلان.
وذهب ابن عباس - رضي الله عنه -، ومالك - رحمه الله -، والشافعي - رحمه الله - وروي عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -، وأبي هريرة - رضي الله عنه -، وجابر بن زيد - رضي الله عنه -، وابن المسيب - رحمه الله -، ومكحول - رحمه الله -، وربيعة - رحمه الله - إلى أنه غير ناقض.
وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال، وبالمعارضة بمثل حديث: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] احتجم، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه؛ رواه الدارقطني (2) - رحمه الله -، وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف.
ويُجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه (3) ، وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في النقض.
في " المسوى " قال الشافعي - رحمه الله -: الرعاف والحجامة لا ينقضان الوضوء.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ينقضان إذا كان الدم سائلاً.
وقال مالك - رحمه الله -: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. (4) انتهى.
أقول: قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم، وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها، وقد تقرر أن كون الشيء ناقضاً للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج؛ وإلا وجب البقاء على الأصل؛ لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله، وإلا فليس بشرع.
ومع هذا؛ فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يباشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس، فلو كان خروج الدم ناقضاً: لما ترك [صلى الله عليه وسلم] بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه، وكثرة الحامل عليه.
ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض، وغاية ما
هناك حديث إسماعيل بن عياش، وفيه من المقال ما لا يخفى.
__________
(1) هو الفراهيدي؛ الإمام المشور.
(2) (1 / 51) ، وضعفه النووي في " المجموع " (2 / 42) .
(3) أما هذا: فلا!
(4) وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم.
__________________________
(6 -[مس الذكر] :)
(ومس الذكر) : وقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها -، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ "؛ رواه أحمد - رحمه الله -، وأهل " السنن " - رحمهم الله -، ومالك - رحمه الله -، والشافعي - رحمه الله -، وابن خزيمة - رحمه الله -، وابن حبان - رحمه الله -، والحاكم - رحمه الله -، وابن الجارود.
وصححه أحمد - رحمه الله -، والترمذي - رحمه الله -، والدارقطني - رحمه الله -، ويحيى بن معين - رحمه الله -، والبيهقي - رحمه الله -، والحازمي - رحمه الله -، وابن حبان - رحمه الله -، وابن خزيمة - رحمه الله -.
قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ منهم: جابر - رضي الله عنه -، وأبو هريرة - رضي الله عنه -، وأم حبيبة - رضي الله عنها -، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وزيد بن خالد - رضي الله عنه -، وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، وعائشة - رضي الله عنها -، وابن عباس - رضي الله عنهما -، ابن عمرو - رضي الله عنهما -، والنعمان بن بشير - رضي الله عنه -، وأنس - رضي الله عنه -، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة (1) - رضي الله عنه -، وقبيصة - رضي الله عنه -، وأروى بنت أُنيس (2) - رضي الله عنها - (3) .
وحديث بسرة - رضي الله عنها - بمجرده أرجح من حديث طلْق بن علي - رضي الله عنه - عند أهل " السنن " - رحمهم الله - مرفوعاً، بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال [صلى الله عليه وسلم] : " إنما هو بضعة منك "؛ فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة - رضي الله عنها - أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟ {ومن مال إلى ترجيح حديث طلق: فلم يأت بطائل}
وقد تقرر في الأصول: أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي، وأن المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة.
قد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم، والأئمة - رحمهم الله -، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة؛ لتأخر إسلامها.
وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك.
والحق الانتقاض.
وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج؛ وهو أعم من
القُبُل والدُبُر، كما أخرجه ابن ماجه - رحمه الله - من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، قالت: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من مس فرجه فليتوضأ "، وصححه أحمد - رحمه الله -، وأبو زرعة - رحمه الله -، وقال ابن السكن - رحمه الله -: لا أعلم له علة.
وأخرج الدارقطني - رحمه الله - من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: " إذا مسّت إحداكن فرجها فلتتوضأ "؛ وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله العمري؛ وفيه مقال (4) .
وأخرج أحمد - رحمه الله -، والترمذي - رحمه الله -، والبيهقي - رحمه الله -، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ "، وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث (5) .
قال في " المسوى ": قال الشافعي - رحمه الله -: يجب الوضوء على من مس الفرج، وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: مس الفرج لا ينقض؛ واحتج بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " هل هو إلا بضعة منك؟ ! ". انتهى.
قالوا: إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة، والبلوى به دائمة: وجب أن ينقل شرعاً ثابتاً متواتراً مستقراً.
أقول: قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن يُنقل نقلاً مستفيضاً؛ والقائل بذلك بعض الحنفية.
وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد.
وهذه القاعدة كثيراً ما ترى المشغوفين بمحبة ما ألفوه من مذاهب الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم {فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا، وصار عندهم من المألوفات المعروفات: مالوا عن ذلك ولم يُعرِّجوا عليه، وهذا ستراه في غير موطن من كتب المتمذهبين، فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات، ولا يغره سراب التلبيسات: فلا تلعب بك الرجال من حال إلى حال بزخارف ما تنمقه من الأقوال.
(فكن رجلا رِجْله في الثَّرى ... وهامة همته في الثُرَيّا)
ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه؛ إنما الشأن في التكلم في مواطن الخلاف بما يتبرأ منه الإنصاف، اللهم} بصرنا بالصواب، واجعل بيننا وبين العصبية من لطفك أمنع حجاب.
وفي " الحجة البالغة ": " موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات:
إحداها: ما اجتمع عليه جمهور الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع، وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم الثقيل وما في معناها.
الثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -، وتعارض فيه الرواية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ؛ كمس الذكر لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " من مس ذكره فليتوضأ "؛ قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم - رضي الله عنهم -، ورده علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - وفقهاء الكوفة، ولهم قوله [صلى الله عليه وسلم] : " هل هو إلا بضعة منك؟ ! "؛ ولم يجيء الثلج (6) بكون أحدهما منسوخاً.
___________
(1) في الأصل: معاوية بن أبي حيدة؛ وهو خطأ. (ش)
(2) هي غير معروفة، والإسناد إليها ضعيف.
واختُلف فيها؛ فقال بعضهم: أروى؛ ولم يذكر اسم أبيها.
وقال بعضهم: أروى بنت أنيس.
وقال بعضهم: عن أبي أروى؛ فقط! (ش)
(3) انظر " التلخيص الحبير " (1 / 122 - 124) .
(4) بل هو كذّاب، انظر " المجروحين " (2 / 53) لابن حبان.
(5) فهو حسن؛ وقد نقل الحافظ في " التلخيص " (1 / 124) تصحيحه عن البخاري.
(6) أي: الاطمئنان
__________________________
( [لمس المرأة لا ينقض الوضوء] :)
ولمس المرأة، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم -؛ لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (1) ، ولا يشهد له حديث، بل يشهد حديث عائشة - رضي الله عنها - بخلافه، لكن فيه نظر؛ لأن في إسناده انقطاعاً (2) .
وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض. والله تعالى أعلم.
وبالجملة: فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره، وتارك له رأساً، وفارق بين الشهوة وغيرها.
ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع، أن مس الذكر فعل شنيع، ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاء، فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة.
والثالثة: ما وُجد فيه شبهة من لفظ الحديث؛ وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - على تركه.
( [الوضوء مما مسته النار منسوخ] :)
كالوضوء مما مست النار؛ فإنه ظهر عمل النبي [صلى الله عليه وسلم] ، والخلفاء، وابن عباس، وأبي طلحة وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - بخلافه، وبيّن جابر - رضي الله عنه - أنه منسوخ.
قلت: " عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وتأول بعضهم على غسل اليد والفم، قال قتادة - رضي الله عنه -: من غسل فمه فقد توضأ ". كذا في " المسوى ".
__________
.
(1) انظر كتاب " القراءات وأثرها في الأحكام " (1 / 419 - 425) للأخ الشيخ محمد عمر بازمول.
(2) بل هو حسن؛ فانظر " صحيح سنن ابن ماجه " (406) .
ولفظه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قبّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.



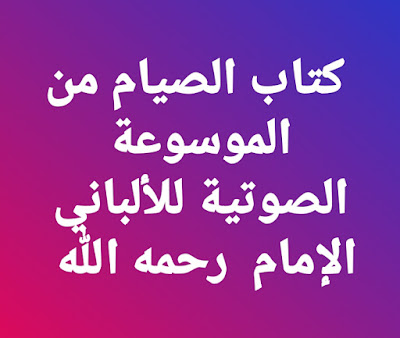

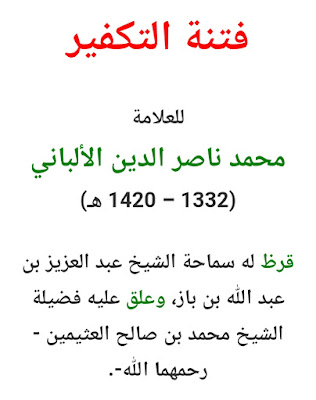

تعليقات
إرسال تعليق