باب ما جاء في الجنة والنار و فصل في الإيمان بالقضاء والقدر
باب ما جاء في الجنة والنار
س)- هل هناك دليل صريح صحيح يدل على فناء نار الكافرين؟
النار في الآخرة ناران ، نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى ، فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين ، والأخرى نار الكفار والمشركين ، هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في " الوابل الصيب " وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة ، فلا تغتر بما ذكره شارح الطحاوية وابن القيم في "شفاء العليل" و"حادي الأرواح" مما قد ينافي هذا الذي لخصته فإنهما لم يتبنيا ذلك وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء الكافرين والله تعالى كما قال في أهل الجنة : (لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين )الحجر48 ، قال مثله في الكافرين : (وما هم بخارجين من النار)البقرة 167 ، وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليقي على "شرح الطحاوية"فتنبه ثم في "الأحاديث الضعيفة".
انتهى كلام الالباني من شرح العقيدة الطحاوية.
س)- ما حكم القول بفناء النار؟
قال صلى الله عليه وسلم (أما أهل النار الذين هم أهلها (وفي رواية: الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم) فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (يريد الله عز وجل إخراجهم) فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل) ، وفي الحديث دليل صريح على خلود الكفار في النار، وعدم فنائها بمن فيها، خلافاً لقول بعضهم،لأنه لو فنيت بمن فيها لماتوا واستراحوا، وهذا خلاف الحديث، ولم ينتبه لهذا ولا غيره من نصوص الكتاب والسنة المؤيدة له؛ من ذهب من أفاضل علمائنا إلى القول بفنائها، وقد رده الإمام الصنعاني رداً علمياً متيناً في كتابه(رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار)، وقد حققته وخرجت أحاديثه وقدمت له بمقدمة ضافية نافعة، وهو تحت الطبع، وسيكون في أيدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى.
انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم1551.
س)- كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟
هذا كما يقول الصوفية -تماماً-: كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكشف فلا يناله غير الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، هذا تمثيل يُمثَّل للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات شتى، منها في قصة كسوف الشمس، حين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف رأوه يتقدم كأنه يريد أن يقبض شيئاً، ثم رؤي يتقهقر، حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخلت الصفوف بعضها في بعض، ثم بعد الصلاة سألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: (عرضت عليّ الجنة في جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها، ورأيت عنبها، فهممت أن أقتطف منها)، ثم تذكر -فيما يبدو، وهذا ليس في الحديث- أنها محرمة إلا لمن دخلها، ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها، فتقهقر عليه الصلاة والسلام فهذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.
دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
س)- ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: (لن تمسهما النار إلا تحلة القسم)؟
هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً) [مريم:71] (وَإِنْ مِنْكُمْ) قسم من الله، (إِلَّا وَارِدُهَا) اختلف العلماء قديماً وحديثاً في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: القول الأول: الورود بطرف النار، كما يقال: أورد الإبل الحوض. والقول الثاني: المرور على الصراط من فوق النار. والقول الثالث وهو لا ينافي الثاني: الدخول في النار؛ لأن المرور على الصراط هو دخول في النار. فقوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) [مريم:71] أي: داخلها، لا فرق بين مؤمن وكافر، كلهم من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول، لكن بعد أن يتحقق هذا القسم الإلهي من الدخول هناك، بعد ذلك سرعان ما يتميز الصالح من الطالح، فالصالح يدخل الجنة، والطالح يدخل النار. ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل، لكن لا بد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده؛ لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيهاً على ضعفه، لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة. ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين -وهو العلة- عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه فقال: (كنا في مجلس ذكرت فيه هذه الآية: (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ))[مريم:71] قال: فاختلفنا -وذكر الأقوال الثلاثة- فما كان من جابر -كما تقول الرواية على ضعفها- إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال: صُمَّتا صُمَّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها، ثم تكون برداً وسلاماً على المؤمنين، كما كانت على إبراهيم). إذاً: هذا الدخول المذكور في هذه الآية، والمفسر أيضاً في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة، قالت: كيف هذا يا رسول الله! والله عز وجل يقول: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )[مريم:71]؟ ) وهنا ملاحظة مهمة من حيث أنها تساعد طالب العلم على فهم النصوص الشرعية: نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول: إن الذي تقوله يا رسول الله! خلاف ما أفهم من الآية، فالآية: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) [مريم:71] ولفظة (منكم) تشمل بلا شك أهل بدر وأصحاب الشجرة، فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي، -أي: حفصة - وبين ما تقوله يا رسول الله؟! فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام وديدنه: (فاقرئي ما بعدها: (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً) [مريم:72] ) ما هي الفائدة؟ الفائدة: أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع قولاً ولم ينكره؛ كان ذلك دليلاً على صحته في نفسه، ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيص وتقييد لا يخطر على بال المتكلم بتلك الكلمة. وهذه فائدة مهمة جداً قد يغفل عنها بعض أهل العلم، ولا بأس من أن أضرب لكم مثلاً وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة.. فالإمام أبو محمد بن حزم صاحب الكتاب العظيم كتاب المحلى، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام، وغيره من الكتب، قد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية، والأغاني، وما شابه ذلك، وكان مما استدل به على ما ذهب إليه في تلك الرسالة، الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليَّ يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وتضربان عليه بدف، ولما دخل أبو بكر قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟! -وهذا استفهام استنكاري- فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). الشاهد: أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث على جواز الضرب بالدف والغناء به؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الجاريتين على ذلك، ولكن فاته ما أردت التنبيه عليه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر الصديق على قوله السالف الذكر: (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟!) فقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به، سماه مزمار الشيطان، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، بل أقره، كما أقر حفصة على قولها في الآية هكذا، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل على استدلال حفصة قيداً كانت غافلة عنه، كذلك تماماً فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق، فلفت نظره كأنه يقول له: إن الأمر كما تقول أنت يا أبا بكر! لكن هنا استثناء قد فاتك: (دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). فإذا نحن جمعنا بين إقرار الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر على قوله: (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!)، وبين قوله له: (دعهما، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا) فإننا نخرج بنتيجة: أن مزامير الشيطان لا تجوز، ويكفي في النهي عنها النسبة إلى الشيطان. لكن هذا الحكم يستثنى منه الضرب بالدف في يوم العيد، وممن؟ من الجاريتين، فجمعنا بين إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ؛ وبين قوله له، وخرجنا بنتيجة معاكسة تماماً للنتيجة التي ذهب إليها أبو محمد بن حزم رحمه الله، حيث أخذ قول الرسول عليه السلام ولم يتنبه لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر : (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟!).
دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
فصل في الإيمان بالقضاء والقدر
س)- قال تعالى: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً) [الإسراء:46] يشم البعض منها رائحة الجبر، فما رأيكم؟
الجعل هو جعل كوني، ولفهم هذا لا بد من شرح الإرادة الإلهية، فإن الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: - إرادة شرعية. - وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي: كل ما شرعه الله عز وجل لعباده، وحضهم على القيام به، من طاعات وعبادات، على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات، وهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. أما الإرادة الكونية فهي: قد تكون تارة مما شرع الله وأحبها لعباده، وقد تكون تارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها، وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقاً من قوله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس:82] فشيئاً: اسم نكرة يشمل كل شيء؛ سواءً كان طاعة أو كان معصية، إنما يكون ذلك بقوله تعالى: (كن). أي: بمشيئته وبقضائه وقدره، فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية، وهي أنها تشمل كل شيء؛ سواء كان طاعة أو كان معصية، حين ذلك لا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر؛ لأن قوله عز وجل: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس:82] معنى ذلك أن هذا الذي قال له (كن) جعله أمراً مقدراً كائناً لا بد منه. حينئذٍ طرقنا بحث القضاء والقدر مراراً وتكراراً، وقلنا: إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر، أيضاً هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر إلى ما نقوم به نحن، حيث إنه: إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغماً عنا، وهذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار، وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون جزاء الإنسان الجنة أو النار. أي: ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره، فهو الذي يحاسب عليه الإنسان إن خيراً فخير أو شراً فشر، هذه حقيقة! أي: كون الإنسان مختاراً في قسم كبير من أعماله؛ فهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعاً ولا عقلاً، أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة يأمر الإنسان في أن يفعل ما أمر به، وفي أن يترك ما نهي عنه، وهي أكثر من أن تذكر، وأما عقلاً فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلم .. حينما يمشي .. حينما يأكل .. حينما يشرب .. حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره؛ فهو مختار في ذلك وغير مضطر إطلاقاً. هأنذا أتكلم معكم الآن، لا أحد يجبرني بطبيعة الحال، ولكنه مقدر، فمعنى كلامي هذا مع كونه مقدراً، أي: أنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به، أنا الآن أتابع الحديث
ولا أسكت، ولكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك مما أقول أني مختار في هذا الكلام، هأنا أصمت الآن ولو للحظات؛ لأنني مختار. إذاً فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يحتاج المناقشة والمجادلة، وإلا يكون الذي يجادل في مثل هذا إنما هو يسفسط ويشكك في البديهيات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذاً: أعمال الإنسان تنقسم إلى قسمين: اختيارية، واضطرارية. فالاضطرارية ليس لنا فيها كلام، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية، فهذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا؛ استطعنا أن نفهم الآية السابقة: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) [الإسراء:46] فهذا الجعل كوني، ويجب أن تتفكروا في الآية السابقة (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً) [يس:82] كوني، ولكن ليس رغماً عن هذا الذي جعل الله على قلبه أكنة، هذا مثاله من الناحية المادية: الإنسان حينما يخلق، يخلق ولحمه غض طري، ثم إذا ما كبر، وكبر، وكبر، يغلظ لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء، ففرق كبير جداً بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، ويقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها، وينصب في كل جهوده عليها، لكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى، وعضلاته لا تنمو. والعكس بالعكس تماماً؛ بالنسبة لشخص منصب على الناحية المادية، فهو كل يوم يتعاطى تمارين رياضية، فهذا تشتد عضلاته، ويقوى جسده، ويصبح له صورة، كما نرى ذلك أحياناً في الواقع وأحياناً في الصور، فهؤلاء الأبطال -مثلاً- تصبح أجسادهم كلها عضلات، فهل هو خلق هكذا، أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره. ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله، وفي عناده، وفي كفره وجحوده، فيصل إلى الران .. إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم؛ وإنما بسبب كسبهم واختيارهم، فهذا هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار، فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال أنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، وإنما ذلك بما كسبت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد.
دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
س)- ما رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في صحيح مسلم ولفظه: (إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي) علماً بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله: وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعر بعدم الوجوب؟
الواقع أن هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية.. (وأراد أحدكم أن يضحي) نحن نقول: نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جداً بموضوعنا السابق، أي: إن الإنسان مكلف بالعبادة وبالطاعة، فهو عليه أن يريدها، وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضاً، ويقصره على ذلك قصراً، لا. فالنكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان من هذه الناحية، وهذا واضح جداً في نفس القرآن الكريم (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) [التكوير:28] إذاً: الاستقامة على هذا الفهم -مع الأسف أن هذا الفهم نسب إلى بعض الأئمة- ينتج قياساً على هذا الفهم أن الاستقامة غير واجبة، لماذا؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، فكل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك، ولذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادخر لنا وما خبئ لنا من مثل هذا السؤال، قلنا: إن الإرادة قسمان: إرادة كونية، وإرادة شرعية، فالبحث ليس في الإرادة الكونية، وإنما في الإرادة الشرعية، فالمفهوم هنا: يجب أن تفعل، وإن لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية إلى الإرادة الكونية؛ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون رغماً عن الله عز وجل، فهنا لما قال الله عز وجل: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) [التكوير:28] لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ الجواب: لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية، ولكن على سبيل التفريع، قال عليه الصلاة والسلام: (من أراد الحج فليعجل) أيضاً نسب الإرادة هنا للإنسان في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب: لا. لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفاً، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه، ولذلك -كما تعلمون في الحديث الصحيح- (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ).
دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
س)- هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبراً؟
هذا سؤال قديم لكنه حديث في التعبير، هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مقدرة للعبد أم لا؟ أما الجواب العقلي والشرعي في آن واحد، فهو أن كل شيء بقدر، والزواج إما أن يكون زواجاً شرعياً أو أن يكون زواجاً بدعياً، فإن كان زواجاً شرعياً فهو خير، وإن كان زواجاً بدعياً فهو شرٌ، فهل الخير والشر مقدر على الإنسان؟ الجواب: نعم. كل شيء بقدر، كما جاء في الحديث الصحيح: (كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس) ولكن إذا كان كل شيء بقدر حتى السعادة والشقاوة فلم العمل؟ لقد ذكروا للرسول هذا السؤال حينما أخبرهم بأن كل شيء مستطر، كل شيء مسجل، قالوا له: ففيم العمل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجواب الحكم الفصل الذي لا جواب بعده ولكن لمن فهمه، قال عليه الصلاة والسلام:
(اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) [الليل:5-10] ) إذاً كل ميسر لما خلق له. بالنسبة للسؤال السابق: من كان يريد الخير فيسعى إليه ويتزوج الزواج المشروع، ومن كان يريد الشر يسعى -أيضاً- إليه ويتزوج بزواج غير مشروع، كلٌ ميسر لما خلق له، لذلك لا يقولن أحدكم: إذا كانت السعادة مكتوبة لي فإذاً لماذا أنا أتعب نفسي وأصلي وأصوم وأنا سعيد؟ أو إذا كنت كتبت شقياً -لا سمح الله- لماذا -أيضاً- لا أتمتع بملاذ الحياة كلها ولا أتعب نفسي بصلاة وعبادة وصيام... إلخ؟ الجواب: إن كنت صادقاً مع نفسك فقل كل شيء مثل السعادة والشقاوة، وسابقاً ذكرنا أن الرزق سيأتي، فلماذا تسعى وراء الرزق؟! والرزق -أيضاً- مما سجل كالسعادة والشقاوة، كل شيء مسطر، فلماذا تسعى وراء الرزق؟! لأنك تعلم أنك إن لم تسع لم يأتك، فهنا أنت معتزلي، أي: تؤمن بالأسباب، أما هناك فأنت جبري فيما يتعلق بالسعادة؛ لأنك لا تعمل؛ لأنه إن كان مكتوباً سعيد فأنت سعيد، وإن كان مكتوباً شقي فأنت شقي، وإن كان مكتوباً فقير فأنت فقير، فلماذا تسعى؟ لا بد من السعي، قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) [الإسراء:18-19] لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر، والله عز وجل بحكمته قدر أن يعطي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت:69] .
دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
_______________



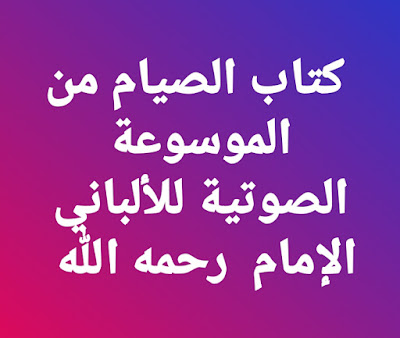

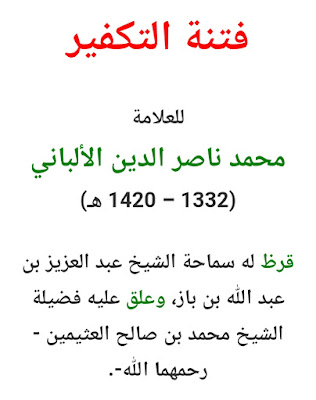

تعليقات
إرسال تعليق