الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة، وفضل يوم عرفة
9 - (الترغيب في الوقوف بعرفة والمزدلفة، وفضل يوم عرفة).
1151 - (1) [صحيح لغيره] وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس ابن مالك قال:
وقفَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بـ (عرفات) وقد كادت الشمسُ أن تؤوبَ، فقال:
"يا بلال! أَنصِتْ لي الناسَ".
فقام بلال، فقال: أَنْصِتوا لرسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأنصتَ الناسُ، فقال:
"معاشرَ الناسِ! أَتاني جبرائيل آنفاً، فأقرأني من رَبي السلامَ، وقال: إنَّ الله عز وجل غفرَ لأهلِ عرفاتٍ، وأَهل المَشْعَر، وضَمِنَ عنهم التبعاتِ".
فقام عمر بنُ الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال:
"هذا لكم، ولمن أتى من بعدِكم إلى يوم القيامة".
فقال عمر بن الخطاب: كثرَ خيرٌ الله وطابَ. (1)
1152 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إنَّ الله يباهي بأهلِ عرفاتٍ أهلَ السماءِ، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاؤني شُعثاً غبراً".
رواه أحمد، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما".
1153 - (3) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما؛ أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول:
"إن الله عز وجل يباهي ملائكتَه عَشِيَّة عرفةَ بأَهلِ عرفةَ، فيقول: انظُروا إلى عبادي شُعثاً غُبراً".
رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الصغير"، وإسناد أحمد لا بأس به.
1154 - (4) [صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما من يومٍ أكثرُ من أن يُعتِقَ الله فيه عبيداً (2) من النار مِن يوم عرفة، وإنه ليدنو (3)، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
[صحيح لغيره] وزاد رزين في "جامعه" فيه:
"اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم" (4).
1155 - (5) [حسن] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
جاء رجل من الأنصار إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسولَ الله! كلماتٌ أَسأَلُ عنهن. فقال:
"اجلس".
وجاءَ رجلٌ من ثقيف، فقال: يا رسولَ الله! كلماتٌ أسألُ عنهن. فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"سبقَكَ الأنصاري".
فقال الأنصاري: إنه رجلٌ غريبٌ، وإن للغريبِ حقاً، فابدأْ به. فأَقبل على الثقفي فقال:
"إن شئتَ أنبأْتُكَ عما كنتَ تسألني عنه، وإن شئتَ تسأَلُني وأُخبرُك؟ "
فقالَ: يا رسولَ الله! بل أجبْني عما كنتُ أَسأَلُك. قال:
"جئتَ تسألُني عن الركوعِ والسجودِ والصلاةِ والصومِ".
[صحيح] فقال: والذي بعثَك بالحقِّ ما أخطأتَ مما كان في نفسي شيئاً. قال:
"فإذا ركعت فَضعْ راحتَيْكَ على رُكبَتَيْكَ، ثم فرِّجْ أصابَعك. ثم اسكن حتى يأخذَ كلُّ عضوٍ مأْخذَه، وإذا سجدْتَ فمكِّنْ جبهتَك، ولا تنقر نقراً، وصلِّ أولَ النهارِ وآخرَه".
فقال: يا نبي الله! فإنْ أَنا صلَّيت بينهما؟ قال:
"فأَنت إذاً مصلٍّ. وصُمْ من كلِّ شهرٍ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وحْمسَ عشرةَ".
فقام الثقفي. ثم أقبل على الأنصاري، فقال:
"إن شئتَ أخبرتُك عما جئتَ تسألني، وإن شئت تسأَلُني وأُخبرُك؟ ".
فقال: لا يا نبي الله! أَخبرني بما جئتُ أسألكَ. قال:
"جِئتَ تسأَلني عن الحاجِّ ما لَه حين يخرج من بيته؟ وما لَه حين يقومُ بعرفاتٍ؟ وما له حين يرمي الجمار؟ وما له حين يحلقُ رأْسَه؟ وما له حين يقضي آخر طوافٍ بالبيت؟ ".
"سبقَكَ الأنصاري".
فقال الأنصاري: إنه رجلٌ غريبٌ، وإن للغريبِ حقاً، فابدأْ به. فأَقبل على الثقفي فقال:
"إن شئتَ أنبأْتُكَ عما كنتَ تسألني عنه، وإن شئتَ تسأَلُني وأُخبرُك؟ "
فقالَ: يا رسولَ الله! بل أجبْني عما كنتُ أَسأَلُك. قال:
"جئتَ تسألُني عن الركوعِ والسجودِ والصلاةِ والصومِ".
[صحيح] فقال: والذي بعثَك بالحقِّ ما أخطأتَ مما كان في نفسي شيئاً. قال:
"فإذا ركعت فَضعْ راحتَيْكَ على رُكبَتَيْكَ، ثم فرِّجْ أصابَعك. ثم اسكن حتى يأخذَ كلُّ عضوٍ مأْخذَه، وإذا سجدْتَ فمكِّنْ جبهتَك، ولا تنقر نقراً، وصلِّ أولَ النهارِ وآخرَه".
فقال: يا نبي الله! فإنْ أَنا صلَّيت بينهما؟ قال:
"فأَنت إذاً مصلٍّ. وصُمْ من كلِّ شهرٍ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وحْمسَ عشرةَ".
فقام الثقفي. ثم أقبل على الأنصاري، فقال:
"إن شئتَ أخبرتُك عما جئتَ تسألني، وإن شئت تسأَلُني وأُخبرُك؟ ".
فقال: لا يا نبي الله! أَخبرني بما جئتُ أسألكَ. قال:
"جِئتَ تسأَلني عن الحاجِّ ما لَه حين يخرج من بيته؟ وما لَه حين يقومُ بعرفاتٍ؟ وما له حين يرمي الجمار؟ وما له حين يحلقُ رأْسَه؟ وما له حين يقضي آخر طوافٍ بالبيت؟ ".
فقال: يا نبيَّ الله! والذي بعثك بالحق ما أَخطأتَ مما كان في نفسي شيئاً. قال:
"فإنّ له حين يخرجُ من بيتِه أَنَّ راحلَتَه لا تخطو خطوةً؛ إلا كتبَ الله له بها حسنةً، أَو حطَّ عنه بها خطيئةً، فإذا وقفَ بـ (عرفةَ) فإنّ الله عز وجل يَنزلُ إلى سماءِ الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شُعثاً غُبراً، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كانت عدد قَطرِ السماء ورملِ عالج، وإذا رمى الجمارَ لا يدري أحدٌ ما لَه حتى يُوفاه يوم القيامة، [وإذا حلق رأسه، فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة] (5)، وإذا قضى آخر طوافٍ (6) بالبيت؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
رواه البزار والطبراني، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ له (7).
__________(1) إنما أوردته هنا لجزم المؤلف رحمه الله بنسبته إلى ابن المبارك، وهو إمام من أئمة الحديث، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "فإن ثبت سنده إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح". نقله السيوطي في "اللآلئ" (2/ 69).
قلت: وظني أنه لو لم يثبت سنده إلى ابن المبارك، ما جزم المؤلف بنسبته إليه كما هو ظاهر.
ومع ذلك فله شواهد خرجتها في "الصحيحة" (1624)، والله تعالى أعلم. وأما المعلقون الثلاثة فقالوا كعادتهم في الارتجال والادعاء: "حسن"!
(2) كذا وقع في الكتاب. والصواب "عبداً" بالإفراد كما عند مخرجيه جميعاً، وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 373 - مجموع الفتاوى)، والناجي في "العجالة".
(3) الأصل والمخطوطة: "ليدنو يتجلى"، والصواب ما أثبتناه، وزيادة "يتجلى" زيادة منكرة لا أصل لها في شيء من روايات الحديث كما حققته في "الصحيحة" (2551). ومن الظاهر أن مقصود من أدرجها في الحديث تفسيره بها، وهذا خلاف ما عليه السلف أن الدنو صفة حقيقية لله تعالى كالنزول، فهو ينزل كما يشاء، ويدنو من خلقه كما يشاء، لا يشبه نزوله ودنوه نزول المخلوقات ودنوهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "شرح حديث النزول" وغيره. وخفي هذا التصويب والذي قبله على المحققين الثلاثة للكتاب -زعموا- فطبعوا الحديث بالزيادتين المنكرتين! فهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة من تحقيقهم!
(4) قلت: لكن يشهد لها حديث ابن عمر الآتي قريباً بعد حديث.
(5) زيادة من "الإحسان"، والبزار.
(6) الأصل: "الطواف"، والتصحيح من "الموارد"، ومما قبله بأسطر.
(7) قلت: أخرجه البزار (1082) وابن حبان (963 - موارد) من طريق طلحة بن مصرف، والطبراني (12/ 425) من طريق ابن مجاهد، كلاهما عن مجاهد عن ابن عمر، وللفرق بين الطريقين قال الهيثمي: "رجال البزار موثقون"، فتعقبه الجهلة الثلاثة بقولهم: "قلنا (!): بل فيهم عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف". فهل عميت أبصارهم عن الطريق الأولى النظيفة من هذا الضعف -وهم قد عزوها إلى مخرجيها بالأرقام كعادتهم- أم تعاموا! وقد حسنها البيهقي في "الدلائل" (6/ 294)، وصرح المؤلف بصحتها في أول الباب الآتي. وانظر التعليق المتقدم في أول هذا الكتاب: (الحج).
(3) الأصل والمخطوطة: "ليدنو يتجلى"، والصواب ما أثبتناه، وزيادة "يتجلى" زيادة منكرة لا أصل لها في شيء من روايات الحديث كما حققته في "الصحيحة" (2551). ومن الظاهر أن مقصود من أدرجها في الحديث تفسيره بها، وهذا خلاف ما عليه السلف أن الدنو صفة حقيقية لله تعالى كالنزول، فهو ينزل كما يشاء، ويدنو من خلقه كما يشاء، لا يشبه نزوله ودنوه نزول المخلوقات ودنوهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "شرح حديث النزول" وغيره. وخفي هذا التصويب والذي قبله على المحققين الثلاثة للكتاب -زعموا- فطبعوا الحديث بالزيادتين المنكرتين! فهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة من تحقيقهم!
(4) قلت: لكن يشهد لها حديث ابن عمر الآتي قريباً بعد حديث.
(5) زيادة من "الإحسان"، والبزار.
(6) الأصل: "الطواف"، والتصحيح من "الموارد"، ومما قبله بأسطر.
(7) قلت: أخرجه البزار (1082) وابن حبان (963 - موارد) من طريق طلحة بن مصرف، والطبراني (12/ 425) من طريق ابن مجاهد، كلاهما عن مجاهد عن ابن عمر، وللفرق بين الطريقين قال الهيثمي: "رجال البزار موثقون"، فتعقبه الجهلة الثلاثة بقولهم: "قلنا (!): بل فيهم عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف". فهل عميت أبصارهم عن الطريق الأولى النظيفة من هذا الضعف -وهم قد عزوها إلى مخرجيها بالأرقام كعادتهم- أم تعاموا! وقد حسنها البيهقي في "الدلائل" (6/ 294)، وصرح المؤلف بصحتها في أول الباب الآتي. وانظر التعليق المتقدم في أول هذا الكتاب: (الحج).
صَحِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع
لِصَاحِبَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشِد الريَاض
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع
لِصَاحِبَهَا سَعد بن عَبْد الرحمن الراشِد الريَاض
المكتبة الشاملة



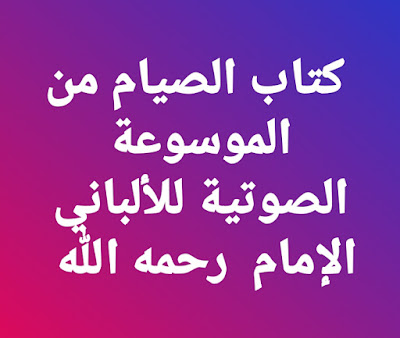

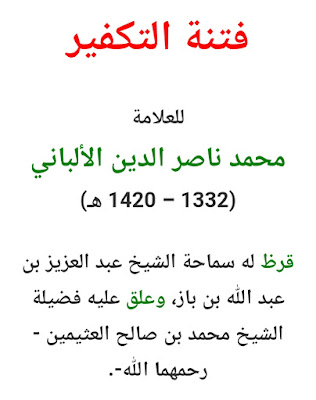

تعليقات
إرسال تعليق