الفصلُ الخامسُ: آدابُ الطالبِ في حياتِه العِلْمِيَّةِ
الفصلُ الخامسُ: آدابُ الطالبِ في حياتِه العِلْمِيَّةِ
24- كِبَرُ الْهِمَّةِ في العِلْمِ: من سجايا الإسلامِ التَّحَلِّي بكِبَرِ الْهِمَّةِ؛ مرْكَزِ السالِبِ والموجِبِ في شَخْصِك، الرقيبِ على جوارِحِك، كِبَرُ الْهِمَّةِ يَجْلُبُ لك بإذْنِ اللهِ خَيْرًا غيرَ مَجذوذٍ، لتَرْقَى إلى دَرجاتِ الكَمالِ، فيُجْرِي في عُروقِك دَمَ الشَّهَامةِ، والرَّكْضَ في مَيدانِ العِلْمِ والعَمَلِ، فلا يَراكَ الناسُ وَاقِفًا إلا على أبوابِ الفضائلِ ولا باسطًا يَدَيْكَ إلا لِمُهِمَّاتِ الأمورِ .
وهذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب بل يكون له همة، ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، ويشعر أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها، وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع، هذه مرتبة ثانية، وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضاً عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلم به العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك .
فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليها .
والتَّحَلِّي بها يَسْلُبُ منك سَفاسِفَ الآمالِ والأعمالِ، ويَجْتَثُّ منك شَجرةَ الذُّلِّ والهوانِ والتمَلُّقِ والْمُداهَنَةِ، فَكَبِيرُ الْهِمَّةِ ثابتُ الْجَأْشِ، لا تُرْهِبُهُ المواقِفُ، وفاقِدُها جَبانٌ رِعديدٌ، تُغْلِقُ فَمَه الفَهَاهَةُ.
هذا صحيح. التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال.
الآمال: هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهه الآمال، بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج.
وأما من تلهيه الآمال ويقول: إن شاء الله أقرأ هذا, أراجع هذا, الآن أستريح وبعد ذلك أراجع. أو تلهيه الآمال بما يحدث للإنسان أحياناً، يتصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل تلهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع وهذا يقع كثيراً, فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس هذا الكتاب، فإياك والآمال المخيبة، اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا أحاديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء. مثل عتبان بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى فواعده النبي عليه الصلاة والسلام فأعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما وأخبر الجيران بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وصل البيت أخبره عتبان بما صنعه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم، لأنه جاء لغرض فلا تشتغل عن الغرض الذي تريده بأشياء لا تريدها من الأصل لأن هذا يضيع عليك الوقت وهو من علو الهمة.
ولا تَغْلَطْ فتَخْلِطْ بينَ كِبَرِ الْهِمَّةِ والكِبْرِ؛ فإنَّ بينَهما من الفَرْقِ كما بينَ السماءِ ذاتِ الرَّجْعِ والأرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ. كِبَرُ الْهِمَّةِ حِلْيَةُ وَرَثَةِ الأنبياءِ ، والكِبْرُ داءُ الْمَرْضَى بعِلَّةِ الْجَبابِرَةِ البُؤَسَاءِ .
كبر الهمة: إن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يصرفه ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف.
وأما كبر النفس: فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ولا يهتم وربما يصعر وجهه وهو يخاطبهم فكما قال الشيخ بكر: بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
فيا طالبَ العلْمِ ! ارْسُمْ لنفسِكَ كِبَرَ الْهِمَّةِ، ولا تَنْفَلِتْ منه، وقد أَوْمَأَ الشرْعُ إليها في فِقْهِيَّاتٍ تُلابِسُ حياتَك؛ لتكونَ دائمًا على يَقَظَةٍ من اغتنامِها، ومنها إباحةُ التيَمُّمِ للمُكَلَّفِ عندَ فَقْدِ الماءِ وعدَمُ إلزامِه بقَبولِ هِبَةِ ثَمَنِ الماءِ للوُضوءِ؛ لما في ذلك من الْمِنَّةِ التي تَنالُ من الْهِمَّةِ مَنَالًا وعلى هذا فقِسْ، واللهُ أَعْلَمُ .
يعني من علو الهمة أن لا تكون متشوفاً لما في أيدي الناس، لأنك إذا تشوفت ومَنَّ الناسُ عليك ملكوك؛ لأن المنة ملك للرقبة في الواقع. لو أعطاك الإنسان قرشاً لوجد أن يده أعلى من يدك كما جاء في الحديث: ( اليد العليا خير من اليد السفلى) واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، لا تبسط يدك للناس ولا تمد كفك إليهم.
إذا كان الإنسان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله بل يعدل إلى التيمم خوفاً من المنة مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه , ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه:
فقالوا: من يبيعه اشتر منه وجوباً لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض. ومن أهدى عليك لا يلزمك قبوله، من أجل أن منته تقطع رقبتك، ولكن إذا كان الذي أهدى الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو من جرت العادة بأنه لا منة بينهم مثل الأب مع ابنه، والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك. فهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم.
والمهم أن من علو الهمة وكبرها ألا يكون الإنسان مستشرفاً لما في أيدي الناس.
بعض الناس يكون عنده أسلوب في السؤال، أي في سؤال المال، إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه، ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته؟ هل يوجد في السوق؟ لأجل ماذا ؟ حتى يعطيه إياه لأن الكريم سوف يخجل ويقول: إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن أقول: (تعمل عليه) فخذه. هو إذا قال (تعمل عليه) ماذا يقول؟ لا يا أخي فالمهم أن بعض الناس يستشرف أو يسأل بطريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره أيضاً.
25- النَّهْمَةُ في الطَّلَبِ: إذا عَلِمْتَ الكلمةَ المنسوبةَ إلى الخليفةِ الراشدِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضِي الله
اللهُ عَنْهُ: (قيمةُ كلِّ امرئٍ ما يُحْسِنُه) وقد قِيلَ: ليس كلمةٌ أحَضَّ على طَلَبِ العلْمِ منها؛ فاحْذَرْ غَلَطَ القائلِ: ما تَرَكَ الأَوَّلُ للآخِرِ. وصوابُه : كم تَرَكَ الأَوَّلُ للآخِرِ .
إن كل إنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة، أحسن مما يحسن فتل الحبال مثلا. لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق بين هذا وهذا، فقيمة كل امرئ ما يحسنه. «وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها» وهذا القيل ليس بصحيح. أشد كلمة في الحض على طلب العلم قول الله تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: 90). وقوله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) (المجادلة: 11). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». وقوله صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء ». وأشباه ذلك مما جاء في الحث على طلب العلم، لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي كلمة لا شك أنها جامعة، لكن لا شك أنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم.
وقوله: «ما ترك الأول للآخر» إما تكون «ما» نافية أو استفهامية، فإن كانت «نافية» فالمعنى: ما ترك الأول للآخر شيئا. وإن كانت «استفهامية» فيكون المعنى: أي شيء ترك الأول للآخر؟
وكلا المعنيين يوجب أن يتثبط الإنسان عن العلم، ويقول كل العلم أخذ من قبلي فلا فائدة، فيكون بذلك تثبيط لهمته، لأنه إذا قيل لك: أن من قبلك أخذوا كل شيء. ستقول إذا ما الفائدة.
أما إذا قيل: كم ترك الأول للآخر، فالمعنى: ما أكثر ما ترك الأول للآخر، وهذا يحملك على أن تبحث على كل ما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قال الأولون.
ولا شك أن المعنى الصواب: كم ترك الأول للآخر. فإن قيل: إن الشاعر الجاهلي يقول:
ما أرانا نقول إلا معارا ** أو معادا من قولنا مكرور
فهل هذا صواب؟ الجواب: لا هذا ليس بصواب، وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا. أما إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات، وهذا صحيح لو أراد المعاني.
ولعل الشاعر الجاهلي أراد أنه كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار أخذه من غيره، وإما معاد.
لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشره الإنسان في بيت شعر.
فعليك بالاستكثارِ من مِيراثِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابْذُل الوُسْعَ في الطلَبِ والتحصيلِ والتدقيقِ، ومَهْمَا بَلَغْتَ في العِلْمِ؛ فتَذَكَّرْ ( كم تَرَكَ الأوَّلُ للآخِرِ ) .
قوله: «فعليك بالاستكثار..» يحثك على أن تستكثر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك العلم لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ثم اعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية.
فإن كان بالقرآن الكريم، فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى النظر بالسند لأنه متواتر أعظم التواتر.
أما إذا كان بالسنة النبوية فلا بد أن تنظر في السنة النبوية، أولا هل صحت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم تصح؟ فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى؟ وإلا: فقلد.
إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع
قوله: «ابذل الوسع» يعني الطاقة في التدقيق، أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعمومها دون أن يدقق. هل هذا الظاهر مراد أم غير مراد؟ وهل هذا العام مخصص أم غير مخصص؟ أم هذا العام مقيد أم غير مقيد؟ فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث، أو في الحكم على الحديث. هذا خطر عظيم.
يقول: «مهما بلغت في العلم فتذكر: كم ترك الأول للآخر» هذا طيب، ولكن نقول: إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم، فتذكر قول الله عز وجل: (وفوق كل ذي علم عليم) (يوسف: 76). وقوله (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) (الإسراء: 85).
وفي تَرجمةِ أحمدَ بنِ عبد الجليلِ من ( تاريخِ بَغدادَ ) للخطيبِ ذِكْرٌ من قصيدةٍ له:
لا يَكونُ السَّـرِيُّ مِثْـلَ الدَّنِـيِّ لا ولا ذو الذكـاءِ مثـلَ الغَبِـيِّ
قيمةُ المرءِ كُلَّمَا أَحْسَنَ الْمَرْءُ قضـاءً مـن الإمـامِ عَـلِـيِّ
هذا سبق الكلام عليه.
و«السري» يعني: الشريف عالي الهمة، مثل الوفي ونفي المماثلة ظاهر أيضا، لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي ولا ذو العلم مثل الجاهل.
26- الرِّحْلَةُ للطَّلَبِ: (من لم يكنْ رُحْلَةً لن يكونَ رُحَلَةً ) فمَن لم يَرْحَلْ في طَلَبِ العلْمِ للبحْثِ عن الشيوخِ، والسياحةِ في الأَخْذِ عنهم؛ فيَبْعُدُ تأَهُّلُه ليُرْحَلَ إليه؛ لأنَّ هؤلاءِ العلماءَ الذين مَضَى وقتٌ في تَعَلُّمِهم وتَعليمِهم، والتَّلَقِّي عنهم: لديهم من التَّحريراتِ والضبْطِ والنِّكاتِ العِلْمِيَّةِ، والتجارُبِ ما يَعِزُّ الوُقوفُ عليه أو على نظائرِه في بُطونِ الأسفارِ .
قوله : «من لم يكن رحلة لن يكون رحلة» لعل: "من لم يكن له" يرجع إلى الأصل.
قوله : «التجارب» مكسور حرف الراء. والتجربة غلط ما هي لغة عربية، رغم أنها في الشائع بين الناس الآن، حتى طلبة العلم، يقول: تجارب، تجربة. رغم أن الصواب كسر الراء. والمعنى: أن من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه وتأتي الناس إليه.
واحذر العقود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين، الذين يفضلون «علم الخرق» على «علم الورق». وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟!
وقال آخر: إذا خاطَبُونِي بعِلْمِ الوَرَقِ برَزْتُ عليهم بعِلْمِ الْخِرَقِ
فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا، ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام.
الصوفية يدعون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم، وأنه يزورهم ويزورونه وهذا من خرافاتهم.
والعبارة الأخيرة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين قال في هؤلاء: «لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا» يعني أنهم ما نصروا الإسلام الذي جاء لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معان أو جددوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقالوا لهم: أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات، مع ظهورها ووضوحها، فاسمحوا لنا أن نأول آيات المعاد، أي آيات اليوم الآخر فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به، فإذا أبحتم لأنفسكم أن تأولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فاسمحوا لنا أن نأول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا ولا شك أن هذه حجة قوية لهؤلاء الفلاسفة على هؤلاء المتكلمين، إذ لا فرق.
المهم أن الشيخ وفقه الله هاجم الصوفية، فهم جديرون بالمهاجمة، لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد بالله، حتى يعتقد أنه هو الرب كما يقول بعضهم «ما في الجبة إلا الله» يعني نفسه. ويقول:
الرب عبد والعبد رب = يا ليت شعري من المكلف
يعني هما شيء واحد. إلى أمثال ذلك من الخرافات التي يقولونها، لكن ينبغي أيضا أن نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله من كماله بكلامهم أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة. ومنهم من أثبت الأسماء، لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى، وغالى بعضهم وقال: إنها أسماء واحدة، وأن السميع هو البصير، وأن السميع والبصير هما العزيز وهما شيء واحد. وغالى بعضهم فقال: هي أسماء متعددة، لكن لا تدل على معنى، مسلوبة المعنى. لأنهم لو أثبتوا لها معنى- بزعمهم- لزم تعدد الصفات، وبتعددها وبتعدد الصفات يرون أنه شرك، لأنهم يقولون يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهو أشد شركا من النصارى.
فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم على أهل الكلام الذين عطلوا لله مما يجب له من صفات كمال بعقول واهية.
والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر، الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة، لكن الرحلة أكبر لأن الرحلة إلى العالم، يكتسب الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه، ثم يترك الرجل يتكلم ليس كما يعمله إياه في الشريط.
مثلا: الخطبة، أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد... تتأثر به لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريط لن تتأثر به تأثرك وأنت تشاهد الخطيب.
27- حفظ العلم كتابة: ابذل الجهد في حفظ العلم (حفظ كتاب)، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع، وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها، ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي.
«ابذل» همزة وصل، لكن عند الابتداء بها تكون همزة قطع. بذل الجهد في الكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب.
كم من مسألة نادرة مهمة لا يقيدها اعتمادا على أنه يقول: إن شاء الله لا أنساها. فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها، ولكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره، كتابة تطمس الأصل فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، لكن يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يلتبس هذا بهذا، فإن لم يتيسر هذا، كأن ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا ضير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت، وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب كلما ذكر الإنسان منهم مسألة قيدها، إما فائدة علم في خاطر، أو مسألة يسأل عنها الشيخ فيقيدها، فاستفادوا بذلك كثيرا.
ولذا؛ فاجْعَلْ لك ( كُناشًا ) أو ( مُذَكِّرَةً ) لتقييدِ الفوائدِ والفرائدِ والأبحاثِ الْمَنثورةِ في غيرِ مَظَانِّها ، وإن اسْتَعْمَلْتَ غُلافَ الكتابِ لتَقييدِ ما فيه من ذلك ؛ فحَسَنٌ ، ثم تَنْقُلُ ما يَجْتَمِعُ لك بعدُ في مُذَكِّرَةٍ ؛ مُرَتِّبًا له على الموضوعاتِ مُقَيِّدًا رأسَ المسألةِ ، واسمَ الكتابِ ، ورقْمَ الصفحةِ والمجلَّدِ ، ثم اكْتُبْ على ما قَيَّدْتَه : ( نُقِلَ ) ؛ حتى لا يَخْتَلِطَ بما لم يُنْقَلْ كما تَكتُبُ : ( بلَغَ صفحةَ كذا ) فيما وَصَلْتَ إليه من قراءةِ الكتابِ حتى لا يَفُوتَك ما لم تَبْلُغْه قراءةً .
وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها :«بدائع الفوائد»، لابن القيم، و«خبايا الزوايا» للزركشي، ومنها: كتاب «الإغفال»، و«بقايا الخفايا»، وغيرها.
ومنها أيضا «صيد الخاطر» لابن الجوزي، لكن أحسن ما رأيت «بدائع الفوائد» لابن القيم أربعة أجزاء في مجلدين، فيها من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب أخر لكل فن. كل ما طرأ على باله قيده، لذلك تجد فيه من العقائد في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء.
أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحة تحليلا وتفريعا واشتقاقا وغير ذلك. بحث بحثا بالغا في الفرق بين «المدح والحمد»، كتب كتابة فائقة في ذلك، وقال: كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب لكنه كما قيل:
تألق البرق نجديـا فقلـت لـه إليك عني فإني عنك مشغول
يعني رحمه الله مشغول بما هو أهم من التحقق في اللغة العربية وإلا فهو- شيخ الإسلام – رحمه الله آية في اللغة العربية، لما قدم مصر اجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب «البحر المحيط» في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عطرا، ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول فيه:
قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر
يعني أبي بكر يوم الردة. فلما قدم مصر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل- أبي حيان- وتناظر معه في مسألة نحوية واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال إن سيبويه في كتابه قال كذا وكذا. فكيف تخالفه؟.
فقال له شيخ الإسلام: «وهل سيبويه نبي النحو؟!» يعني: حتى يجب علينا اتباعه، ثم قال: «لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو». سبحان الله !! هكذا يقول لسيد النحاة.
يقال: إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار بنفسه فأنشأ قصيدة يهجوه فيها.
عفا الله عنا وعنهم جميعا. المهم أن كتاب «بدائع الفوائد» من أجمل الكتب، فيه فوائد لا تجدها في غيره.
وعليه، فقيد العلم بالكتاب، لاسيما بدائع الفوائد في غير مظانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشي فواتها...... وهكذا، فإن الحفظ يضعف، والنسيان يعرض.
قوله:«لاسيما بدائع» الأفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لاسيما، يجوز النصب ولكن الأحسن الرفع.
ومعني الكلام: أنه يحث على كتابة هذه الأشياء، بدائع الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساها وكذلك أيضا ولاسيما إذا كانت في غير مظانها لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر، فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها، وكذلك أيضا «خبايا الزوايا في غير مساقها» وهي بمعني الجملة الأولي. و«درر منثورة تراها وتسمعها تخشي فواتها». وهذه أيضا مسائل تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منثورة، فهذه يجب أن تجمعها وتجعلها في كتاب.
قال الشعبي: «إذا سمعت شيئا، فاكتبه، ولو في الحائط». رواه خيثمة.
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع، فرتبه في (تذكرة) أو (كناش) على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف وباء؟ نرى أنه على ألف باء أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء، تجد مثلا: ترتيب الحنابلة يفترق عن الشافعية لاسيما في المعاملات، بل إن نفس المذهب الواحد يختلف ترتيبه. ترتيب المتقدمين منهم والمتأخرين. فإذا رتبناها على ألف باء سهل واتفقت الموضوعات على هذا الرتيب.
تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابة ومن العلماء من عكس فقال ينبغي حفظ العلم حفظا في الصدور لا في السطور وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة يعني أنه محى حافظته وأهملها، لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ .
وهذا له وجهة نظر ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة الآن والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس .
الآن مثلا يوجد جدولا للفرائض، في جهاز الكومبيوتر فيأتي أي إنسان يعرف كيف يفتح الكومبيوتر ويخرج الأحكام في المواريث وهو لا يعرف وهذا ضرر عظيم على الذاكرة وعلى الحفظ ، ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند الحاجة كمسألة فرضية وردت على الإنسان تطلب العجلة وحسابها طويل عريض، فهنا لا بأس أن يستعملها أما إذا يمكنك أن تستعمل الشيء حسب ذاكرتك وفهمك فابتعد عن الكتابة، والاعتماد على الحفظ أولى، لذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حمل الحديث حفظا لا كتابة وان كان من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص لكن أبو هريرة لا يكتب ومع ذلك عندهم من علم الحديث أو روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه.
فالمسألة هنا أننا لا نقول بفضل الكتابة مطلقا ولا بفضل الحفظ في الصدر مطلقا فنقول إذا تساويا فالحفظ في الصدر أحسن، وإن دعت الحاجة لهذا أو هذا فالمستعمل.
والآن التلقي يكون التلقي عن طريق المسجلات فلو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا، لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات .
وأنه مما يعتري الكتابة أنه ربما لا يكون الكتاب معك، فتبقى كأنك عامي وإذا تمكن لك في الصدر ربما لا يكون صدرك معك .
28- حفظ الرعاية: ابذل الوسع في حفظ العلم (حفظ رعاية) بالعمل والاتباع، قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه. وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه.
جاء الوعيد لمن طلب علما وهو يبتغي به وجه الله لغير الله لم يجد عرف الجنة، أي ريحها، وما ذكره الخطيب البغدادي- رحمه الله- حق أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص، ولا يكون قصده نيل الأعراض كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أحد الأعواض كالمرتبات لا يريد هذا.
فإذا قال قائل: كل الذين يطلبون العلم في الكليات إنما يقصدون الشهادة ولذلك نرى بعضهم يريد الوصول إلى هذه الشهادات ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك. فيقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية وذلك أن يريد الوصول إلى منفعة الخلق لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل الشهادة.
فإذا قال: أنا أريد أن أنال الشهادة لأتمكن من التدريس في الكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة ما درست. أريد الشهادة لأن أكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان فيه داعيا إلى الله إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله هذا في العلم الشرعي. أما في العلم الدنيوي فانو فيه ما شئت مما أحله الله. لو تعلم الإنسان الهندسة وقال أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب 10 آلاف ريال. فهل هذا حرام؟ لا.. لماذا؟ لأن هذا علم دنيوي، كالتاجر يتاجر من أجل أن يحصل على ربح.
وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، واتخاذ الأتباع، وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
وقد جاء الوعيد فيمن طلب ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء. فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك. هذه نيات سيئة، وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت نية صالحة، صرت إماما، صرت رئيسا يشير الناس إليك وأخذوا بقولك.
وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمة بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه.
ومعنى «رعاية» أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :«رب مبلغ أوعى من سامع» .
والمقصود بالأحاديث أو القرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم راو فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيء واضح بين لا يحتاج الناس إلى مناقشته فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا، ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص إلا أنه ضعيف الحفظ، ومن الناس من يعطيه الله الأمرين: قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أتاه الله تعالى من العلم والحكمة مطر أصاب أرضا فصارت الأرض ثلاثة أقسام:
قسم: قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلأ، فهذا مثل من أتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع به غيره.
والقسم الثاني: أرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلأ. هؤلاء من الرواة، امسكوا الماء فسقوا الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم أنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء.
والأرض الثالثة: أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم. وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه، فنفعوا الناس وانتفعوا به.
وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول :(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (سورة الأحزاب: 21). اهـ.
«ينبغي» أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشائع في استعمالها أنها للندب. وهذا في الأمور التعبدية ظاهر، أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد هل يشرع أن يتبعها الإنسان أم لا ؟
كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتبع ذلك، حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فنزل ويبول. وإن لم يكن محتاجا للبول. كل هذا من شدة تحريه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قد خالف أكثر الصحابة فيه ورأوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع اتباعه للإنسان. ولهذا لو قال قائل: أيسن لنا الآن ألا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع؟ الصحيح أنه لا يشرع لأنه وقع اتفاقا لا قصدا.
ما وقع عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ مثلا: العمامة والرداء والإزار. نقول: نعم يشرع أن نتبعه فيه.
لكن ما معنى الاتباع. هل معناه اتباعه في عين ما لبس؟ أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الجواب: الثاني. لأنه لبس ما اعتاده الناس في ذلك الوقت. وعلى ذلك نقول: السنة لبس ما يعتاده الناس، ما لم يكن محرما، فإن كان محرما وجب اجتنابه.
ما وقع على سبيل التشهي فهل نتبعه فيه. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، يحب العسل، يتتبع الدباء في الأكل. هل نتبعه في ذلك. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء- يعني القرع- في الطعام، فمازلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها.
وعلى هذا فهل نقول من المشروع أنك تتبع الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أم لا؟ الظاهر أن هذا الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه- وهو ما وقع اتفاقا- لأن هذا لم يقع اتفاقا، حيث أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يتتبعها أنه يتتبعها قصدا لا اتفاقا، ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يوجب له محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره وحينئذ نقول: إذا تتبعت هذا فإنك على الخير، وقد يكون في الدباء منفعة طبية، تسهل وتلين وتكون قدما للطعام.
قوله «باستعمال آثار» هذه العبارة فيها شيء من الركاكة، ولو قال «باتباع آثار» كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا». وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن . (فاتبعوني يحببكم الله) (سورة آل عمران: 31). أما استعمال الآثار فقد يتوهم واحد أن استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك. لكن إذا قلنا اتباع آثار كان ذلك أحسن وأوضح.
وقوله: «توظيف السنن على نفسه» يراد بذلك أن يطبق توظيفها، بمعنى تطبيق السنن على نفسه لأن الله يقول: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة) (سورة الأحزاب: 21). ولو ذكر آخر الآية لكان أحسن ما هي (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (سورة الأحزاب: 21)
29- تَعَاهُدُ المحفوظاتِ : تَعاهَدْ عِلْمَك من وَقتٍ إلى آخَرَ ؛ فإنَّ عَدَمَ التعاهُدِ عُنوانُ الذهابِ للعِلْمِ مهما كان .
فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب، يعني دليل الذهاب، ولكن لو عبر بقوله : «فإن عدم التعاهد سبب الذهاب للعلم» لكان أولى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها». فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب للنسيان، وليس عنوان الذهاب للعلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء. وسبب الشيء يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد سابق على عدم البقاء، أي بقاء العلم، والخطب في هذا يسير إذا كان المعنى مفهوما، فالأمر يسير بالنسبة للألفاظ .
عن ابنِ عمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ : (( إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ ، إن عاهدَ عليها أَمْسَكَها وإن أَطْلَقَها ذَهَبَتْ )). رواه الشيخانِ، ومالِكٌ في ( الْمُوَطَّأِ ) .
قالَ الحافظُ ابنُ عبدِ البَرِّ رَحِمَه اللهُ: ( وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَن لم يَتَعَاهَدْ عِلْمَه ذَهَبَ عنه، أيْ مَنْ كان؛ لأنَّ عِلْمَهم كان ذلك الوَقْتَ القرآنَ لا غيرَ، وإذا كان القرآنُ الْمُيَسَّرُ للذكْرِ يَذْهَبُ إن لم يُتَعَاهَدْ؛ فما ظَنُّكَ بغيرِه من العلومِ المعهودةِ ؟! وخيرُ العلومِ ما ضُبِطَ أَصْلُه، واسْتُذْكِرَ فَرْعُه، وقادَ إلى اللهِ تعالى ودَلَّ على ما يَرضاهُ ) .
( وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَن لم يَتَعَاهَدْ عِلْمَه ذَهَبَ عنه ) وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسي وكما أن هذا في المعقول فهو أيضا في المحسوس فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء تموت، أو تذبل، وكذلك من لم يتعاهد أغصانها بالشتل، تتكاثر ويفسد بعضها بعضا فلا تستقيم وكذلك العلوم.
(خيرُ العلومِ ما ضُبِطَ أَصْلُه، واسْتُذْكِرَ فَرْعُه) يعني كأنه يرد على القواعد والأصول وأنا أحثكم دائما عليهما عليكم بالقواعد والأصول لأن المسائل الفقهية المتفرعة كتلاقط الجراد من أرض صحراء تضيع عليك لكن الذي عنده علم بالأصول هذا هو العالم من فاتته الأصول فاته الوصول.
وقالَ بعضُهم ( كلُّ عِزٍّ لم يُؤَكَّدْ بعِلْمٍ فإلى ذُلٍّ مَصيرُه ) اهـ .
يعني غالبا، وإلا فقد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى أن يموت ولكن في الغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يزول.
30- التفقه بتخريج الفروع على الأصول: من وراء الفقه: التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله قال: «نضر الله امرؤ سمع مقالتي فحفظها، ووعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
«التفقه» يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم. بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: «كيف لكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم».
الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير.
قال: «نضر الله.. » نضر بمعنى: حسنه، ومنه قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) (سورة القيامة: 22). أي: حسنه، وقوله تعالى: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) (سورة الإنسان: 11). نضرة: يعني حسنا في وجوههم، وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن. لأن الإنسان قد يغتم قلبه، ووجهه قد أعطاه الله نضارة لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نضارة الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمران: السرور في القلب ونضارة في الوجه. وبذلك تتم النعمة.
قال ابن خير- رحمه الله تعالى- في فقه هذا الحديث: «وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه، والبحث على -الصواب عن- معاني الحديث، واستخراج المكنون من سره» أ هـ. وللشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى، في ذلك القدح المعلي، ومن نظر في كتب هذبن الإمامين، سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما.
لا شك أن ما ذكره- وفقه الله- هو الصواب؛ أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. لكن لا ينبغي أن يقتصر على الحديث، بل نقول من الأدلة في القرآن والسنة ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأثبت، لأنه لا يعتريه عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فهي تنقل بالمعنى. وعلى هذا فيقال: «بالبحث عن معاني القرآن والحديث».
ومن أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا- رحمه الله- عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج – أحيانا- من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر، وهذا الطريق- أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة- هو طريق الصحابة، فما كانوا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلمونها، وما فيها من العلم والعمل.
ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم- رحمهم الله- وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهما الله فهما عجيبا في القرآن والسنة.
ونضرب مثلا لهذا- أعني التفقه-، أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (سورة الأحقاف:15)، ومن قوله: (وفصاله في عامين) (سورة لقمان: 14) فإن ثلاثين شهرا، عامان وستة أشهر، فإذا كان حمله وفصاله (ثلاثون شهرا) وفي الآية الأخرى (في عامين) لزم أن يكون الحمل أقله ستة أشهر.
ومن مليح كلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- قوله في مجلس للتفقه: «أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة، تصويرا وتقريرا، وتأصيلا، وتفصيلا، فوقع الكلام في... فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين..».
واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه: (التفكر). فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في (التفكر) في ملكوت السموات والأرض، وإلى أن يمعن النظر في نفسه، وما حوله، فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان، وتعميق الأحكام، والانتصار العلمي: (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) (سورة البقرة: 219)، (قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون) (سورة الأنعام: 50).
وعليه، فإن «التفقه» أبعد مدى من (التفكر)، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) (سورة النساء: 78). لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجوز عن التشهي والهوى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير) (سورة البقرة: 12).
إذا نقول: المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكير، ثم التفقه. لا بد من هذا، فمن لا علم عنده كيف يتفقه؟ وكيف يعلم... من عنده علم وليس عنده فهم، كيف يتفقه؟ حتى لو حاول أن يتفقه وهو مما لا يفهم لا يمكن ذلك. بعد أن تفهم، تتفكر، ما مدلول هذه الآيات وما مدلول هذا الحديث؟ وتتفكر أيضا في أنواع الدلالة، وأنواع الدلالة ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام.
فدلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة مطابقة.
ودلالته على بعض معناه، دلالة تضمن.
ودلالته على لازم خارج، هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم. وبين ذلك تفاوت عظيم.
فلا بد أن يعمل هذه الدلالات، حينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها.
ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل- وأحمد تلميذ الشافعي وكان يثني عليه عند أهله- فقدم له العشاء، فأكله كله ورد الصحفة خالية، فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن الإنسان يأكل قليلا: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذه واحدة ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو أظنه أنه لم يقم يتهجد، ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء، هذه اثنتان.
فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له كيف تقول في الشافعي ما تقول، والرجل أكل الطعام وملأ بطنه، ونام وقام ولم يتوضأ كيف إذا؟ قال: «آتيكم بالخبر..» فسأله. قال: فأما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل فأردت أن أملأ بطني منه، أما كوني لم أتهجد فلأن التفكير في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم واستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يا أبا عمير ما فعل النغير» كذا وكذا ما أدري قال: مائة، أو ألف. أما كوني لم أطلب ماء وأن خارج لصلاة الفجر، فلم أشأ أن أطلب ماء وأنا على وضوء. فذكر ذلك لأهله. فقالوا: الآن !!
فهيا أيها الطالب! تحل بالنظر والتفكر، والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى (فقيه النفس) كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو (فقيه البدن) كما في اصطلاح المحدثين.
هناك فقه ثالث ظهر، وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم.
وقالوا: من لم يكن فقيها للواقع فليس بعالم، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاشتغال بالتعبد الصحيح، عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن انشغال الشباب بفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب إذا امتلأ بشيء امتنع عن الآخر.
فانشغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والدين والإخلاص خيرا له من البحث عن الواقع، وماذا فعل فلان؟ وماذا فعل فلان، وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة أو المقرؤة أو المرئية أو يبنون ما يظنون فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع. أو ينظر إلى أشياء خطط لها أعداؤنا من قبل على واقع معين، تغير الواقع وزال بالكلية فبقيت هذه الخطط لا شيء.
والمهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا الذي يطلب من الإنسان أن يحققه.
وفقه النفس: الذي وصل بالقلب إلى العقيدة السليمة وحب المسلمين وما أشبه ذلك ينبني عليه فقه البدن وقول هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك.
أما فقه الواقع إذا احتاج الإنسان إليه فلا بد أن يعرفه أما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا حقيقة غير واقع فأحيانا يكون غير واقع وكذب ودجلا وتقديرات ليست مبنية على أصل
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة، كقواعد المصالح، ودفع الضرر والمشقة، وجلب التيسير، وسد باب الحيل، وسد الذرائع.
لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول الثلاثة: الأدلة من القرآن، والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة من الكتاب والسنة.
وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالضوابط والقواعد حتى ينزل عليها الجزئيات.
والفرق بين القاعدة والضابط: أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة. والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة.
فالضابط أقل رتبة من القاعدة، كما يدل ذلك اللفظ، الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب واحد. والقاعدة أصل تفرع عنه الجزيئات.
قوله: «فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، وتمام العناية بالقواعد والضوابط» هذا من أهم ما يكون، أن الإنسان يجعل نظره أي فكره يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يحفظ القاعدة كما يحفظ الفاتحة ولكن لا يعرف أن يخرج عليها. وهذا لا شك نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتخريج القواعد على الأصول.
قوله: «وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام...» وهذا أيضا مهم عند أهل الحديث. يأتي مثلا نص ظاهرة. الحكم بكذا لكن إذا تأملت في هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة من الشريعة، فما موقفك؟
نقول: لا بد أن نرجع إلى القواعد، ويحكم على هذا بما تقتضيه الحاجة. وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا- وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته- نقول: إن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا. أعني عدم النظر إلى القواعد والأصول الثابتة. وهذا أمر مهم، وذلك لأن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح الدينية والدنيوية ولدرء المفاسد أو تقليلها، سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية، ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا.
تنزل الأمطار على الأرض، وهذا رجل تم بنيانه قريبا. هل يضره المطر أو لا؟ نعم يضره، لكن لا عبرة. لأن العبرة بالعموم.
وكذلك تنزل وهذا الرجل قد انتهي من السقي، والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء، مطرا كان أو سقي بعد الانتهاء من سقيه أنه يضره، لكن العبرة بالعموم.
فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله ووفقه الله«وأصولها المطردة كقواعد المصالح».
وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس: هو المصالح المرسلة. فقال: الأدلة هي القرآن والسنة والقياس الصحيح والإجماع والمصالح المرسلة.
وهذا غلط لأن هذه المصالح الذين يدعون أنها – مصالح مرسلة – إن كان الشرع قد شهد لها أنها مصالح مرسلة فهي من الشرع داخلة في عموم الشرع: كتاب أو سنة قياس كان أو إجماع، وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة الاعتبار، وحينئذ لا تؤصل أصلا، دليلا ندين الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة. لأن كونك تؤصل أصلا يعني أنك تبني دينك على هذا.
وعلى هذا فتمسح أو فتنسخ ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ لأننا نقول: إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعمومتها وقواعدها، وإن شهد ببطلانها فهي باطلة.
الآن من أهل البدع من ركب بدعته على هذا الدليل. قال: هذا من المصالح المرسلة. فالإنسان يحيي قلبه ويحركه بماذا؟ ببدعة صوفية وما أشبه ذلك وقال: نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأذكار وعلى هذه الصفة ويضرب الأرض حتى تتغبر قدماه. قال: هذه مصلحة عظيمة تحرك القلوب.
ماذا نقول: لو قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذه المصلحة وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة أصله أن كل واحد يرى أن كل ما عليه مصلحة، وربما يماري ليكون قوله المقبول.
المهم أن قول الشيخ بكر «كقواعد المصالح» مراده بذلك المصالح الشرعية، فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان يريد المصالح المرسلة فهو بعيد، لأنه قال بعد ذلك «ودفع الضرر والمشقة»، إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمت فساد ما يجعلها دليلا مستقلا.
وقوله :«ودفع الضرر» أين نجد من القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) (سورة النساء: 29) وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك، ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد، مع أن البرد قد لا يميت الإنسان، ولكن قد يكون سببا لموته، استدل بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وضحك. هذا من القرآن.
وأيضا من القرآن قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (سورة المائدة: 6) الشاهد قوله: (مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) لماذا يتيمم وهو مريض، يقدر أن يستعمل الماء؟ لكن لئلا يزاد مرضه أو يتأخر برأه.
ومن دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما وهو في السفر، ورجلا قد ظلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر» مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم وهو مسافر، وهل يفعل غير البر ؟! لا لكن إذا وصلت الحال من المشقة فإنه ليس من البر، وإذا انتفى أن يكون من البر، فهو إما من الإثم وإما أن يكون من لا لك ولا عليك.
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عطاش وقد شق عليهم الصيام، لكنهم ينظرون متى، فدعا بماء بعد صلاة العصر ووضعه على فخده الشريفة، وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشرب، والناس ينظرون. ثم قيل له إن بعض الناس قد صام. فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة».
هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ لا، ولكن العموم (ولا تقتلوا أنفسكم) (سورة النساء: 29)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (سورة الحج: 78) إذا الشرع يراعي قواعد المصالح ودفع الضرر، دفع المشقة.
قوله: «وجلب التيسير» كل الإسلام تيسير، لكن هل اليسر هو ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ باعتبار العموم. ومع ذلك إذا حصل للإنسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحا: «صل قائما..» إذا هذا تيسير، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحدا إلا غلبه». كل الدين يسر، وكان إذا بعث البعوث يقول: «يسروا لا وتعسروا، بشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».
فالحمد لله. هذا الدين للإنسان دين يسر، وبناء على ذلك هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو أن يفعلها على الوجه الأيسر. أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟
الثاني، ولهذا لو أن رجلا في البرد حانت صلاة الفجر وعنده ماء، أحدهما ساخن والآخر بارد. فقال أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى أنال أجر إسباغ الوضوء على المكاره. وقال الثاني أنا أريد أن أتوضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال: (يريد الله بكم اليسر) (سورة البقرة: 185). أيهما أصوب؟ الثاني بالإجماع بلا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباغ الوضوء على المكاره ليس المراد منه أن يقتصد الإنسان ما يكره. المراد إذا لم يكن الوضوء إلا بمكروه.. يتوضأ هذا معناه. وإلا لكان يقول أحجج البيت على قدميك... سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة خربة، تمشي قليلا وتقف كثيرا لماذا؟ لأنها أشق. فإن لم تستطع فعلى طيارة. ليس هذا بصحيح!! أيهما أفضل الطيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرجت الطيارات كنا نحدث ونحن صغار أن الحج على الطيارة ثمن الحج. وعلى السيارة نصف الحج.
والشاهد على كل حال: جلب التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نرى أنه إذا اختلف عالمان في رأي، ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل، ولا من حيث الاستدلال، ولا من حيث المستدل. وأحدهما أشد من الثاني، فمن نتبع الأيسر أم الأشد؟ الأيسر. وقيل الأشد لأنه أحوط؟ لكن في هذا القول لأننا نقول ما هو الأحوط؟ هل هو الأشد على بني آدم أم هو الموافق للشرع؟ الثاني.... ما كان أوفق للشرع.
ثم قال: «وسد الحيل وسد الذرائع» إن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل، وأشد الناس حيلا ومكرا هم اليهود، وهذه الأمة فيها من تشبه باليهود وتحايلوا على محارم الله.
والحيلة: أصلها حولة من حال يحول. هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح: هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة .
مثال ذلك: رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان وليس له قصد في السفر إلا أن يفطر. ظاهر فعله أنه حلال، لكن أراد بذلك إلى إسقاط واجب وهو الصوم.
مثال آخر: رجل تزوج بمطلقة صاحبه ثلاثا، ورآه محزونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول- الذي هو صاحبه- ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها. نقول: هذا تحيل على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا وأراد أن يحللها له. ولهذا جاء في الحديث بما هو أهل له حيث سمي «التيس المستعار».
ومن باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا رجل باع سلعة ب، 10 آلاف إلى سنة، ثم اشتراها نقدا بـ 8 آلاف. هذه حيلة على أن يعطي 8 آلاف ويأخذ 10 آلاف لأن هذا العقد صوري. ولهذا قال فيه عبد الله بن مسعود أنه دراهم بدراهم دخلت بينهم حريرة، يعني قطعة قماش.
«سد الذرائع» الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة. والفرق بينها وبين الحيلة: أن فاعل الحيلة قد قصد التحيل. وفاعل الذريعة لم يقصد، ولكن فعله يكون ذريعة إلى الشر والفساد.
مثال ذلك: بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا. بمعنى أنها لم تخرق فيه لتسر وجهها إلا مقدار العين؟... لا. إذا يمنع النقاب لأنه ذريعة يتوصل به إلى شيء محرم؟
وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا، أو نبا سمعك، فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق، والمعيار الصحيح، لمدى التحصيل والقدرة على التخريج:
فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله، مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب، نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة.
هذا صحيح.. الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الأحكام عليها، وليس من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو كنسخة من الكتاب، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها، كالبلاغي... وهل البلاغي هو من يبين لك البلاغة وأقسامها، والفصاحة وأقسامها؟ أم من يكون كلامه بليغا؟... الثاني، من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي، حتى ولو لم يكن يعرف من البلاغة شيئا.
ولهذا ينبغي للإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع. بمعنى: أنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا عرف شيئا يمرن نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية.
31- اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل: لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم: الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيي بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو.
لكن هذا لا يضر... ما دمنا نطلب الفقه لا يضرنا أن نتكلم بكلام أو ألا نعرف النحو. لكن لا شك إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا محبوبا للنفس، والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان ويلحن يكره الكلام من هذا الرجل كراهية عظيمة.
فإن عجزت عن فن فالجأ إلى الله عز وجل، ومر علينا في خلاف الأدباء أن أحد أئمة النحو- إذا لم يكن الكسائي- فهو مثله، طلب النحو وعجز عن إدراكه في يوم من الأيام رأى نملة تريد أن تصعد بطعم لها من الجدار فكلما صعدت سقطت ثم تأخذ هذا الطعم وتمشي ثم تسقط ثم تصعد وربما كل مرة تقول: أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوزته، فقال: إذا كانت هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى انتهى أمرها، فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته.
فأنت تحاول لا تقول عجزت هذه المرة، تعجز هذه المرة، لكن المرة الثانية يقرب لك الأمر.
فيا أيها الطالب! ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى:«اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني». فيجد الفتح في ذلك.
وهذا من باب التوسل بأفعال الله، والتوسل بأفعال الله جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل: مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بذكر شكوى الحال وأنه مفتقر إليه، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من يرجي استجابة دعاءه. كل هذا مشروع.



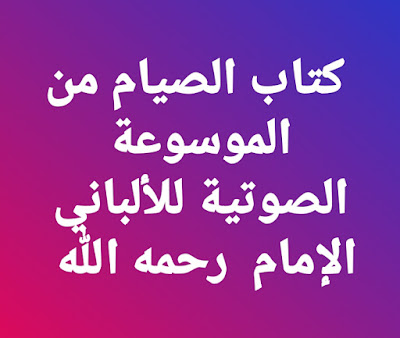

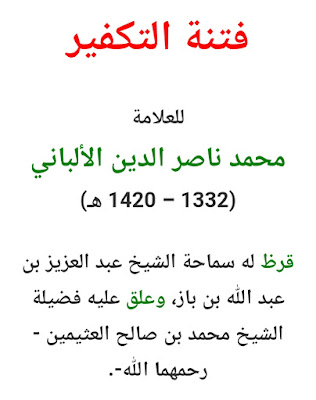

تعليقات
إرسال تعليق