سلسلة أخلاق المسلم من شرح كتاب: الأدب المفرد الشريط الأول
سلسلة أخلاق المسلم
من شرح كتاب: الأدب المفرد
للشيخ العلَّامة / مُحمَّد ناصر الدِّين الألبَاني
(رحمه الله)
الشريط الأوَّل
[حق الطريق]
الحديث الثالث عشر وهو الأخير في هذا الباب أو هذا الفصل وبه نُنهي الدرس، قوله: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رسول الله ﷺ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ") رواه البخاري ومسلم وأبو داوود.
هذا الحديث من الآداب التي يُهملها اكثر المسلمين اليوم، جُلُّهم إهمالًا لضعف الوازع الديني منهم، وقليلٌ منهم لجهلهم بما تضمّنه مثل هذا الأدب النبوي الكريم، فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أوَّل الأمر عن الجلوس في الطرقات: (إياكم والجلوس في الطرقات) هذا النهي واضح المقصود منه؛ لأن الجلوس في الطريق يُعرِّض الجالس فيه لكثير من المخالفات الشرعية، أقلها عرقلة الطريق على المارَّة لاسيَّما إذا كان الجلوس جماعيًا، أي ليس من فرد وإنَّما من اثنين فصاعدا، فكلَّما كثُرَ الجمع كان تعرُّض هؤلاء لشيءٍ من الضَّرر أو الأذى للمارَّة؛ ولذلك وجَّه الرسول ﷺ مثل هذا النهي الصريح: (إياكم والجلوس في الطرقات).
فقالوا: لابد لنا يا رسول الله من الجلوس يعني للتحدُّث في بعض المصالح التي تعرِض لأحدهم في الطريق، فقال ﷺ حينما (قالوا يا سول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدَّثُ فيها، فقال رسول الله ﷺ: إن أبيتم –يعني إن كان ولابد لكم من الجلوس في الطريق - فأعطوا الطريق حقَّه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟، قال: غضُّ البصر: أي يعني لا ترموا بأبصاركم إلى ما قد َّا لا يجوز لكم النظر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي: (النظرة الأولى لك والثانية عليك).
فالجلوس في الطريق يُعرِّض الإنسان لشيءٍ من الفساد؛ لأنه سيرى ولابد شيء من تلك العورات التي لا يجوز النظر إليها، فيجب إذن أن يُجاهد نفسه ولا يُعيد الكرَّة بالنظر إلى ما وقع عليه بصره في العورة لأوَّل مرَّة، فهذا ما أمر به الرسول عليه السلام من غض البصر كحق من حق الطريق، فأولى وأولى أن لا يجوز الجلوس في الطرقات لتقصُّد النظر إلى النساء وإلى العورات، لاسيّما في مثل زمننا هذا الذي خرج فيه النساء عن حدود كل الآداب –لا أقول فقط الآداب الشرعية بل وحتى الآداب الاجتماعية، الجلوس إذن في الطريق للنظر للعورات هذا أول ما يصب النهي في هذا الحديث (إياكم والجلوس في الطرقات)، فإن كان ولابد لقضاء بعض المصالح -كما أشاروا إليه (لابد لنا من الجلوس للتحدُّث)، فلابد حينذاك من مراعاة حق الطريق، فأول ذلك: غض البصر عن العورات
وكفّ الأذى: كف الأذى نصٌ عام يُمكن للإنسان أن يُفسِّره بأي معنى يُخالف للشرع، من ذلك مثلًا أنه لا يجوز الجلوس في الطريق – وأستدرك فأقول ليس المقصود هنا الجلوس فقط بمعنى القعود، فقد كانوا قديما لبساطة عيشهم فعلا يجلسون في الطرقات ولا يَعبؤون بذلك، امَّا نحن اليوم فلا نجلس على الطريق لكنَّنا نقف، فيا تُرى هل الوقوف في الطريق هو منهي عنه كالجلوس المنهي عنه صراحةً في هذا الحديث؟ هنا يتدخل الفقه، والمعنى المقصود من لفظ الحديث (إياكم والجلوس في الطرقات): فمن كان ظاهري المذهب يقف عند ظواهر الألفاظ دون أن يتعمَّق وأن يُمعن النظر في المقصود من تلك الألفاظ، قال: المنهي عنه فقط الجلوس أما الوقوف فليس منهيًّا عنه، هذا جمود على اللفظ الظاهر لا ينبغي للفقيه المسلم أن يجمد عليه لأن المقصود –كما ذكرنا – من النهي عن الجلوس في الطرقات هو لكيلا يتعرَّض المسلم لشيء من المخالفات الشرعية، فسواء كان جالسا فعلا على الأرض قاعدا أو كان واقفا كما هو شأن الكثير من الشباب اليوم الذين يتكتَّلون ثلاثة، أربعة، وينتحون ناحية الطريق ويتحدثون وقد يتغامزون على بعض النساء والفتيات ونحو ذلك، فلا فرق في ذلك بين أن يكون جالسين على الأرض أو وبين أن يكونوا قائمين عليها.
المهم أن الطريق يجب أن يمشي وأن يكون سلسًا ولا يُجعل في شيء من العثرات سواءا كان هو الجلوس أو الوقوف فحق هذا الطريق أوله: غض البصر كما سمعنا، ثم دفع الأذى.
ودفع الأذى هنا أو البعد عن الأذى يكون بمعاني كثيرة، ألَّا يقف هؤلاء الناس أو يجلسوا يتحدَّثون في زيد، بكر، يستفزون الناس وينمُّ بعضهم على بعض، فهذا من الأذى الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من كان لابد له من الجلوس في الطرقات، فقال عليه السلام: (حق الطريق غض البصر وكف الأذى)، أي أذى كان.
ورد السلام: يعني ألَّا يمنع هؤلاء المستغرقين في الحديث من القيام بواجب رد السلام؛ لأن رد السلام فرض على ولو واحد من هؤلاء الجماعة، هذا هو الصحيح، أما إلقاء السلام ففيه قولان للعلماء، منهم من يقول سُنَّة، ومنهم من يقول واجب، والوجوب هو الأصح عندنا، أمَّا رد السلام فلا شك في ذلك لصريح القرآن الكريم في قوله: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء:86] فرَدّ السلام فرض، ولكن إذا كان المُلقى السلام على جماعة فيكفي من أحدهم ويسقط عن الآخرين، فإذا قاموا في الطريق أو جلسوا فيه يتحدَّثون وكان ذلك يصرفهم بصورة لا شعورية عن رد السلام الواجب فلا يجوز حينذاك الجلوس في الطريق مطلقًا؛ لأن السبب الذي يؤدي إلى مُحرَّم فهو مُحرَّم، فالتفاف الناس على التحدُّث في الطريق والحال أنه يصرفهم عن الانتباه إلى رد السلام في هذه الحالة الجلوس في الطريق لا يجوز؛ لأنه لم يُعطي حق الطريق الذي منه غض البصر ومنه كف الأذى ومنه رد السلام.
ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): وهذا للأسف الشديد مما أصبح اليوم نسيا منسيا بسبب تفكك عُرى الوحدة الإسلامية بين المسلمين وضعف الشخصية المسلمة وغلبة أهل الفسق والفجور على أهل العلم والصلاح فأصبح اليوم وضع المسلم في المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان التي أشار إليها الرسول ﷺ بقوله: (مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ –المرتبة الأولى – فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)، فالنهي عن المعروف والنهي عن المنكر أصبح اليوم في أغلب الأحيان أصبح مقره القلب لانتشار الشر وتوسع دائرته، وألَّو تصورنا إنسانا نزل من قرية لم يعرف سواها وأراد أن يُطبِّق ما اعتاده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمعنى ذلك أنه سيظل في الطريق، كل دقيقة بالذوق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكثرة المنكرات التي يأخذ بعضها برقاب بعض، فمثل هذا المجتمع يصعُب على المُسلم أن يُحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرتبة الثانية فضلا عن المرتبة الأولى –المرتبة الثانية يعني بالكلام – لذلك فعلى المسلم اليوم سواءً كان في الطريق أو في أي مجلس من المجالس التي اضطُر للحضور، قد يدخل دائرة من الدوائر مثلا فيرى منكرات مثلا في رمضان، تجد في كثير من الدوائر الدخان الخبيث هذا يعمل عمله في أفواه كثير من الموظفين، فهل تستطيع أن تنكر هذا المنكر ؟ إن فعلت قامت القيامة.
لذلك فقوله عليه السلام:: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فهذا داخل في قاعدة: (اتقوا الله ما استطعتم) أما ما سوى ذلك من الأمور التي تتعلق بشخص جالس أو قائم في الطريق وهي من المستطاع والميسور القيام بها من غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، فليس فيه أي إشكال، فمن قصَّر في مثل هذه الواجبات فلا يجوز له أن يقف في الطرقات لهذا الحديث الصحيح، وبهذا القدر كفاية.
[الوصايا بالجار]
ندخل الآن في الباب الخامس والخمسين، وهو باب الوصايا بالجار، روى المُصنِّف بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) هذا من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي تضمَّنت الحث البليغ في الوصية بالجار والاعتناء به، فإن هذا الحديث يقول بأن الرسول ﷺ تابع نبينا ﷺ في توصيته بأن يستوصى بالجار خيرا حتى ظنَّ الرسول ﷺ من كثرة ما أوصاه جبريل بجاره أنه سيجعله وارثا من الورثة الذين يرثوا فيه الجار جاره. (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) كما يرث الوالد ولده، أو كما يرث الولد والده، هذا من باب عناية الشارع الحكيم بالوصية بالجار..
ومن ذلك الحديث التالي وهو أيضا، وهو أيضا حديث صحيح يرويه المُصنِّف عن أبي شريك الخذاعي عن النبي ﷺ قال (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فليُحسن إلى جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) هذا الحديث يختلف بعض الشيء عن الحديث السابق وإن كان يلتقي به في الموضوع العام من حيث الوصية بالجار، حيث أن في هذا الحديث يأمر بالإحسان إلى الجار، والإحسان ليس مقصورا في القول والكلام فقط وإنما يتعدَّاه إلى العمل، بل هذا هو الأهم، فما يُشعرنا إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (تصدَّقوا ولو بشِق تَمرَة، فإن لم تجدوا فبكلمةٍ طَيبة) فالكلام أهم منه العمل؛ لذلك حضَّ عليه الصلاة والسلام على الصدقة وإخراج الزكاة من المال، فإن لم يجد الإنسان المال فحينئذٍ ينزل إلى الدرجة الدُّنيا وهو حسن الكلام.
فحينما يأمر الرسول عليه السلام في هذا الأحاديث بالإحسان إلى الجار، فمعنى هذا الإحسان: الإحسان إليه عمل وذلك بإكرامه كما سيأتي في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبى ذر بأنه إذا طبخ طبخةً أن يُكثر مرقها ليُعطي جاره من مَرقفه، هذا هو الإحسان العملي، وهذا بالطبع ليس المقصود المرق بالذات، لكن هذا بالنسبة للإحسان العملي إلى الجار يجري مجرى الكلمة الطيبة بالنسبة للصَّدقة إذا لم يجد المتصدِّق الصدقة، كذلك الجار الذي يريد أن يطبخ طبخةً يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يُكثر مرقها، لماذا؟؟ لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يُكثر الطَّبخة نفسها، مثلا: إذا كان كيلو لحم يضع عادةً نصف كيلو ماء فالرسول عليه السلام يقول هنا أكثر المرقة (حط كيلو ماء لكي توزع على الجيران من هذه المرقة) لكن الأولى من هذا بالطبع بدل ما تطبخ كيلو لحم أطبخ اثنين، ثلاثة أربعة، لكن هذا ليس كل إنسان يستطيعه لاسيما في هذا الزمان الذين كان فيه أصحاب النبي ﷺ لا يجد الكثيرون منهم قوت يومهم؛ لذلك أوصاهم بأن يُكثر المرقة، لكن أنا رأيي ليس الوقوف عند المرقة، لكن الوصول إلى نفس اللحم؛ لكن هذا قد لا يستطيعه الكثيرون فليُكثر المرقة على الأقل، هذا من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحسِن إلى جاره) يعني عملا وليس فقط قولا، فإذن الإحسان إلى الجار يشمل أن تهدي إليه شيئا من طعامك، من شرابك، من فاكهتك أو من أي شيء يتيسَّر إليك.
لكن مع الأسف الشديد لقد وصل المسلمون في حالة سيئة جدا من التفكك الاجتماعي بحيث أنَّه لم يعد هناك أية صلة بين الجار والجار حتى ربما ولا بالكلام، ذلك لأنك قد تعيش بين جارين فلا تجد أحدًا منهما يحضر المسجد، فتجد نفسك غريبا من بينهم وهذه الغرابة تجعلك أيضا غريبا عن تطبيق مثل هذه الأحاديث الكريمة الجليلة التي بها يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُحقق الترابط بين المسلم وبين جاره حتى لو كان هذا الجار يهوديا، يعني الإسلام لا يقتصر فقط في الأمر أو في الوصية بالجار أن يعني فقط الجار المسلم بل حتى ولو كان غير مسلم ينبغي أن تستوصي به خيرا كما سيأتي قريبا في بعض الأحاديث الصحيحة.
[حق الضيف]
وفي تمام هذا الحديث الثاني، فقرتان أخريان، الفقرة الثانية بعد الأولى قوله عليه الصلاة والسلام (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه) هذا أيضًا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي جاء بها الرسول ﷺ من ربه –عز وجل – إلى هذه الأمَّة، فهو يقول: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه) فمن فضائل ومكارم الأخلاق: إكرام الضيف، والبيت المُسلِم هو الذي تطرقه أقدام الضيوف، وكلَّما كَثُرت أقدام الضيوف إلى البيت، كلما كان هذا البيت أقرب إلى الإسلام وأشد تحقيقًا له، و كثيرون منَّا في هذا الزمان لا يعلم أن نزول المُسلم في بيت أخيه المُسلم ضيفا هذا حقٌ شرعيٌ له، كما أن للفقير الحق في مال الغني كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج:24] كذلك الضَّيفُ -ولو كان غنيا -إذا نزل في بلد غريب عنه فله على المسلمين حق الضيافة، فلا يجوز لهؤلاء المسلمين أن يُجمعوا على عدم ضيافة هذا الضيف، يعني ضيافتهم فرض كفاية لهذا الغريب، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإذا لم يقُم به أحد منهم فهم قد وقعوا في الإثم أجمعين، وأغرب من هذا ففي الأحاديث الصحيحة أن هذا المسلم الغريب الضيف –بدنا نشتغل بالدرس مو بالأطفال، الأطفال في بيوتكم تشبعوا منهم، أمَّا هنا جايين تتمتَّعوا بالعلم؛ لذلك دعوا الطفولة والتفتوا إلى العلم! [تنبيه من الشيخ –رحمه الله تعالى] –
فمن الأحكام الغريبة في الإسلام والتي تؤكِّد حق الضيف أنه أي ضيف نزل بلدا –قلنا - فله الحق أن ينزل ضيفا على فرد من أفراد البلد، فإذا لم يفعلوا فله الحق شرعًا بأن يطالب بحق الضيافة، حق القِرى، حق الإيواء والضيافة، والقاضي الشرعي طبعا يحكم له، إذا دخل القرية وما أحد أضافه بيقيم دعوة: إنه أنا مثلا رحت عند فلان وما قبلني، وفلان ما قبلني ضيفا، وحينئذٍ يحكم القاضي على هذا البيت الذي لم يقبل ضيافة هذا الغريب مقدارا يكفيه يوم مثلا أو أكثر، يقول الرسول ﷺ في بعض الأحاديث الصحيحة: (حقُّ الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فجائزة) أي نافلة، فكل ضيف ينزل على مسلم فله حق الضيافة عليه ثلاثة أيام، فإذا أحب أن يضيف صاحب الدار أن يزيد كرما وفضلا أبقاه عنده ما شاء من الزيادة بعد الثلاث، أما الثلاث فهو حق ليس له فيه مِنَّة على الغريب، حق واجب له عليه، فإن زاد فهذا نافلة.
هذا مما أدَّب الرسول ﷺ صاحب الدار، ولكن لم ينس أن يتوجَّه بالتأديب إلى الضيف، فإن بعض الضيوف يكونون ثُقلاء في الحقيقة، فإنهم بعد أن يمكثوا الحق المُعطى لهم في الشرع وهو ثلاث أيام يظلُّون مرابطين لا يتحرَّكون، وكأنَّهم هذا أيضا من حقِّهم، فالرسول ﷺ لمثل هؤلاء: فإذا انتهت هذه الثلاثة أيام فليرحل ولا يُحرِّج صاحب البيت، هكذا أدَّب الرسول ﷺ كلَّا من المضيف والضيف، حق الضيافة مع الزمن ومع تطور المسلمين بما يُسمونه بالمدنية الحاضرة، ومن آثار المدنية الحاضرة القضاء على كثير من الآداب الإسلامية ومنها الضيافة وبحُكم هذا التأثُّر بالمدنية الغربية اليوم يكاد يموت معنى الضيافة في البلاد الإسلامية، ولذلك كان كنتيجة طبيعية أن تكثُر الفنادق في المدن الإسلامية لقاء أن الناس أماتوا حق الضيافة، فقلَّ من يأتي وينزل ضيفا، حتى المسلمين منهم والذين لا يزالون على شيء من التمسُّك بالإسلام، ولنقُلها صراحة حتى بعض إخواننا الذين لهم بنا صلة إذا جاءوا إلى دمشق مثلا يأتين في المساء أو في الصباح فنفهم منهم أنه نزل في فندق لماذا؟؟ لأنه لم تُشبَّع أفكاره بأن له حقًا، إذا جاء من بلده إلى بلد له فيه صديق فمن الحق له على هذا الصديق أن ينزل ضيفًا عنده، ماتت هذه المعاني لذلك ينزل في الفندق، نتيجة ذلك أن أصبح نساؤنا أيضًا يتضايقن ممَّا لو نزل فيهنَّ ضيفٌ، هذا كله سببه عدم التأثُّر بالسُّنَّة، والتضايق هذا نجده مع عدم كثرة الضيوف بحكم موت هذه المعاني الجميلة، فكيف يكون وضع نسائنا لو كان الوعي الإسلامي منتشرا بين المسلمين جميعا إذن لوجب على أصحاب البيوت أن يفتحوا أبوابهم على الأقل كل يوم ضيف أو ضيفين، لأن السفر اليوم كثير وكثير جدا، إذن لا يُمكن أن نُصلح وضعنا ومجتمعنا إلَّا بالعلم.
لذلك نحن نقول لابد من التصفية والتربية، لابد من تصفية العلوم التي تلقينا قسمًا كبيرا منها محرَّفا عن الكتاب والسنَّة، فلا بد من تصفيته، ثم لابد من أن نربي أنفسنا على هذا العلم المُصفَّى، فمن هذا العلم قوله عليه الصلاة والسلام (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه) وإكرام الضيف إنزاله في المنزل المناسب له وتقديم ما يُمكن من الطعام والشراب ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك إمَّا أن يُزاد في إحسانه إن كان مستطاعا أو يُعتذر إليه....
ومن تمام الحديث: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) وهذا أدبٌ أيضا من آداب الإسلام السامية والعالية،وأعتقد وأقولها صريحةً: إن النساء أحق وأوجب من يجب عليهنَّ أن يتأدَّبن بهذا الأدب، نقول هذا لأن النساء أنفسهن يشهدن بأنهن يتكلَّمن أكثر من الرجال، أليس كذلك؟، لذلك الواجب عليهن –كالرجال طبعا - أن يتذكروا جميعا هذا التوجيه النبوي الكريم وهو قوله عليه الصلاة و السلام (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، ولذلك قالوا في الحكم القديمة: (إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب)، هذا أدب من آداب الإسلام العامة إذا إلا بيتكلَّم أو بيسكت سواء كان في بيته أو في دكَّانه أ, أو إلى آخره، فليُفكِّر إذا كان وجد في الكلام خيرا فالأحسن يتكلَّم، إن كان ما فيه خير الكلام فالأحسن أن لا يتكلَّم، يعني أن هذا النفَس ما يروح سُدى، فإمَّ أن يصمُت عن الكلام ويسكت، وإما إذا تكلَّم فليتكلَّم بخير.
بعد أن قدَّم حديثين صحيحين بالوصية للجار بدأ الآن يعقدُ فصلًا خاصًّا، فيقول:
الباب السادس والخمسين: باب حق الجار:
روى بإسناده الصحيح عن المقداد بن الأسود قال: سأل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا ؟، قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ ﷺ: لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ -وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ) هذا حديث واضح جدًّا – كما يقولون اليوم – في تقويم حق الجار بحيث أن الإضرار بأي مسلم ليس جارا له يتضاعف هذا الإضرار فيما إذا كان جاره عشرة أضعاف، فهذا الحديث يوضِّح ذلك أتمَّ توضيح.
[حق الجار]
الباب السابع والخمسين: باب يبدأ بالجار
[هذا] الباب هو أيضا تأصيل لمبدأ حق الجار والوصية بالجار، فيقول:
باب: يبدأ بالجار: يعني إذا أراد أن يقسم مالًا أو عطيَّةً أو هدية فيبدأ بجاره قبل غيره، ذكر في ذلك حديثين اثنين أحدهما يتضمَّن مبدأ عامَّا للوصية بالجار والآخر يوضِّح الذي ترجم له بقوله: يبدأ بالجار.
الحديث الأوَّل: عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)، وهذا تقدَّم في أول الدرس من حديث السيدة عائشة.
الحديث الثاني: وفيه موضع الشاهد يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه ذُبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديتَ لجارنا اليهودي ، أهديتَ لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)
يأتي باب جديد فيما بعد فيه أيضا تأكيد للبداءة بالأقرب، وإنما هنا الشاهد أن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فَهِمَ من وصية الرسول ﷺ بالجار أنه حينما ذبحت له شاةٍ –أي عبد الله بن عمرو- استوثق من غلامه: أي خادمه، فهل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وكرر ذلك مرتين أو أكثر، ثم استشهد على ذلك بأنه سمع الرسول ﷺ يقول: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) ففَهِمَ بن عمرو أن النار في الحديث يشمل حتى الجار غير المسلم، لذلك لمَّا ذُبحت تلك الشاة لابن عمرو قال لعبده –خادمه، غلامه – هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ لأنه داخل في قولنا عليه الصلاة و السلام (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)
أعاد المُصنِّف الحديث بعده الحديث المتقدِّم في أول الدرس من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثُهُ)
الباب الثامن والخمسون: باب: يهدي إلى أقربهم بابا
روى بإسناده الصحيح عن عائشة قالت: (قلت يا رسول الله إنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدى؟، قال: إلى أقربِهما منك بابا)
هذا طبعا السؤال هنا: (فإلى أيهما أهدى؟) فيما إذا كانت الهدية محصورة، محدودة، فهو لا يستطيع مثلا أن يهدي إلى جارين، جار على اليمين وجار على اليسار، فجاء هذا السؤال: (فإلى أيهما أهدى؟) قال: (إلى أقربهما مِنكَ بابا) فهو أحق بهذه الهدية التي لا تستطيع أن تُعددها وتُكررها، مادام أنه أقرب بابه إلى بابك من باب الجار الآخر، فهذا من جملة التفصيل في مبدأ إكرام الجار والوصية بالجار.
2 - الحديث الثاني بنفس معنى الأول، وهو عن عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: قلت: (يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيِّهما أُهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابا)، قد يسأل سائل هنا ممن ليس له معرفة باصطلاح علماء الحديث في كتب الحديث والأبواب، لماذا يُكرر البخاري الحديث الواحد في الباب الواحد؟ كان يظهر جواب هذا السؤال لو كان من عادة المُدرسين اليوم والطلاَّب أن يقرؤا الحديث مع السند، فلو أننا قرأنا الحديث مع السند لعرف السائل السر في تكرار الحديث ولنعمل تجربة الآن قبل ما أعطيكم جوابا مختصرًا:
في هذا الباب: باب: يُهدي إلى أقربهم بابا، ذكر البخاري الحديثين كما قلنا فهو يقول:
في الحديث الأول: حدثنا حجَّاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: (قلت: يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدى؟، قال: إلى أقربهما منك بابا)
ثم قال البخاري:
[الحديث الثاني ]:حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبى عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بنى تيم بن مرة، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: (قلت يا رسول الله...) وساق الحديث.
اختلف السند، إذن كرر البخاري الحديث مرة ثانية مع أنه هو هو الحديث المتقدِّم في المرَّة الأولى، لأنه هناك اختلاف فيه السند سواء كان من أوله أو في آخره، وهذه طبعا تُعطي فائدة من الناحية الحديثية للحديث، وأحيانا تعطيه قوة.
الباب التاسع والخمسون: باب: الأدنى فالأدنى من الجيران
الآن يعقد بابًا جديدا يبين الجار الذي وصَّى به الرسول ﷺ هذه وصايا عديدة، يا ترى يشمل الجهات الأربعة والا شلون؟، فهو يقول الآن بيانا لهذا السؤال.
ساق بإسناده الحسن عن الحسن -الحسن هنا هو البصري التابعي، وليس الحسن بن علي بن أبي طالب- عن الحسن أنه ُسئل عن الجار فقال: (أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره) هؤلاء هم الجيران... [يضحك الشيخ والحاضرون]
فإذا واحد بدُّه يعمل خير،هدية، توزيعة بمناسبة ما، عنده استعداد إنه يوصِّل أربعين باب من يمينه، وأربعين من يساره، وأربعين أمامه وخلفه، وهكذا.
الحديث الذي بعده على قاعدتنا حديث ضعيف، لذلك لا نقرأه
الباب الستون: حديثه ضعيف
الباب الواحد وستون: باب لا يشبع دون جاره
روى بإسناده الصحيح عن عبد الله بن المساور قال سمعت بن عباس يُخبر بن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس المؤمن الذي يشبعُ وجارهُ جائع) هذا أيضا من حق الجار لأخيه إذا كان لك جارٌ فقير، تعرفه أنه من فقره يباتُ جائعا وأنت تستطيع أن تُطعمه بحيث يبات وينام شبعان ريَّان، فلم تفعل فلست مؤمنا، وقد يُشكل على بعض الناس مثل هذا الحديث بعد أن عرفنا أن الحديث فيه حضّ على الاعتناء بالجيران لاسيما إذا كانوا فقراء ومساكين، فقد يشكل الحديث من جهة أنه ينفي الإيمان عن هذا المُسلم الذي بات وجاره إلى جنبه جائع، فكيف يكون ليس بالمؤمن؟ فهل معنى هذا الحديث إنه يُصبح بسبب هذه المعصية كافرا؟
هذا الحديث له أمثلة كثيرة جدا في السُّنّة، فيجب أن نفهم هذا الحديث وأمثاله حتى ما يُصيبنا شيء من الاختلاط في العقيدة، فنسمع ونقرأ في كتب الفرق الضالَّة أن من هذه الفرق فرقة الخوارج، وفرقة أخرى أشهر منها وهي المعتزلة، هؤلاء يقولون بأن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر ليس مسلمًا، الخوارج يُخرجونه من دائرة الإسلام ويدخلونه في الكفر، أما المعتزلة فيجعلونه في منزلةٍ بين منزلتين، يقولون أنه ليس بمسلم وليس بكافر. هذا من الضلال الذي جاءهم بسبب سوء فهم مثل هذا الحديث.
(ليس المؤمن) إذن هل هو كافر؟؟؟ الجواب: لا، وإنما يعني ليس بالمؤمن الكامل الإيمان الذي يبات وجاره جائع بجانبه، وليس المقصود به أنه كافر لأن الإيمان في أصح قولي العلماء يقبل التجزؤ، كما يقول علماء السلف: يزيد وينقص، فزيادته ليس لها حدود مُطلقا وزيادة الإيمان طريق القرآن الكريم كما قال: ﴿ليزداد الذين آمنوا إيمانا﴾ ومثل هذا النص في القرآن نصوص كثيرة جدا، ولذلك حينما يأتي مثل هذا الحديث: (ليس بالمؤمن)، (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) ليس المعنى من هذا الحديث وذاك وأمثالهما إخراج هذا العاصي بارتكاب هذا الذنب من دائرة الإسلام مطلقا، ومن دائرة الإيمان من أصله، وإنما المقصود إخراجه من دائرة الإيمان الكامل.
فقوله ﷺ: (ليس المؤمن): المقصود بها هنا المؤمن الكامل الإيمان أي إن الذي يبات وجاره إلى جنبه جائع فهو ناقص الإيمان، فعليه أن يتدارك هذا النقص بأن يلتفت إلى جيرانه ويعتني بهم فيما إذا كانوا فُقراء ويبات أحدهم من فقره جائعا، فعليه أن يطعمه بقدر ما يستطيع ويقدر عليه، ولا يُكلِّف الله نفسا إلا وسعها.
من شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيّما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحُمَّى وما جاء فيمن فقد بصره
هذا باب واسع،فيه عديد من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع الذي ترجم له المصنِّف –رحمه الله-.
الحديث الأول وهو حديث صحيح، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا) رواه مسلم
في هذا الحديث عدّة فقرات، في كل فقرة منها علم وهدى ونور، الفقرة الأولى:
(الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ):
ذكر العلماء في تفسير هذه الفقرة عدة أقوال: أقربها أن المقصود هنا بالطُّهور: هو الوضوء نفسه، والمقصود بالإيمان هو الصَّلاة، فيكون الوضوء بالنسبة للصلاة الشطر، وليس هناك غرابة في تفسير الإيمان بالصلاة؛ لأن هذا المعنى جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ ﴾ [البقرة:143] ففسّر علماء التفسير الإيمان في خصوص هذه الآية بالصلاة، فعلى هذا جاء الحديث أيضًا: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)، فالإيمان: الصلاة، وشطر هذه الصلاة هو الوضوء لما تعلمون من أمر الوضوء هو ركن من أركان الصلاة، ولا يُشكل على هذا أن للصلاة أركان أخرى؛ لأن العلماء قالوا لا يلزم من كون الشيء شطرا لشيء آخر أن يكون شطرًا على الدقة وإنّما هو قريب من ذلك، فكأن قول الرسول ﷺ (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ) نحو قوله: (الحج عرفة) يعني يذكر أو يُخصِّص بالذكر (الطُّهور) الذي هو (الوضوء) وأنه شطر الصلاة لأهمية الطهارة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: (ولا صلاةَ لمن لا وضوء له)، هذا هو المعنى الأول والذي اختاره بعض شُراح الحديث ومنهم الإمام النووي –رحمه الله –
وهناك معنى آخر وذلك بتوسيع معنى (الطُّهور) وتوسيع معنى (الإيمان)، على نحو ما فسَّرنا الدرس الماضي (العافية) حيث قلنا إن بعض العلماء خصصوها بالعافية البدنية، فقلنا الأولى أن نجعلها تشمل البدنية والروحية والمعنوية، فالأمر كذلك هنا في الرأي الآخر في تفسير هذا الحديث، الطُّهور هو بالمعنى المادي والمعنوي، فأن يتنظَّف الإنسان في بدنه وفي أخلاقه حينئذٍ هذه الطهارة بقسميها المادِّي والمعنوي هي شطر الإيمان؛ لأن الإيمان يشمل أيضا الاعتقادات ويشمل الأخلاق ويشمل العبادات وكل شيء جاء به الإسلام، هذا المعنى الثاني هو ممكن أيضا تفسير الحديث به لكن المعنى الأول لعله أقرب إلى سياق هذا الحديث، حيث ذكر الصلاة وذكر الصدقة ونحو ذلك.
ثم قال ﷺ في بيان فضل حمد الله -عز وجل- وتسبيحه، قال: (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأ ُ- الشك من الراوي- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) في هذا الحديث بيان أن هناك ميزان توزن به الأعمال وذلك يوم القيامة، فهناك آيات كثيرة، أحاديث عديدة وتصف هذه الأحاديث الميزان وصفًا يمنع تأويل الميزان المذكور في تلك الآيات المشار إليها بالتأويل الخلفي الاعتزالي، ذلك أن الخلافات القائمة بين أهل السنَّة وأهل البدعة ومنهم المعتزلة إنكار لكثير من الأمور الغيبية ومنها الميزان، فإن المعتزلة يُفسِّرون الميزان بمعنى الحساب فقط،ويعنون أنه ليس هناك ميزان حقيقي، وبداهةً لا نعني نحن أننا حينما نُثبت الميزان حقيقةً أن هذا الميزان الذي هو عبارة عن مادة من حديد و من نحاس وفيه كفّتين أو ما شابه ذلك، فربنا -عز وجل- لا يزال يُظهر لعباده حُججا مستمرة عليهم يحملهم على أن يخضعوا للأمور الغيبية وألَّا يُدخلوا عقولهم فيها، فمن ذلك ما نحن بصدده، الميزان ذُكر في القرآن ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ ﴿فأما من ثقُلت موازينه﴾ وآيات كثيرة يستحضرها جماهيركم، فنقول أن هذا الميزان المذكور في القرآن وُصف في السنَّة أن له كفَّتان أيضا، وأن الكفَّة إذا رجحت بالحسنات فهو ناجٍ، والعكس بالعكس، فإذن هذا ميزان حقيقي ولكن حقائق الآخرة لا تُشبه حقائق الدنيا، ولذلك فلا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أنه مش معقول يكون ذاك الميزان كهذا الميزان إذن ننكر حقيقة ذاك الميزان كما فعل المعتزلة!!.



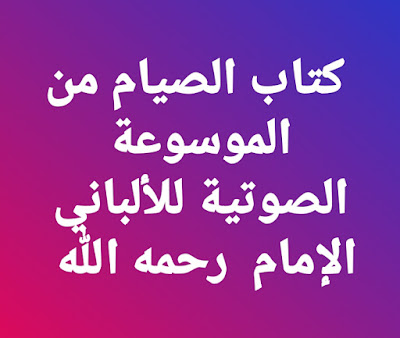

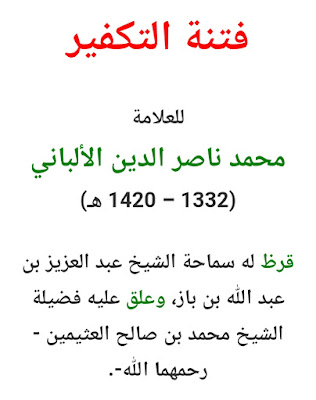

تعليقات
إرسال تعليق