تدوين الأحاديث تدوينا عاما .. نشاط حركة التدوين .. الرحلة في سبيل العلم .. الأطوار التي مر بها تدوين الحديث
نَشَاطُ حَرَكَةِ التَّدْوِينِ :
وقد قام العلماء في كل مِصْرٍ بما ندبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسُنن وتمحيصها، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرَّجُ من الكتابة، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولاً في كتابة الأحاديث، واستقرَّ الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان مِمَّنْ يتعين عليه تبليغ العلم (3).
وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الإزدهار، وتجرَّد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافاة المضاجع، ولازموا الدفاتر والمحابر، وحرصوا على لقاء الأشياخ، والأخذ من
_______________
(3) " فتح الباري ": 1/ 165.
______________________________
الأفواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية، على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال، مُثُلاً عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين.
وما زال العلماء يجمعون الأحاديث، وينقدون ويمحصون، ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن، وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف، والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح، وبدأت عصور الترتيب والتهذيب، أو الاستدراك والتعقيب، وذلك في العصر الرابع وما تلاه من العصور.
وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة :
وهي أن السُنَّة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأنَّ التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النَّبِي، وأنه قوي وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوقه في القرن الثالث الهجري خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرِيَّةَ، خيرِيَّةَ الإيمان والعلم والعمل، والهُدَى والفلاح والاستقامة على الجادة.
الرِّحْلَةُ فِي سَبِيلِ العِلْمِ :
لعل ما يتميَّز به أئمة العلم في الإسلام، ولا سيما أئمة الحديث وجامعوه كثرة الارتحال، وملازمة الأسفار، وقد جَرَوْا في ذلك على سُنَنِ الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الرُواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمَّنْ رواه بلا واسطة، وقد ثبت في " صحيح البخاري " تعليقاً بصفة الجزم أنَّ جابر بن عبد الله الأنصاري رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنَيْسٍ (1) في حديث واحد، والقصة بتمامها - كما أخرجها البخاري في: " الأدب المفرد " وأحمد وأبو يعلى في " مُسْنَدَيْهِمَا " - من طريق عبد الله بن محمد
____________
(1) بضم الهمزة مصغرًا، وهو جُهَنِيٌّ حليف للأنصار.
______________________________
بن عقيل أنه سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ حَدِيثٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ رَحْلِي فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَإِذَا عَبْد اللَّه بْن أُنَيْسٍ»، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ: «قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ»، فَقَالَ: «اِبْنَ عَبْدِ اللهِ؟» قُلْتُ: «نَعَمْ»، فَخَرَجَ فَاعْتَنَقَنِي. فَقُلْتُ : «حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ» فَقَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «يَحْشُرُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً ... » الحديث.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : «كَانَ يَبْلُغْنِي عَنِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ فِي الْقِصَاصِ , وَكَانَ صَاحِبُ، الحَدِيثِ بِمِصْرَ , فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا فَسِرْتُ حَتَّى وَرَدْتُ مِصْرَ , فَقَصَدْتُ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ». فذكر نحو القصة الأولى.
وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال : أتاني جابر فقال لي : «حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْوِيهِ فِي السَّتْر عَلَى اَلْمُسْلِمِ»،فذكره. والظاهر أنها قصص مُتَعَدِّدَةٌ رحل فيها جابر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَة.
وَرَحَلَ السَيِّدُ الجَلِيلُ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ بِسَبَبِ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ فِي السَّتْر عَلَى اَلْمُسْلِمِ، رواه أحمد بسند منقطع، وروى أبو داود في " سننه " مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ [أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ في حديث.
وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين، روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال : «بَلَغَنِي حَدِيثٌ عِنْدَ عَلِيٍّ فَخِفْتُ إِنْ مَاتَ أَنْ لاَ أَجِدهُ عِنْدَ غَيْرهِ، فَرَحَلْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الْعِرَاقَ».
وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : «إِنْ كُنْت لأَرْحَلُ الأَيَّام وَاللَّيَالِي فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ».
وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال : «كُنَّا نَسْمَع عَنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نَرْضَى حَتَّى خَرَجْنَا إِلَيْهِمْ فَسَمِعْنَا مِنْهُمْ» (1).
قال الشعبي في مسألة أفتى فيها : «أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، [قَدْ] كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ».
وقد روى " الدارمي " بسند صحيح عن بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «إِنْ كُنْتُ لأَرْكَبُ إِلَى
_______
(1) " فتح الباري ": 1/ 141، 142.
______________________________
المِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، [لأَسْمَعَهُ]». وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : «لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ [ثَلاَثًا] مَالِي حَاجَةً إِلاَّ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَدِيثٌ يَقْدَمُ فَأَسْمَعُهُ مِنْهُ».
وَقِيلَ أَحْمَد: «رَجُلٌ يَطْلُبُ العِلْمَ، يَلْزَمُ رَجُلاً عِنْدهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، أَوْ يَرْحَلُ؟ قَالَ: يَرْحَلُ، يَكْتُبُ عَنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ».
ومِمَّنْ ارتحل في سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن المُحَدِّثِينَ جَمٌّ غَفِيرٌ، ويأتي في الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وإنَّ منهم من لم يذق طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته.
الأَطْوَارُ التِي مَرَّ بِهَا تَدْوِينُ الحَدِيثِ :
قلنا إنَّ التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة وإنَّ العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وتجرَّد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم، وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح فألف الإمام مالك (م 179) بالمدينة، وألف أبو محمد عبد العزيز بن جريج (م 150) بمكة والأوزاعي (م 156) بالشام، ومعمر بن راشد (م 153) باليمن، وسعيد بن أبي عروبة (م 156) وحماد بن سلمة (م 176) بالبصرة، وسفيان الثوري (م 161) بالكوفة، وعبد الله بن المبارك (م 181) بخراسان، وهُشيم بن بشير (م 188) بواسط، وجرير بن عبد الحميد (م 188) بالري وغير هؤلاء كثيرون، وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري.
وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ويظهر ذلك بجلاء في " موطأ الإمام مالك ".
ثم حدث طور آخر في تدوين الحديث، وهو إفراد حديث رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خاصة وكانت تلك الخطوة على رأس المائتين، وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة، منهم من ألَّف على المسانيد، وذلك بأنْ يجمع أحاديث كل صحابي على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا، وذلك كـ " مسند الإمام أحمد " وعثمان بن شيبة واسحق بن راهويه
وغيرهم، وأصحاب المسانيد لم يتقيَّدوا بالصحيح بل خَرَّجُوا الصحيح والحسن والضعيف.
ومنهم من ألَّف على الأبواب الفقهية كأصحاب " الكتب الستة " المشهورة وهؤلاء منهم من تقيد في جمعه الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم ومنهم من لم يتقيَّد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحياناً ومع عدم التنبيه أحياناً أخرى، اعتماداً على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود وذلك مثل أصحاب " السنن الأربعة ": أبي داود والترمذي والنَسَائي وابن ماجه.
وقد كان القرن الثالث الهجري (200 - 300) أسعد القرون بجمع السُنَّة وتدوينها ونقدها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته، وحُذَّاق النقد وصيارفته، وفيه أشرقت شموس " الكتب الستة " وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث، ولا يغيب عنها إِلاَّ النذر اليسير والتي يعتمد عليها الفُقَهَاء والمستنبطون، والمؤلفون والمعلِّمون، ويجد فيها طلبتهم الهُداة والمصلحون، والمتأدبون والأخلاقيون، وعلماء النفس والاجتماع.



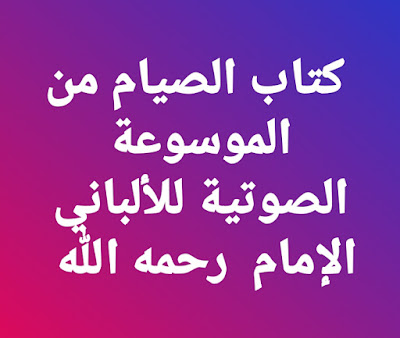

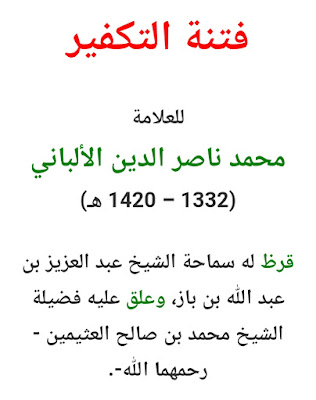

تعليقات
إرسال تعليق