عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِنَقْدِ الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ .. عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِفِقْهِ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهَا .. الرِّوَايَةُ بِاللَّفْظِ وَالمَعْنَى
عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِنَقْدِ الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ :
وقد عني المُحَدِّثُونَ عناية فائقة بنقد الأسانيد بحيث لم يَدَعُوا زيادة لمستزيد وقد خلَّفوا لنا في نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة، منها ما ألِّف في الثقات، ومنها ما ألِّف في الضعفاء، ومنها ما ألِّف فيما هو أعم منهما، ولم يكتفوا في نقدهم للرجال بالتجريح الظاهري، بل عنوا اَيْضًا بالنقد النَفْسِي، وليس أَدَلَّ على هذا مِنْ تفريقهم بين رواية المُبْتَدِع الداعية وغير الداعية، فردُّوا رواية الأول وقبلوا رواية الثاني، لأنَّ احتمال الكذب في الأول قريب، ولا كذلك الثاني، وكذلك رَدُّوا رواية المُبْتَدِع وإنْ كان غير داعية إذا روى ما يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ، لأنَّ احتمال الكذب قريب لتأييد بِدْعَتِهِ، وقبلوا رواية المُبْتَدِع الداعية إذا روى ما يخالف بدعته، لأنَّ احتمال الكذب من الناحية النفسية بعيد جداً في هذا.
وكذلك اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام، وقبول جوائزهم ونحو ذلك مِمَّا راعوا فيه أنَّ الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف.
وكما عني المُحَدِّثُونَ بنقد الأسانيد - النقد الخارجي - عنوا بنقد المتون - النقد الداخلي - وليس أدلَّ على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل أو المشاهدة والحس مع عدم إمكان تأويله تأويلاً قريباً محتملاً وأنهم كثيراً ما يَرُدُّونَ الحديث لمخالفته للقرآن أو السُنَّة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف مع تعذر التوفيق، وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ، ومُعَلَّلَ المتن ومضطرب المتن إلى غير ذلك.
نعم لم يبالغ المُحَدِّثُونَ في نقد المتون مبالغتهم في نقد الأسانيد لأمور جديرة بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاتئاد في البحث الصحيح، وسأعرض لهذا بالتفصيل والتوضيح فيما بعد.
عِنَايَةُ المُحَدِّثِينَ بِفِقْهِ الأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهَا :
وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها، ولم يكونوا زَوَامِلَ للأخبار لا يفقهون لها معنى كما زعم بعض المُتَخرِّصِينَ على المُحَدِّثِينَ، والرعيل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيّاً من الشوائب والغرائب، كانوا أهل فقه ودِراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد والسُفْيَانَيْنِ الثَوْرِي وابْنِ عُيَيْنَةَ، والبخاري ومسلم، وباقي أصحاب الكتب الستة وغيرهم، قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعتُ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: «إِذَا كَانَ يَعْرِفُ الحَدِيثَ وَمَعَهُ فِقْهٌ أَحَبَّ إِليَّ مِمَّنْ حَفِظَ الحَدِيثَ وَلاَ يَكُونُ مَعَهُ فِقْهٌ».
وروى الحاكم في " تاريخه " عن عبد العزيز بن يحيى قال: قال لنا سفيان بن عُيينة: «يَا أَصْحَابَ الحَدِيثِ تَعَلَّمُوا مَعَانِي الحَدِيثِ، فَإِنِّي تَعَلَّمْتُ مَعَانِي الحَدِيثِ ثَلاَثِينَ سَنَةً» (1). وإنك لتلمس أثر الفقه والفهم للأحاديث في " صحيح الإمام البخاري " في تبويبه الأبواب، وطريقته في التراجم، وتكراره أو تقطيعه للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية، وكثيراً ما يُدْلِي برأيه في مسائل تكون موضع الخلاف، وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يَتَرَجَّحْ عنده شيء حتى لقد قيل: «فِقْهُ البُخَارِي فِي تَرَاجِمِهِ»، وكذلك طريقة مسلم في ترتيب كتابه، وطريقة أصحاب السُنن ولا سيما الترمذي فقد عرض في " سُننه " لكثير من الآراء الفقهية عَرْضَ رجلٍ وَاعٍ فاهمٍ عارفٍ.
نعم لقد وُجِدَ في العصور المتأخِّرة أناس - وَهُمْ قلَّة - جعلوا هَمَّهُمْ الرواية والجمع دون الفقه والفهم للمتون، وهؤلاء إنما وجدوا بعد أنْ جُمِعَتْ السُنن والأحاديث في دواوينها المعتمدة ولعلَّ هؤلاء هم الذين عناهم أبو الفرج بن الجوزي في كتابه " صيد الخاطر " ووصفهم بأنهم زوامل للأسفار يحملون ما لا يعلمون (2)، وإلاَّ فقد كان هناك من أمثاله كثيرون.
الرِّوَايَةُ بِاللَّفْظِ وَالمَعْنَى :
لا خلاف بين العلماء أنَّ المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحُكْمٌ من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راوٍ المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، بل قد أوجبه قومٌ ومنعوا نقل الحديث بالمعنى.
والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتَحَوُّطَاتٍ بالغة فقالوا: نَقْلُ الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها، العارف بالفرق بين المُحْتَمَلِ وغير المُحْتَمَلِ، والظاهر والأظهر، والعام والأعمّ، فقد جَوَّزُوا له ذلك، وإلى هذا ذهب جماهير الفُقَهَاء والمُحَدِّثِينَ.
_______
(1) " الآداب الشرعية ": 2/ 129.
(2) المرجع السابق: ص 132.
_______________________
وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أنَّ الرواية بالمعنى رُخْْصَةً تتقدَّر بقدرها، وكان منهم مَنْ يتقيد باللفظ ويَتَحَرَّجُونَ مِنَ الرواية بالمعنى، قال وكيع: «كَانَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ - رَحِمَهُمْ اللهُ - يُعِيدُونَ الْحَدِيثَ عَلَى حُرُوفِهِ» ومِمَّنْ كان يُشَدِّدُ في الألفاظ الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهُ - فقد منع الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سواها، رواه البيهقي عنه في " المدخل ".
ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، قال ابن سيرين: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ - رَحِمَهُمْ اللهُ - يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي» (1).
ومِمَّا ينبغي أنْ يُعْلَمَ أنَّ جواز الرواية بالمعنى في غير ما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أنْ يُغَيِّرَ لفظ شيء من كتاب مُصنَّف ويُثْبِتَ بَدَلَهُ فيه لفظاً آخر بمعناه، فإنَّ الرواية بالمعنى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إنْ ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره كما قال ابن الصلاح (2)
ومِمَّا ينبغي أنْ يُعْلَمَ اَيْضًا أنهم استثنوا من الأحاديث التي جَوَّزُوا روايتها بالمعنى الأحاديث التي يُتَعَبَّدُ بلفظها كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها كجوامع كلمه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرائعة.
فإذا علمنا أنَّ التدوين الخاص وجد في القرن الأول، وأنَّ التدوين العام كان في أول القرن الثاني، وأنَّ الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة، والصحف المكتوبة، وأنَّ الذين نقلوا الأحاديث وَرَوَوْهَا منهم من التزم اللفظ ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى، وهؤلاء المُجِيزُونَ كانوا عرباً خلصاً غالباً، وأنهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وأنهم قد سمعوا من الرسول أو مِمَّنْ سمعوا من الرسول وشاهدوا أحواله، وأنهم أعلم الناس بمواقع الخِطاب ومحامل الكلام، وأنهم يعلمون حق العلم أنهم يَرْوُونَ ما هو دين، ويعلمون حَقَّ العلم حرمة الكذب على رسول الله، وأنه كذب
_______
(1) " جامع الأصول ": 1/ 54، " الباعث الحثيث ": ص 166.
(2) " مقدمة ابن الصلاح: ص 189.
_______________________
على الله فيما شرع وحكم.
إذا علمنا كل ذلك - وقد دَلَّلْنَا فيما سبق - أَيْقَنَّا أنَّ الرواية بالمعنى لم تَجْنِ على الدِّينِ، وأنها لم تُدْخِلْ على النصوص التحريف والتبديل كما زعم بعض المُسْتَشْرِقِينَ وَمَنْ لَفَّ لَفَّهُمْ، وأنَّ الله الذي تَكَفَّلَ بحفظ كتابه قد تَكَفَّلَ بحفظ سُنَّة نبيِّه من التحريف والتبديل، وقَيَّضَ لها في كل عصر من ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين، فذهب الباطل الدخيل، وبقي الحق مورَدًّا صافياً للشاربين {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} (1).
_______
(1) [سورة سبأ، الآية: 49].



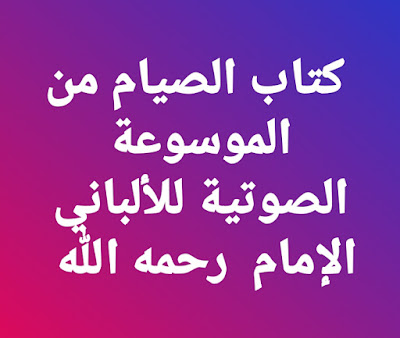

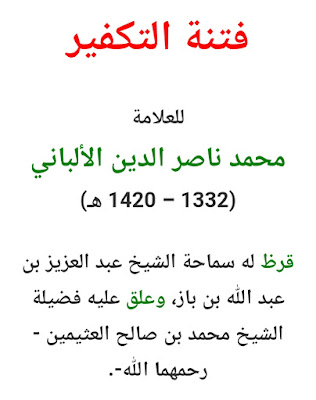

تعليقات
إرسال تعليق