سلسلة أخلاق المسلم من شرح كتاب الأدب المفرد
سلسلة أخلاق المسلم
من شرح كتاب : الأدب المفرد للشيخ العلَّامة / مُحمَّد ناصر الدِّين الألبَاني (رحمه الله)
الشريط الثَّالث
[تكملة الشريط الثاني، وتتمّة شرح حديث : (لا يحل لمسلمٍ أن يُصارم مسلمًا فوقَ ثلاث، فإنَّهما ناكبانِ عن الحق ما داما على صِرامِهما وإنَّ أوَّلَهُمَا فيئًا يكون كفارة عنه سبقُه بالفيء، وإن ماتا على صِرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا، وإن سلَّم عليه فأبَى أن يقبَل تسليمَهُ وسلامه، ردَّ عليه الملك، وردَّ على الآخر الشيطان)]
فحسبه أن يُبادر ذلك المُقاطَع بالسَّلام فيكون سلامه عليه رفعًا للإثم السابق والواقع عليه. ثم إنَّ الله - تبارك وتعالى - من فضله وكرمه يُسخِّر ملكًا من الملائكة إذا سلَّم أحد المتقاطعين على الآخر فأبى هذا الآخر أن يرُدَّ السلام ردَّ عليه من هو خيرٌ منه، فقد قال عليه الصلاة و السلام: (وإن ماتا على صِرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا، وإن سلَّم عليه فأبَى أن يقبَل تسليمَهُ وسلامه-هكذا الرواية هنا في الكتاب وفيها شيء من الاختصار، بيَّن هذا الاختصار رواية أحمد، لأنه ما معنى : (فأبَى أن يقبَل تسليمَهُ وسلامه) ؟ معناه – في رواية أحمد (فأبَى أن يقبَل تسليمَهُ وردَّ سلامَه عليه) يعني أبى أن يتقبَّل اللفظ، وأبى أن يرد باللفظ، ماذا ؟ قال : ( ردَّ عليه الملك) بدل الرجل المقاطَع الذي رد عليه التائب من المقاطعة الله - عز وجل - يُسخِّر ملكًا فيرد على الذي تاب عن المقاطعة فيرُذَّ عليه السلام.
(وردَّ على الآخر الشيطان) وهكذا ربنا - عز وجل - يعامل كل إنسان بحسب عمله، إن صالحا فصالحا وإن طالحا فطالحا.
الآن يذكرُ المُصنِّف حديثا يبدو بادي الرأي أنه ليس له صلة بهجر المسلم كما هو عنوان الكتاب، ولكن بعد أن نقرأه عليكن سيبدو لكم الصِّلة القائمة بينه وبين الباب.
روى المُصنِّف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَك، وَرِضَاكِ، َقَالَتْ : قلتُ : وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَالكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟، قَالَ : إنّك إذا كنت راضيةً قلتِ : فلا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وإِذَا كنت ساخطةً، قُلْتِ : لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قالت : قُلْتُ : أجل)
في هذا الحديث إشارة إلى طبيعة الإنسان، وأنه قد يصدُر من الإنسان الكامل شيء ما ينبغي أن يصدُر منه وذلك لثورة غضبية أو لحالة مرضية نفسية أو نحو ذلك من الأمور التي قد تَعرض للإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة، وأنه ما قد يصدُرُ من هذا الإنسان في مثل هذه الحالة لا يدخل في باب الهجر المنهي عنه في الحديث السابق والأحاديث الُمتقدِّمة، لماذا؟ لأن هذه الحال لا تستمر مع صاحبها، يعني هذه ما بعد الثلاث الأيام، كما قلنا مسموح الثلاثة أيام الهجر وإنما هي ساعة أو سويعة ثم تعود النفس إلى طبيعتها، فهذه القصة التي ترويها السيدة عائشة –صاحبة القصة نفسها – تدلنا على أن هذا وإن كان ليس من الكمال ولكنه أيضا ليس من باب الإثم.
فهي تقول أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها يوما : (إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَك، وَرِضَاكِ : يعني إذا كنت راضية مني أو غضبانة علي
قَالَتْ: قلُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَالكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: إنّك إذا كنت راضيةً قلتِ: فلا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ : حلفت بالله - عز وجل - ربِّها وخفّت إضافة الرب إلى حبيبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت : (وَرَبِّ مُحَمَّدٍ)
(وإِذَا كنت ساخطةً قُلْتِ : لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ): الحلف واحد فرب محمَّد هو رب إبراهيم ورب الجميع، ولكن هذا في الواقع من نعومة السيدة عائشة ومن سياستها وفِطنتها في إظهار ما في نفسها من حيث جهة زوجها، فهي لا تهجره، حتى أنا الآن تذكَّرت أنها قالت له في بعض الأحاديث: (والله يا رسول الله لا أهجر إلَّا اسمك) فهي إذا كانت راضية قالت: (وَرَبِّ مُحَمَّدٍ)، وإذا كانت غضبى قال: (ورب إبراهيم)، وقالت هنا في الجواب: الأمر كما تقول يا رسول الله ولا أهجر إلَّا اسمك، أمَّا أن أهجر شخصك فحاشايا من ذلك لأن هذا إثم كبير لاسيّما وأنت سيّد البشر - صلى الله عليه وسلم -.
إذن هذا الحديث في الوقت الذي يُشعرنا بأن طبيعة الإنسان قد تتغيَّر أحيانا فيجب ألَّا يسمح هذا الإنسان لنفسه بأن [ ... ] للتغيُّر وأن يقف الأمر عند أمور شكلية فقط كما هو المثال بين أيدينا، كانت تقول: (ورب محمّد)، وفي حالة الغضب تقول: (ورب إبراهيم) قالت: قلت: (أجل، لستُ أهاجر إلَّا اسمك) هذه الرواية في نفس الكتاب.
[من هاجر أخاه سنة]
ثم قال المُصنِّف -رحمه الله- في بابٍ جديد في بيان تعبير آخر للرسول مهاجرة المسلم، قال :
باب : من هاجر أخاه سنة :
ثم روى باسناده الصحيح عن أبي خِراج السُلَمي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من هَجَرَ أخاهُ سنةً فهو بِسفكِ دمه) وهناك رواية في سنن بن أبي داوود تؤيد رواية يذكرها المُصنّف : (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دَمِه)، والمعنى تقريبا واحد أي : أن مهاجرة المُسلم لأخيه المسلم سنةً كاملة يُساوي كما لو قتلَه وسفك دمه، وهذا اثم كبير جدا، ولذلك فإذا ما وقع الإنسان في أمر ما لثورة نفسية غضبية -كما قلنا آنفا- في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق –أمَّا المقاطعة بحق، فقد عرفتم مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير - فإذا وقع المسلم في مقاطعة أخيه المسلم بغير الحق فله فُسحة من باب التنفيس عن النفس وعن الغضب ثلاث ليال فقط، فهناك عليه ان يكبح من جماح نفسه ولا يزيد عن ثلاث ليال ثم بعد ذلك إن كان لم يفئ إلى نفسه ولم يعُد إلى رشده ودخل الليلة الرابعة واليوم الرابع وهكذا، فعليه أن يُبادر إلى التَّوبة والفيء والعودة والأَّا يستمر خشية أن يُصبح ذلك عنده عادة فتدخل السنة على المقاطعة وهو فاجر في مقاطعته، مستمر في ضلاله فحينئذِ يكون كسفكِ دم ذلك الذي قاطعه وهاجره إذا ما بلغ في المقاطعة سنة.
رواية ثانية من نفس الطريق الأولى لكن بلفظ: قال: (أن رجلا من أسلَم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدَّثه -يعني راوي الحديث وهو عمران بن أبي أنس- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هجرة المسلم سنة كدَمِه)، فهاديك كانت رواية بن أبي داوود، فرواية بن أبي داوود تقول: (كسفك دمه)، وهذه تقول (كدَمِه)، والمراد أنه كما لو سفك دمه، تمام الحديث (وفي المجلس محمَّد بن المُنكدر، وعبد الله بن أبي عسَّاف فقالا: قد سمعنا هذا عنه) يعني أن تابعي الحديث الذي هو هنا في هذا الحديث: عمران بن أبي أنس لمَّا حدَّث هذا الحديث في مجلسه، كان في ذلك المجلس مُحمَّد بن المُنكدر وعبد الله بن أبي عسَّاف وكلٌّ منهما تابعيٌ أدرك غير ما واحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذان التابعيَّان محمَّد بن المُنكدر وعبد الله بن أبي عسّاف لمَّا سمعا عِمران بن أبي أنس يُحدّث أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدَّثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هجرة المسلم سنةً كدمه)، ماذا قالا هذان التابعيان مُحمَّد بن المُنكدر وعبد الله بن أبي عسَّاف؟؟ قالا: (قد سمعنا هذا عنه)، وهذه فائدة حديثية.
[من كره أمثال السوء]
درسنا اليوم في الباب السادس والتسعين بعد المائة وهو قول المصنِّف – رحمه الله –
باب من كره أمثال السوء :
ثم روى من إسناده الصحيح عن بن عبَّاس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليسَ لنا مَثلُ السوء، العائدُ في هبتِه كالكلبِ يرجعُ في قَيئِه).
معنى هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون متحدِّثا عن أمَّته: (ليس لنا مثل السوء): أي لا يجوز أن تُضرب فينا الأمثالُ السيئة التي تدلُ على الأخلاق الرديئة، فيكون المثل السوء ما هو؟؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (العائدُ في هِبتِه كالكلب يرجع في قيئه) أي: لا يجوز للمسلم إذا ما أعطى عَطاءً أو مَنح منحةً أو وهَبَ هِبةً لأحد أن يَسترجع هذه الهِبة ويُعيدها إلى نَفسه بعد أن أخرَجها طيّبة بها نفسه، فلا يجوز والحالةُ هذه أن يرجع هذا المسلم بما وهَبَ لغيره، فضرب الرسول بذلك مثلا فقال إن الذي يفعل ذلك: (كالكلب يرجعُ في قيئه) وهذا المثل سيِّي جدا، ذلك لأن فيه تشبيها قبيحا من ناحيتين:
الناحية الأولى: تشبيه العائد والراجع بالهبة بالكلب، والقبح الثاني: أنَّ التشبيه بهذا الكلب كان في عملٍ سيئٍ وهو أنَّه يرجع في قيئه، وما معنى: (يرجع في قيئه)؟: هذا أمر طبيعي للإنسان فضلا عن الحيوان أحيانا يستفرغ لمرض في مَعدته، لامتلاء المعدة بالطعام أكثر مما تتحمل المَعدة فهنا يستفرغ، هذا الاستفراغ يجب أن يخرج إلى خارج الفم لأنه قبيح في نفسه، وفي كثير من الأحيان يُشاهد من بعض النَّاس الذين يستقيئون يخرج مع القيئ رائحة قبيحة جدًا، وفي بعض الأحيان إذا ما اشتد القيئ ربما يخرُج مع القيئ شيئ من النجس، فمع أن هذا القيء قبيح ومع أنه يكون فيه شيء من النجاسة، فهذا الكلب الذي شُبِّه به العائد في هبته يرجع في هذا القيئ أن يبلعه، يعني بياكله من جديد، فهذا مثل الذي يرجع في الهبة التي أعطاها للإنسان، فشببه - صلى الله عليه وسلم - بالكلب، فالتشبيه بالكلب يكفي ذمَّا وقدحا في المُشبَّه به، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (يعتدلُ في السجود ولا يبسُط أحدَكُم ذراعيه بسط الكلب) ما معنى هذا؟ وهذا كثير من الرجال فضلا عن النساء يتشبَّه بالكلب في أثناء سجوده، فما هي هذه الصورة المَذمومة والتي شُبِّه صاحِبها بالكلب؟
السُّنَّة في الصلاة أن المسلم كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (يسجُد بن آدم على سبعة آراب) أراب: يعني أعضاء، وهذه الأعضاء ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: (الجبهة): هذا العضو الأول الذي ينبغي أن يسجد عليه المُصلِّي –كلُّ مُصلًّ سواء كان ذكرًا أو أُنثى، الجبهة ثم أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يده من الجبهة إلى الأنف أشار هكذا [] يعني أن الجبهة والأنف عضوٌ واحد أي لا يجوز أن يسجد فقط على جبهته وإنَّما جبهتِه وأنفه.
(ثم الكفَّين) هكذا صاروا ثلاثة، (ثم الركبتين) صاروا خمسة، (ثم رؤوس القدمين)، البحث الآن في وضع الكفّين على الأرض حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: (يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب) أي ليسجُد هكذا ولا يسجد هكذا [] لأنه هكذا يعمل الكلب، فإذا ما تصوَّرتم الآن كلب منبطح على الأرض يمد ذراعيه على الأرض وبطنه ورجليه كلهم في الأرض، فهذا الانبطاح وبسط الذراعين هو صنيع الكلب، فنهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - المُصلِّي -أي مُصلٍ كان ذكرًا أو أُنثى - أن يتشبَّه في سُجوده بهذا الكلب لأنه يُضرَب به مثل السوء، فإذا ما لاحظنا هذا الحديث: (ولا يبسُط أحدكم ذراعيه بسط الكلب) نهى الرسول عليه السلام عن وضع الذراعين على الأرض لأنه فيه تشبُّه بالكلب، فأولى وأولى ألَّا يعود الإنسان بما وهب لغيره من هبةٍ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبَّه هذا العائد في هبته كالكلب، وليس فقط كالكلب وإنّما كالكلب يرجع في قيئه –الشيء اللي استفرغه بيبلعه، فهنا فيه تشبيه ذميم من ناحيتين، الناحية الأولى أنه شبَّه الراجع في هبته بالكلب، والناحية الأخرى أنّه شبهه بصنيعٍ للكلب هو فوق أنه صنيع الكلب هو ذميم في نفسه لأن الإنسان لو رجع في قيئه فهو عيبٌ، فكيف هو يُشبِّه الراجع في هبته بالكلب يعود ويرجع في قيئه.
إذن الشاهد من هذا أن البخاري –رحمه الله – وضع هذا الباب: باب من كره أمثال السوء: يعني أن المسلم لازم يكون له قدوة المثل الحسن وليس المثل السيئ كالكلب يرجع في قيئه.
إذن هذا الحديث يُفيدنا فائدة فقهية وهي أن الُمسلم يَحرُم عليه أن يرجِع في هبةٍ أعطاها لغيره، مهما كانت هذه الهِبة ثَمينة أو حقيرة، يعني إنسان أعطى حَبِّة برتقال أو مشمش او غير ذلك لآخر فلا يجوز أن يسترجعها حينئذٍ مثله مثل الكلب يرجع في قيئه، أعطى ما هو أكثر من ذلك فأولى وأولى لأنه لا يجوز أن يرجع في قيئه، فالتحريم أُخذ من هذا التشبيه الذي شرحناه لكنَّ، (كالكلب يرجع في قيئه)، إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى المُصلِّي أن يبسط في سجوده بسط الكلب كان ذلك دليلا على تحريم هذا البسط، فكيف وهو شبَّه الراجع في هبته، في عطيته بالكلب يرجع في قيئه!! فدلَّ الحديث على تحريم الرجوع في الهبة والعطية.
لكن هنا سؤال: هل هُناك تفصيل في الرجوع المُحرَّم؟
الجواب: اختلفت المذاهب فأكثر العلماء على أنَّ الحديث يبقى على إطلاقه فيَحرُم على كل واهبٍ أن يهب شيئًا ثم يرجع فيه:
الأحناف قالوا: بشرط أن يُثاب: يعني إذا إنسان أعطى عطية بقصد أن يُقابل بمثلها أو بأحسنَ منها، وإذا به يُفاجأ بأنه راحت عطيته سُدى، قال الأحناف: يجوز له الرجوع مادام أنه لم يُثَب عليها، واحتجُّوا على هذا التقييد ببعض الأحاديث التي قَيَّدت هذا التحريم بما إذا أُثيب أي قوبل بالمثل، فإذا لم يُثَب جاز له الرجوع لكن هذه الأحاديث ليست صحيحة الإسناد؛ ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها فيبقى هذا الحديث من هذه الحيثية، من هذه الجهة على إطلاقه أي سواءٌ كان الواهب يطمع في أن يوهَب أو لا يطمع فرجوعه عن هبته حرامٌ لهذا التشبيه المذكور في الحديث.
ويأتي هنا سؤال آخر وهو: هل هذا الإطلاق المذكور في هذا الحديث هو على عمومه من جهة أخرى وهي من جهة ملاحظة الواهب إذا وهب لفرع من فروعه كأن يهب الوالد لولده، فهل أيضا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته؟؟
هذا أيضا موضع خلاف، لكن الصحيح أن الوالد مُستثنى من عدم الجواز وإن كان له حصَّة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح أي فيما أفهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان:
إحداهما فقهية، والأُخرى ذوقية -إذا صحَّ التعبير- أمَّا الناحية الأولى: هي الناحية الفقهية فهل يجوز للوالد إذا ما وهب ولد له هبة ما أن يَرجع فيها؟ ولو حق المطالبة بها أم لا؟؟
الجواب: يجوز، بمعنى أنه إذا ترافعَ واهبٌ وموهوبٌ إلى الحاكم فادَّعى أحدهما بأنه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد أن يرجع فيها، فالقاضي الذي يحكم بما أنزل الله ينظر في الواهب فإن كان والدا فرض على الولد أن يرجع بالهبة إلى أبيه مادام هكذا يريد الوالد، فرض عليه وأوجب عليه وألزمه بأن يُعيد ما وهب والده إليه إلى أبيه. أمَّا إن كان الواهب ليس أبًا ففي هذه الحالة يحكم الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله للموهوب على الواهب ويقول للواهب ليس لك أن ترجع؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: ليس لنا مثل السوء، هذه الناحية الفقهية أو القضائية.
أمَّا الناحية الذوقية فللوالد نسبة من هذا الذنب ومن هذا التشبيه السيء حينما يُعطي لولده هبةً ثم يرجع في هذه الهبة ولكن أقول له نسبة معيَّنة، لا أقول ينطبق عليه تماما؛ ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا، هذه الحقوق تلطِّف من أثر هذه الخَصلة القبيحة فيما لو وقع فيها.
مثلا: الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول لمن جاء يشكو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أباه يقول: (إن أبي يُريد أن يجتاح مالي: أي أن يأخذ مالي – فقال له - صلى الله عليه وسلم -: أنت ومالك لأبيك) كأنَّه يقول هذا ليس غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنَّك أنت ومالك لأبيك، وفي حديث آخر: (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم).
فإذن لمَّا يكون الوالد قد أعطى هبة ما لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يقول العامَّة اليوم (بيحُط من جيبته لِعبّه) فالمصدر والمخرج واحد، أنت ومالك لأبيك، فإذن إذا وهب الوالد لأبنه هبة ثم رجع فهذا أمر جائز لأنه يجوز أن يأخذ من ماله الذي اكتسبه هو بكسبه وعرق جبينه-كما يقال – يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال كما يشاء ثم هو بحاجة إليه، فأولى وأولى أن يجوز له أن يرجع بمالٍ أو بهبةٍ أو عطية قدَّمها هو من ماله لولده، من أجل هذا الحق الذي له على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامَّة فيها، ومن هذه الأحكام ما نحن بصدده، لا يجوز لأحد أن يرجِع في هبة له إلَّا الوالد مع ولده، بل هناك ما هو أخطر من ذلك بكثير وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يُقادُ والدٌ بولده): أي لا يُقتل والدٌ بولده، يعني: إذا والدٌ ما أجرم فقتل ولد من أولاده بغير حق ولكن لا يجري على هذا القاتل الحُكم العام المعروف في الإسلام وهو أن القاتل يُقتَل، القاتل يُقتَل هذا المبدأ العام لكن يُستثنى منه الوالد إذا قتل ولده، فهو ارتكب جُرما ولا شك، ولكن من الناحية القضائية لا يُقتل الوالد بولده؛ لأن هذا المقتول هو جزءٌ منه كما لو أن هذا الوالد عُضوا من أعضائه -لا شك أن هذا أيضا لا يجوز إسلاميا- لكن لا يُدان، من المُدَّعي ومن المُدَّعى عليه؟؟ منه وإليه، ولذلك فهناك أحكام تختلف في الإسلام من حيث العموم والخصوص، من ذلك ما نحن في صدد بيانه، فكل إنسان باختصار وهب هِبةً ما يَحرُم عليه أن يرجع في هذه الهبة -يسترجعها إلى ملكه-، اللهم إلَّا الوالد لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه.
[السباب]
ثم عقب المُصنِّف –رحمه الله – بابًا جديدًا فقال:
باب: السباب :
وذكر فيه بعض الأحاديث والآثار:
أما الحديث الأول تحت هذا الباب فهو ضعيف الإسناد ولذلك فنحن [ ... ] نجتنبه كالعادة، أما الثاني فهو اسناده حسنٌ وهو أثرٌ من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، وهي أم الدرداء، حيث روى المُصنِّف –رحمه الله – بإسناده الحسن عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: (إن رجلًا نال منك عند عبد الملك فقالت-اسمعن يا نساء شوفوا أخلاق السلف الصالح من النساء -: (أن رجلا أتاها، فقال: إن رجلا قد نال منك عند عبد الملك، فقالت: (إن نؤبن بما ليس فينا، فطالما زُكينا بما ليس فينا) شيء عظيم!
نال منك أي طعن فيكِ، وعند من؟ ليس عند أي رجل كان، وإنما عند ملك هذا الزمان وهو عبد الملك بن مروان الأموي، فرجل ينقل إلى هذه السيدة أم الدرداء هذه الوشاية بأن فلانًا نال منك عند الملك، فما اهتزَّ لها شعرة من بدنها، بل على العكس من ذلك تلقَّت هذه الوشاية بكل تُؤدة وكل خلق إسلامية صحيحة إذ قالت: (إن نؤبن) أي إن نُتَّهم ونُطعَنُ بما ليس فينا، فقد زُكِّينا بما ليس فينا، يعني كأنَّه كلام من وحي السماء، (لقد كان في أمَّتي مُحدَثون) (خيركم في أمتي فعمر) يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لقد كان فيمن قبلكم – أي في بني إسرائيل- مُحدَّثون –ملهمون كثيرون أما في هذه الأمة فهم قليلون، ذلك لأن الله -عز وجل -أغنى هذه الأمَّة بالوحي الذي على قلب محمّد - صلى الله عليه وسلم - فجعل رسالته خاتمة الرسائل ودينه خاتم الأديان، فلم يبقى ثمَّة حاجة كُبرى إلى أن يكون في هذه الأمَّة مُحدَّثون مُلهمون كما كان الشأن في من قبلكم من الأمم، لذلك فالمُحدَّثون في هذه الأمَّة قليلون وإن يكن فيهم فعُمر، وفعلا لقد ثبت في أكثر من حادثة أن عُمر -رضي الله عنه -كان يتكلَّم فينزل الوحي وفق كلامه، يقترح فيأتي الوحي وفق اقتراحه.
فهذا الحديث (فإن يكن في أمَّتي فعُمر) فيه إشارة إلى قلَّة وجود المُحدَّثين في هذه الأمَّة، فأنا أرى كأنَّ هذه أم الدرداء من هؤلاء المُحدَّثين المُلهمين، حين أجابت ذلك الإنسان الناقل لطعن الطاعن فيها فقالت: (طالما زُكينا بما ليس فينا) فإذا طُعِن فينا بما ليس فينا فلا غرابة في ذلك، هذه مقابل هذه
إن نؤبن أي نُتَّهم، بما ليس فينا، فقد نُزكَّى كثيرا بما ليس فينا، فإذا زكَّانا أحد بما ليس فينا فهل يتحرَّك منَّا شيء من ثورة أو غضب؟؟ مع أنه كلام باطل؟.
يعني مثلا كما يُروى -وأنا أذكر هذه القِصَّة على طريقة رمي عصفورين بحجر واحد يُروى -في مناقب أبي حنيفة –رحمه الله – وهذه رواية غير صحيحة، هذا هو العصفور الأول للتنبيه أن هذه الرواية غير صحيحة، والعصفور الثاني للتمثيل لما نحن فيه، يُروى في مناقب أبي حنيفة –رحمه الله – بأنه كان يمشي في الطريق وإذا به يسمع أحدهما يقول للآخر أتدري من فلان؟، فلان أبو حنيفة الذي لا ينام الليل [ ... ] وبطَّل من بعد هذا الخبر ينام بالليل حتى يكون كلام الناس فيه صحيحا، وأقول هذه القصَّة تُروى وليست بالصحيحة لما سيأتي بيانه؛ لأن هناك قصَّة أخرى وهذه تُذكر في مناقب أبي حنيفة –رحمه الله – أنه مضى عليه أربعون سنة وهو يُصلِّي فرض الفجر بوضوء العشاء، وهذا معناه أنه صلَّى صلاة العِشاء وما نام – القصَّة الأولى غير صحيحة ذكرتها لما سيأتي بيانه في القصّة الأخرى – فالقصَّة الأخرى تقول أن أبو حنيفة صلَّى فرض الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة وهذا معناه أنه ما كان ينام الليل وهذا خلاف السُّنة وحاش لابن حنيفة بل لمن هو أدني وأدنى وأدنى بكذا مراحل من أبي حنيفة أن يأتي و [ ... ] ولا ينام من الليل إطلاقا، ليس لا ينام من الليل إلا قليلا!! مع تعليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنا ما علَّمنا الله إياه أنه لا يجوز التنطُّع والتشدد في العبادة؛ لأنّه مثلما يقول العامَّة، وهذا مأخوذ من حِكم النبوة والرسالة: (كِثرة الشدّ بيرخي) وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: (إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فمن كانت فَترته إلى سُنَّتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بِدعة فقد ضلَّ).
(إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً): يعني حَماس، كل عمل يبدأ فيه الإنسان –وهذا شيء طبيعي مُلاحَظ حتى في الأمور المادِّية يأخد الإنسان أمرًا ما بكل حرارة وما بيحس بحالة إنه بيبدأ يبرد يبرد ويفتر إلى آخره، ثم ماذا يصير فيه؟ بيفلِّت الأمر بقدر ما شدّه بالأول، إما بيرخيه ويفلته إمَّا بيعتدل إلى ما أقدم عليه، هذا الاعتدال هو الهُدى وهذا معنى الحديث: (إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّة) يعني شدَّة وحماس متناهٍ، (وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ) بيبدأ يفتر شوية شوية، إمَّا إنه يفلِّتها بالكلية كما قلنا، أو يظل يمسكها باعتدال، (فمن كانت فترته إلى سُنَّتي) يعني الاعتدال في الأمور (فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضلَّ) ضلالا مبينا.
فأبو حنيفة يُروى عنه كان يُصلِّي صلاة الفجر بوضوء العشاء لمدة أربعين سنة، وغير معقول أبدا أن يصدر من ابي حنيفة لكن الشاهد للقصَّة الأولى، قيل عنه: هذا لا ينام الليل فالغرض من القِصَّة –إن صحَّت- أنه لا يريد أن يُقال فيه ما ليس فيه، لا يريد أن يُزكَّى بما ليس فيه، إذن لازم هويعمل حتى يُصدِّق الناس ما يقولون فيه.
الشاهد من هذا الأثر شيئان اثنان: أن الناس ليس عندهم اعتدال في الأمور، والواقع أنا أقول -لأني مُتأثِّر بهذا الأثر عن أم الدرداء وغيره- أنه مهما سمعتم كلام على إنسان ما فرأسًا لازم تتصوَّروا إنه فيه مبالغة مهما سمعتم ثناءا على إنسان ما لازم تتصوَّروا إنه فيه مبالغة لأن الخبر ما هكذا، إلَّا فيه شيء بالزيادة، والعكس بالعكس، مهما سمعتم ذمَّا على إنسانٍ فلازم تفترضوا إنه هناك مبالغة، فسواءً في المدح أو القدح –قد يكون له أصل لكن ما هكذا كما يبالغوا الناس سواء في المدح أو القدح، أمّا قد لا يكون له أصل مُطلقا هذا أيضا ممكن، لكن إذا افترضنا إن إنسان رجلٌ صالح فعلا صالح، وصاروا الناس يتحدَّثوا عنه وفي صلاحه ما فيه شك فيه مبالغة، إذا فيه عالم فأثنى عليه الناس لا شك فيه مبالغة، والعكس بالعكس تماما، لماذا نحن نقول هذا؟ أولا: الواقع يشهد أن الناس ما عندهم اعتدال لا مدحا ولا قدحا، وثانيا أن النَّاس ما أوتوا علما، ما أوتوا خُلقا، حتى إذا توفَّر العلم والخلق في من يتكلَّم مدحًا أو قدحًا لا يقول إلَّا حقَّا هذا نادر جدَّا، والنادر لا حُكم له، هذا أحد ما يُستفاد من هذا الأثر.
والفائدة الثانية: هو في الواقع فائدة مهمة جدا وهي فائدة خُلُقية تربوية أن أحدنا إذا ما سمِع ذمَّا فيه من بعض أصدقائه أو أعدائه لا يغضب ولا يثُر وليتَذكَّر هذه الحكمة، فليَقل إن الناس بيحكوا فينا ويمدحونا بما ليس فينا فمن الطبيعي أن يذمُّونا أيضا بما ليس فينا هذا يغطِّي على هذا [ ... ] فاعتبروا يا أولي الألباب.
الخبر الثاني: صحيح الإسناد وهو أيضا أثر موقوف يرويه المُصنِّف –رحمه الله- عن قيسٍ قال: قال عبد الله: (إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوِّي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برِأ من صاحبه)
(عن قيس): هذا رجل من التابعيين، وهو بن أبي حازم البجلي الكوفي.
يقول: (قال عبد الله): وعبد الله هو صاحبنا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أيضا يُحدِّثنا بحكمة عالية وهي مُستقاةٌ من بعض الأحاديث الصحيحة.
يقول عبد الله: (إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوِّي فقد خرج أحدهما من الإسلام)؛ لأنه معنى عدوي أي لا نلتقي في الأخوة الإسلامية {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] فإذا قال مسلم لأخيه أنت عدوي، يا عدوي، فقد خرج من الإسلام أحدهما؛ لذلك قال: (فقد خرج أحدهما من الإسلام أو بَرِأ من صاحبه) لأن القائل لصاحبه: أنت عدوي، إمَّا صادق وإمَّا كاذب، فإن كان صادقا فعلا بَرء هذا من صاحبه ذاك لأن الكُفر والإسلام لا يجتمعان، وإن كان كاذبا انعكس الموضوع وبقي المُقال له بأنَّه عدو للقائل على إسلامه وبرء هذا القائل لأنه يظلم صاحبه المسلم بقوله: (أنت عدوي) برء من الإسلام، فهذا المعنى مأخوذ من الحديث الصحيح في البخاري وغيره إنه: (إذا قال المسلم لأخيه المسلم: يا كافر فقد باء به أحدهما) إما أن يكون قوله قوله حق في صاحبه –مادام أنه تكلَّم الحق فيكون صاحبه كافرا- أو إذا كان باغيا ظالما فيرجع هذا التكفير يرتد من صاحبه إلى نفسه فيكفُر هو باتِّهامه لأخيه المسلم بالكُفر.
لذلك ينبغي أن نأخذ من هنا عبرة وهي ألَّا نتَّهم بعضنا بعضا بكلام فيه تعدِّي وفيه ظلم للآخر، فيه وصف له بما ليس فيه، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: (الغَيبة ذكرُكَ أخاك بما يكره، قالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلتُ، قال: إن كان فيه ما قلتَ فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلتَ فقد بهتَّه) يعني افتريت عليه، فأكبر فِرية دون هذه الفرية وكله فرية كبرى، أكبر فرية هو أن تقول لأخيك المسلم: يا كافر، إذا قلت له كاذب، سرَّاق، غشَّاش، حرامي، إلى آخره من أوصاف سيئة هي أيضا لا تليق بالمسلمين لكن أكثر من كل هذه الاتهامات أن تقول لأخيك المُسلم: (يا كافر)، فإذا قلت لأخيك المُسلم يا كافر فأحدهما برئ من صاحبه ولا بد؛ لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان، فإمَّا أن يكون صادقا في قوله فقد برء هو مما قال له: (يا كافر) لأن ذاك كافر، أو كاذب في اتِّهامه فيعود الكفر إلى الممتهن ويبرأ هو من ذاك؛ لأن ذاك كفر وهذا بقي على إسلامه، فليتَّق الله كل مسلم في أخيه المُسلم فلا يرميه بما ليس فيه لاسيما بالكفر الذي هو أكبر الكبائر.
قال قيس: وأخبرني بعد أبو جُحيفة أن عبد الله قال: (إلَّا من تاب) طبعا التوبة تمحو الحَوبة، فإذا إنسان قال لأخيه المُسلم: يا كافر، ثم تبيَّن له أنَّه كان مُخطئًا في ذلك أو كان مُتسرِّع أو كان غضبان أو كان في حالة ليست حالة سَليمة فتنبَّه إلى هذه الحالة السيئة واستغفر ربَّه -عز وجل – وأناب إليه وتاب فالله –عز وجل – يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير.
[سقي الماء]
ثم عقد بابا جديدا فقال في الباب التاسع والتسعين بعد المائة، فقال:
باب: سقي الماء :
أي بيان فضل سَقي الماء، روى بإسناد صحيح لغيره عن بن عبَّاس – أظنُّه رفعه – قال: (في بن آدم ستون وثلاثمائة سُلامى أو عظمٍ أو مِفصَل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل لآخاه صدقة، والشَّربة من الماء يَسقيها، و إماطةُ الأذى عن الطريق صدقة) هذا حديث من الأحاديث التي جمعت وبيَّنت أن كل خير يُقدِّمه المُسلم لأخيه المُسلم بل ولغير المُسلم بل حتى للحيوانات كل ذلك الخير يُكتَب صدقة.
وقلتُ في ابتداء قراءة هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح لغيره، وهذا اصطلاح في علم الحديث، أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إذا كان إسناد الحديث رجاله كلهم ثقات، حُفَّاظ، وكل واحد منهم اتَّصل بصاحبه، بشيخه وروى عنه هذا الحديث، فيكون الإسناد صحيح لذاته، أمَّا إذا إذا ما تبيَّن أن في إسناد حديثٍ ما ضعف ما في ذاك السند، فهذا الضعف يوجب على العالم أن يقول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن إذا جاء هذا الحديث من طريق أخرى ليس فيه الضعف الموجود في السند الأول، حينئذٍ يُقال أن هذا الحديث أي متنه صحيح لغيره، أي لغير هذا السند أي صح بغير هذا السند، واقع هذا الحديث كذلك لأن المُصنِّف -رحمه الله- رواه من طريق الليث عن طاووس عن بن عبَّاس. طاووس من أئمة التابعين فهو أشهر من أن يُذكر ومن دون ليث وهو شيخ البخاري مُسدَّد وشيخ شيخه وهو عبد الواحد كلاهما من الثقات المُحتَج بهم في الصحيح، فيكون إسناد هذا الحديث كلُّهم ثقات إلَّا ليث هذا، فليث هذا – وهما ليثان- أحدهما ثقةٌ حافظ، والآخر ضعيفٌ مُختلِط، وصاحبنا هنا هو الثاني، أمَّا الثقة فهو الليث بن سعد المصري الذي كان قرين الإمام مالك في العلم والضبط للرواية وليس هو هنا.
أمَّا صاحبنا هنا فهو ليث بن أبي سُليم الحِمصي، ذاك مصري وهذا حمصي، وهذا كان ضعيف الحِفظ وزيادة على ذلك أنه أُصيب بالاختلاط، والمقصود به: الخرف، لكن خرَف دون خرَف، فهذا رجل محدِّث، رجل عالم ولكن نسأل الله -عز وجل – ألَّا يبتلينا في آخر حياتنا، لأجل ذلك كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منَّا) فهذا ليث أُبتُلي بالاختلاط وبالخرف فماذا كان يفعل؟ هو حِمصي فكان يصعد إلى مئذنة مسجد في حمص فيُؤذِّن للظهر في ضحوة النهار –في وسط النهار ما بين الصبح والظهر – فيصعد المئذنة ويؤذِّن أذان شرعي ويكمِّل المسكين صلاة الظهر، ولكن هو في نفسه رجلٌ صالح ورجل صَدوق لكن قبل الاختلاط كانت حافظته ضعيفة وفوق ذلك أُصيب بالخرف حينما أسنّ.
ولذلك فعُلماء الحديث يذكرون على كل حديث يتفرَّد هذا الرجل بروايته بأنه حديث ضعيف، لكن حديثنا هذا قد جاء من غير طريق ليث فلذلك كنتُ خرَّجته في السلسلة الصحيحة بإسناد غير هذا الإسناد، فكل فقرة فيه فهي ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير طريق ليث هذا الذي هو بن أبي سُليم، ومما يُشعر الباحث الناقد بضعفه هو أن الراوي عنه قال: حدَّثنا ليث عن طاووس عن ابن عبَّاس -أظنُّه رفعه-) شكَّ ليث في قول بن عبَّاس رفع الحديث إلى الرسول، يعني بيسأل يا ترى بن عبَّاس الذي روى هذا الحديث قال: قال رسول الله والّا ما ذكر الرسول إطلاقا وإنَّما قال بن عبَّاس كذا وكذا؟؟ يشك! وهذا أمر طبيعي بالنسبة لضعف ذاكرته ولاختلاطه في آخر حياته، لكن كما قلنا الحديث جاء بطريق أخرى فهو يقول: (في بن آدم ستون وثلاثمائة سُلامى: ثلاثمائة وستين مفصل، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُخبر هذا الخبر الطبِّي التشريحي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب، فالطب لا يعرف كم مفصل في بدن الإنسان لكن الله –عز وجل – هو الذي خلق الإنسان: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك:14] أخبر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأنه خلق الإنسان وجعل فيه ثلاثمائة وستين مِفصل. [انتهي



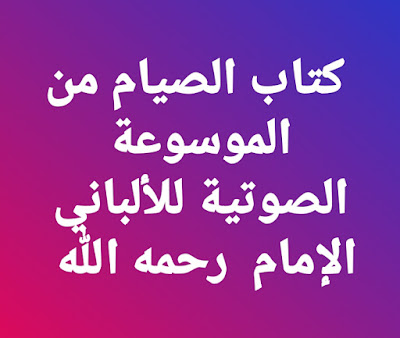

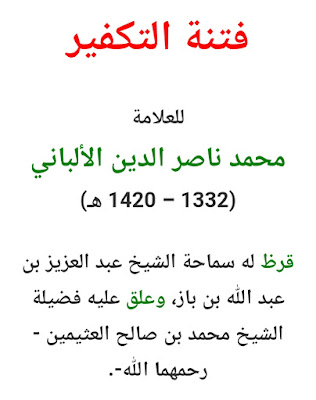

تعليقات
إرسال تعليق